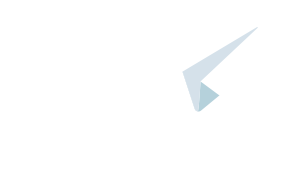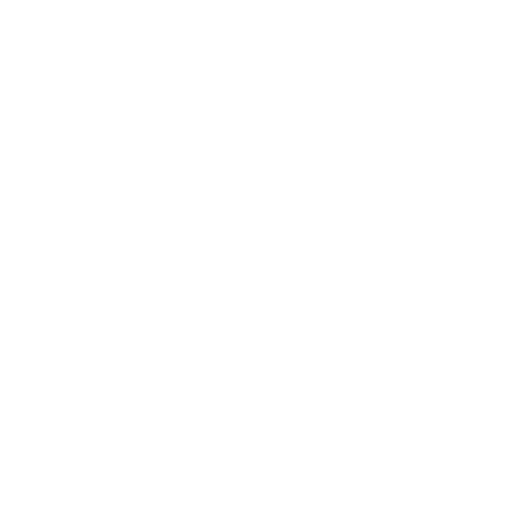التعددية الدينية (Pluralism) من الأسباب والعوامل إلى الأدلة والنقود ..(قراءة في سيرورتها من المسيحية إلى الإسلام)

بقلم : موفق هاشم
لم يقتصر اجترار المنجز الغربي على واقعنا الإسلامي المعيش بتمفصلاته المادية والصناعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فحسب, وإنما وصل هذا الاجترار إلى آليات فهم الدين الإسلامي وفهم نصوصه التشريعية, من خلال إدخال المناهج الحداثية الغربية في تناول النص القرآني, وتقديم قراءات لا تنسجم في أغلب تشيّئاتها مع قصدية منتج النص ومراده.
ومن يرجع الى التاريخ الإسلامي يجد هنالك دعوات تلتقي مع مضمون التعددية الدينية, وكان يوحنا الدمشقي (ت 248هـ)[1] أول من نادى بها, وقد عاصر هذا الرجل عدد من خلفاء بني العباس, وهم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل, قربوه لعلميته الطبية وخبراته في هذا المجال, ويقال إنه هو من أثار فتنة (عدم حدوث الكلام القرآني)؛ ليثبت من خلالها قِدم كلام الله, وبالتالي قدم كلمته (عيسى)!! وقيل ربما كان يهدف من دعوته بتعددية الأفهام الدينية الى التعايش السلمي بين الأديان, ولاسيما وأنه هو من المسيحيين الذين يشكلون أقلية في بلاد المسلمين, مستهدفا التخفيف من حدّة التعصب الإسلامي مع الآخرين من جهة, ومع أنفسهم كطوائف كل لها قراءتها الخاصة من جهة أخرى, كما إن إخوان الصفا ـ بحسب ما أُشيع عنهم ـ في رسائلهم قالوا بالتعددية الدينية, وذهبوا الى أن الحق موجود في كل دين ويجري على كل لسان[2].
ونجد أن هنالك ملامح للتعددية في فهم النص بدأت لها صيرورة في واقعنا الإسلامي الحديث منذ بدايات القرن العشرين, إذ قامت مجموعة من المفكرين العرب بمحاولات تستهدف إعادة قراءة التراث الإسلامي قراءات معاصرة, وتقترح مشاريع فكرية نهضوية, لتقديم رؤية دينية وفكرية تتسم بالعصرنة والتحديث, وتتوافق مع معطيات التطور من جانب, وإبداء محاولات تحررية من الانهماك والتبعية للمنجز الغربي بشتى حيثياته من جانب آخر, بما يُخرج النص عن جموده الظاهري وتقاطعه مع العقل والعلم, أو فلنقل بأن ما قاموا به هو محاولات توفيقية بين المفاهيم الإسلامية أو النصوص الدينية من جهة, ومخرجات الثقافة الغربية التي ألهبت عقول المسلمين ببهرجتها التطوّرية صناعيا وفكريا وتنظيميا من جهة أخرى[3]. وخير من مثّل هذه الفترة هو الشيخ محمد عبده, إذ قام بممارسة فعلية لتفسير النص القرآني بما يتلاءم والمنجز العصري, داعيا الى استثمار العلوم الغربية الحديثة والاستفادة منها[4], وجاعلا من اللاماركية والدارونية مقولات قرآنية! معتبرا إيّاها من السنن الإلهية في هذا الكون[5]. وأتبعه لاحقا الشيخ طنطاوي جوهري الذي استثمر في تفسيره (الجواهر) ما أمكن من القوانين العلمية والنظريات؛ ليبرهن على أن القرآن الكريم سبق الغربيين في العلوم التي نهضت بها أوربا بعد عصر النهضة والثورة الصناعية! ليجعل من المسلمين ذوي ثقة عالية بأنفسهم وتراثهم وتاريخهم, وأن ما يفتخر به الغربيون ويتبخترون موجود في قرآننا العظيم قبل أن يعرفوه بأكثر من اثني عشر قرنا[6]. واستمرت هذه المرحلة حتى سبعينيات القرن المنصرم, أي بعد حدوث النكسة العربية الإسلامية عام 1967, المعروفة بنكسة حزيران مع إسرائيل, إذ حصلت هزة عنيفة في وجدان بعض المفكرين العرب, فحمّلوا التراث تبعات تلك النكسة والخسران! ونادوا بضرورة إعادة قراءة ذلك التراث قراءة جديدة تلائم متطلبات العصر والتقدم والظروف التي يشهدها العالم, وفي جانب آخر نادى البعض بضرورة الاستفادة من التجربة المسيحية الأوربية قبيل عصر النهضة والثورة الصناعية, فانبجست الدعوة لتبني فكرة (التعددية الدينية) في الفهم الديني للنصوص المقدسة (القرآن والحديث), حتى صارت في سنينا الأخيرة تُداوَل بقوة من بعض المثقفين والمفكرين, وصار لها أنصار يدّعي بعضهم انتماءه إلى مؤسسات دينية عُرفت بالأصولية والسلفية, كما في مصر والجزائر وتونس والمغرب وإيران.
وقد ثار حول (البلوراليزم) جدال واسع, لما تفرزه من إشكاليات خطيرة! متمثلة بملازماتها الناقضة للنبوة, ومؤدياتها في نسبية الإدراك والمعرفة الدينية, وهو ما يعني عدم ضرورة مطابقة الدين للواقع! لذلك فمن المنطقي معرفة أسباب نشأة هذه المسألة الكلامية, ومعرفة العوامل الفكرية والفلسفية التي ساعدت على شيوعها وقبول تبنيها في مناطق نشأتها الأولى, أي في أوربا المسيحية, قبل الخوض في مبررات دعاتها المسلمين المعاصرين وأدلتهم, وقبل طرح تلك الدعاوى وتوجيه النقود وفق معطيات الدين الإسلامي. وقد تعددت العوامل والأسباب التي دعت الى تبني هذه الفكرة أو هذه الفلسفة ـ إن صح التعبير ـ في المجتمعات الغربية منذ أواخر العصور الوسطى وصولا الى العصر الحديث, وهي حسب حدود اطلاعي تتمحور في عدة عوامل, ربما تتداخل فيما بينها من وجوه عدة, وهي:
أولا: الحروب والصراعات بين الطوائف والمذاهب المسيحية:
كانت أوربا المسيحية متعددة المذاهب, وكان الصراع المذهبي هنالك على أوجّه, فبرزت فكرة التعددية لتجعل أتباع كل مذهب أو طائفة يقبلون أو يتقبّلون قراءات بقية المذاهب والطوائف, وبالتالي يعيش الجميع بسلم ووئام, وهذا ما حصل فعلا في أوربا, رغم بقاء بعض الصراعات هنا وهناك, كما هو الحال في إيرلندا الشمالية التابعة للملكة المتحدة البريطانية, التي شهدت صراعا داميا بين البروتستانت والكاثوليك حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي!
لقد كانت الخلافات بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية على أوجها خلال العصور الوسطى, لكن رغم ذلك لم تظهر فكرة التعددية الدينية آنذاك, الى أن وصل عصر التنوير الذي سمي بعصر النهضة, وكانت فيه الكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة المسيطرة على دول أوربا الغربية, والتي ما زال لديها حينها شيء من السلطة على الأمور والأوضاع اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا, فبرزت عام 1529م مجموعة من المصلحين الاجتماعيين من نفس المؤسسة الدينية, كان أبرزهم المصلح الديني والاجتماعي الألماني (مارتن لوثر), الذي يعد المؤسس للمذهب البروتستانتي المسيحي, وجرت إثر ذلك نزاعات دينية بين الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية, سُكبت فيها الدماء وحل بسببها الدمار والخراب في كثير من المناطق, استمرت لسنوات طويلة, ولنا في مأساة الفرنسي البروتستانتي (جان كالاس) أبرز مثال على التعصب وسفك الدماء نتيجة التخالف المذهبي! كالاس لأنه كان بروتستانتيا يُعلن بعقيدته ويدافع عنها أمام الأكثرية الكاثوليكية في مدينته قُتل قتلة شنيعة بتهمة مفبركة سنة 1762, ومن ثم أُحرقت جثته أمام الكاتدرائية الكاثوليكية بمرأى الجمهور في مدينة تولوز الفرنسية!
وللحد من تلك الكراهية وذلك التزمت الديني والاضطهاد طُرحت فكرة التعددية الدينية؛ لتكون حلا حاسما بين قراءات المذاهب والطوائف المتعددة, فيكون الكاثوليك على حق والبروتستانت أيضا على حق, وكلا عقائد المذهبين مقبولة وديانتيهما صحيحة, فيمكن بذلك قبول كل الأفهام المستسقاة من النصوص الدينية في عرض واحد, وكل معانيها معتبرة لا رجحان لمعنى على آخر. ومن هنا ولد ما صار يعرف لاحقا بـ (الهرمونطيقا), التي تهتم بتفسير النصوص الدينية وفق رؤية شاملة, ترتبط بكافة مسائل العلوم الإنسانية ومجالاتها, التي يمكن أن تساهم في تقديم آلية تفسيرية متفاعلة مع تطور تلك العلوم ومتغيرة بحسبها, ويعد (دانهاور) أول من استعمل هذا المصطلح في القرن السابع عشر وبالتحديد 1654, إذ ألف كتابا حمل عنوان (الهرمونطيقا المقدسة أو منهج تأويل النصوص المقدسة), بعدها راج هذا المصطلح[7]. ثم تطورت الهرمونطيقا على يد (شلاير ماخر) المتوفى سنة 1834, الذي وسّع منها وجعلها تشمل كل النصوص المكتوبة سواء أكانت دينية أم غيرها, جاء بعده (دلتاي) المتوفى سنة 1911 ليجعل من الفهم ظاهرة ترتبط بكافة المسائل التي تنتمي الى العلوم الإنسانية, وأصبحت أحد المناهج الفكرية التي تعمل على تطوير العلوم الإنسانية وترفعها الى رتبة العلوم التجريبية, جاء بعده (هايدجر) المتوفي سنة 1976 الذي كتب رسالة طويلة في (علم الفهم), في النصوص المكتوبة وغير المكتوبة, المتعلق منها بالظواهر الانسانية وغير المتعلق, المهتم بالحقائق الطبيعية والميتافيزيقية, ثم أتى بعده (جادامير) المتوفى سنة 2002, الذي يعتبر امتدادا لهايدجر, فاستقرت الهرمونطيقا بذلك على مغادرة حتمية الفهم والتفسير للنصوص, وضرورة ترك قاطعية حقائق المعرفة, ومغادرة كل أشكال الدوغمائية.
ثانيا: تقاطع النص الديني للعهدين مع العلم:
إن ما شهدته أوربا إبان عصر النهضة من ازدهار فكري وثقافي وعلمي أطل هو الآخر بظلالة على فلسفة التعددية, فكثير من النصوص الدينية للعهدين القديم والجديد كانت تحمل مدلولات تصطدم مع العقل من جانب, والمنجز العلمي المتنامي من جانب آخر! مما حدا ببعض رجال الدين المسيحي الى تبني التعددية في الفهم؛ درئا لذلك التصادم المفجع! الذي أنقض مضجع المؤسسة الدينية المسيحية وقصم ظهرها! لذلك برزت هذه الفكرة كمنقذ للتوراة والإنجيل من اندراسهما فكريا وانقراضهما اجتماعيا.
وقد نشأ في البدء صراع بين أنصار النص الديني وأنصار العلوم الجديدة, فأصدر زعماء الكنيسة فتاوى القتل والإعدام بحق كل من تسوّل له نفسه أن يقول خلاف النص الديني المتمثل بالأناجيل الأربعة, التي انتخبوها من بين أناجيل كثيرة, أتى بها حواريو عيسى (ع) حسب الفكر المسيحي, وقد قُتل غاليليو الذي اكتشف كروية الأرض وقال بها, فاعتبروه كافرا يجب أن يُقتل؛ لأنه قال بعكس ما تقول به النصوص الإنجيلية! ونتيجة لقتل عدد من المكتشفين العلميين, وتناقض تلك المكتشفات مع مبادئ الدين المسيحي بدأت بوادر التخلي عن الكنيسة ورجالاتها, مما حدا ببعض الحكماء المتدينين أن يحاولوا التوفيق بين الدين المسيحي وما يتوصل إليه العلم الحديث من اكتشافات علمية, وبالتالي يحافظون على الدين والعلم سوية, متخذين من فكرة أن الفهم الشخصي للدين شيء وعين الدين شيء آخر, وأن تلك الأفهام التي أتت عن الدين لا تمثل عين الدين, بل هي أفهام شخصية أثّرت عليها الظروف والأنساق الفكرية التي تتحكم بتوجيه فهم كل شخص, وبالتالي فالمقدّس هو خصوص التوراة والإنجيل الذي يمكن أن تُرتشف منهما أفهام متعددة, معتمدين في ذلك المخرج على عدة أمور, منها هو أن لغة الكتاب المقدس لغة رمزية لا تفيد في بيان الواقع وكشف الحقيقة.
ثالثا: نسبية المعرفة:
تطلق المعرفة على معنيين أساسيين: الأول الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية, الثاني: اطلاقها على نتيجة ذلك الفعل, أي حصول صورة الشيء في الذهن[8]. وهنالك من يذهب الى أن المعرفة تمثل ثمرة التقابل الحاصل بين الذات المدركة والموضوع المدرك, وتختلف عن باقي معطيات الشعور من حيث انها تقوم على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين في آن واحد[9]. وعلى هذا الأساس يمكن أن تعد المعرفة نسبية.
وكانت غاية الفلسفة والفلاسفة الوقوف على معرفة حقيقة الأشياء وأحوالها, وهم قديما كانوا يعرّفون الفلسفة على أنها ((العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية))[10]. وهذا التعريف يتضمن شرطا وتقييدا لذلك العلم أو المعرفة, وهو أنه يكون "بقدر الطاقة البشرية", وهو ما يعني أن الإنسان مهما استطاع أن يوجه تفكيره ويعمله للحصول على معرفة تامة أو علم تام عن الحقائق فإنه لا يتمكن من الوصول الى ذلك أبدا؛ لمحدودية قدرة الانسان وطاقته.
ويبدو أن الفيلسوف الألماني (عمانوئيل كانت المتوفى 1804) كان أبرز من رأى هذا الرأي في العصر الحديث, إذ ذهب الى اختلاف الشيء في ذاته عمّا هو في وعينا وإدراكنا, فالمعرفة الإنسانية عنده تتعلق بتكوين العقل الإنساني الذي لا يمكنه أن يصل الى الحقيقة أو المعرفة المطلقة, ويذكر (كانت) في مدخل كتابه "نقد العقل المحض" ما مفاده أن معرفتنا كلها تبدأ بلا شك من الخبرة؛ لأنه كيف تستيقظ ملكة معرفتنا وتؤدي عملها ما لم تؤثر الأشياء في حواسنا, ليس لدينا معرفة سابقة زمنيا على الخبرة, ومن الخبرة تأتي كل معرفتنا. لكن بالرغم من أن معرفتنا تبدأ من الخبرة فلا يلزم أنها مشتقة جميعا من الخبرة, إذ تتألف معرفتنا ـ حتى التجريبية منها ـ مما نستقبله من انطباعات ومما تضيفه عقولنا في ذاتها[11]. ونجد أيضا الفيلسوف الفرنسي (أوكست كونت المتوفى سنة 1857) يقرر أن القوانين ليست مطلقة ضرورة, ومشاهدة قوانين تجري في كل زمان ومكان يحتاج الى مشاهدة كل مصاديقها التي وقعت وممكن أن تقع, وهذا الأمر مستحيل ما دامت المشاهدة محدودة, وبالتالي فليس بإمكاننا الوصول الى خارج دائرة الملاحظة العلمية, إضافة الى أن التفكير العلمي تفكير نسبي لأنه مرتبط بتكوين الإنسان العضوي, فالقوانين بنظر كونت مهما بلغت من الدقة فهي لا تعدو أن تكون تقريبية نسبية, على الرغم مما قدّمته وما زالت من خدمات جليلة للبشرية[12]. فإذا كانت العلوم التجريبية بهذه النسبية وعدم الثبات فمن باب أولى أن يكون فهم الانسان نسبيا وغير ثابت على منوال واحد. أما الفيلسوف الألماني (فردريش ويلهلم نيتشه المتوفى سنة 1900) فقد كان يعتقد بأن الواقع والحقيقة لا يمكن أن تُدرك, وما يأتينا من أفهام عن تلك الواقعيات والحقائق ما هي إلا خرافات متأثرة بتأويلات عقولنا وأنساقنا الفكرية المسبقة, وهي على ما يبدو عملية تجري بلا شعور من الإنسان, ويذهب نيتشه الى أن مقولات العقل التي تعتبر أساس تشكيل قدراتنا على الفهم والإدراك ما هي إلا أساطير, وأن نصيبها من الواقع لا يتعدى تلك النظرات المنطقية التي تظهر لنا على أنها حقائق ضرورية[13]. وبذلك فقد ساهمت نسبية المعرفة في دفع فكرة التعددية الدينية الى الإمام, من خلال نسبية الفهم والمعرفة الدينية التي تكون متغيرة من شخص الى آخر؛ لتفرّد كل شخص بنسق فكري خاص به.
رابعا: نسبية الحقيقة عند الوجوديين والبراغماتيين:
يبدو أن بعض المفكرين لم يكتفوا بنسبية الطريق الى الحقيقة, والتي تعني نسبية المعرفة, بل راحوا يخلعون شكوكهم على الحقيقة نفسها, وقالوا لا توجد حقيقة واحدة وثابتة, فالحقيقة ـ كما يذهبون ـ نسبية ومتغيرة من شخص الى آخر وفق متغيرات الزمان والمكان!
وهنالك كثير من الفلسفات التي ترى أن الحقيقة نسبية, بيد أن الوجودية والبراغماتية كان لهما أكبر الأثر في الترويج الى ذلك والتأثير, فالحقيقة بحسب ما ترى الوجودية هي الحقيقة الذاتية التي تنتمي الى الوجود البشري, ويذهب أبو الوجودية الدنماركي (كيركجارد المتوفى سنة 1855) الى أن الحقيقة ذاتية, أي أنها منسوبة الى ذات الشخص المعتقد بها, ولا وجود للحقيقة عند كيركجارد إلا ضمن خصوصية الفرد وذاتيته, وهذا لا يعني أنك لا تعرف الحقيقة إلا حين تصبح ماثلة في نفسك فحسب, بل تعرف الحقيقة عندما يكون هنالك معنى نسبي يخلقه الوجدان ابتداءً من ذاته على أنه حق, وأن الحقيقة هي عمل الحرية[14]. وسار الفيلسوف الوجودي الفرنسي (جبريل مارسيل) المتوفى سنة 1973 على خطا كيركجارد, الذي أكد على ذاتية وشخصية الحقيقة[15]. أما (مارتن هايدجر) الفيلسوف الألماني المتوفى سنة 1976 فيرى أن الحقيقة انكشاف وانفتاح ذاتي[16]. فالحقيقة عند هايدجر هي الموضوع نفسه كما يتكشف للعقل[17]. وبالتالي فقراءتك للنص وفهمك الشخصي هو الحق والحقيقة عند الوجوديين.
ومن جانب آخر قدمت الفلسفة البراغماتية القائمة على النتائج والنفعية زخما كبيرا للنظرية التعددية في فهم الدين؛ لأن هذه القراءة ستجعل من المجتمعات مستقرة وبعيدة عن العصبيات والصراعات, وبالتالي سيعيش الجميع بسلم وأمان, ولا توجد حينئذ عقبات في طريق البناء والتقدم والازدهار, وهي منفعة لا منفعة أكبر منها, والحقيقة عند أصحاب هذه الفلسفة ليست ثابتة ولا خالدة, فأينما وجدت المنفعة وجدت معها الحقيقة! فالحق والحقيقة عند الأمريكي (وليم جيمس) المتوفى سنة 1910 ليست نسخة مجردة لما هو كان أو كائن, بل لما سيكون ويؤدي من نتائج, فالحقيقة عند هذا المفكر تنظر الى الأمام دائما, وهو متفق مع (تشارلز بيرس) المتوفى سنة 1914 في أن الحقيقة لا تسبق الفعل بل تأتي بعده, فهي حدس يطرأ على التجربة, ولا حق ولا صدق قبل التجربة والعمل.
وإذا كانت الأسباب والعوامل السالفة هي من أنتجت وولّدت فكرة التعددية الدينية في العالم الغربي المسيحي فلعلها في عالمنا العربي والإسلامي كانت نتيجة للتأثّر بحضارة ذلك العالم, ولاسيما من أولئك الذي درسوا في الجامعات والمعاهد الغربية, الذين رسخت فيهم الهزيمة النفسية جراء الغلبة الغربية والانبهار بحضارته, فهذا عميد الأدب العربي طه حسين يقول: ((إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء, وهي أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا, ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وسرّها, حلوها ومرّها, وما يُحب منها وما يكره, وما يُحمد منها وما يُعاب))[18]. بيد أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن التعدديون لم يكن لديهم مبررات يرون أنها كفيلة بصحة دعواهم, فمن تبريراتهم التي قالوها في هذا الشأن: أن التعصب والجمود على قراءة واحدة للنص أنتجت لنا عقلية عربية وإسلامية متخلفة تعيش في كهوف الماضي! فصار النص ـ كما يرى هؤلاء ـ يعيش منعزلا وغريبا, ولا يستطيع التفاعل والانسجام مع العلم الحديث وما توصّل إليه من كشوفات, كما أنهم يرون أن هنالك تشريعات اسلامية لا يقبل بها العقل الحديث ولا تستقيم مع الحقوق الإنسانية, إضافة الى التناحر والتقاتل والصراعات بين المذاهب الإسلامية التي ألقت بظلالها على هذا الموضوع, إذ مرت الأمة وما تزال بحروب مدمرة وصراعات عميقة سببها خصومات عقائدية دينية ومذهبية, خاصة بعد انتشار المدّ السلفي الوهابي بعقليته الساذجة السطحية, الجانحة إلى التكفير وسفك الدماء, المتمسكة بحبال التخلف والهمجية, حتى أنتجوا لنا أفواجا مرعبة من اليتامى والأرامل, تعيش على أنقاض خربة ومدمرة! زيادة على التجربة السياسية والاجتماعية الفاشلة لبعض الجماعات والأحزاب الاسلامية التي مارست أدوارها باسم الدين, فأعطت صورة مشوّهة عن الإسلام وشريعته! بعد أن عملت ما عملت في أرض الله من خراب ونهب ثروات وسفك دماء وتفجيرات وجرائم يعجز إبليس أن يأتي بمثلها!! كل ذلك يؤكد ـ بحسب هؤلاء ـ على أن لا خلاص من تلك المشاكل والمآسي والكوارث إلا بتبني التعددية الدينية.
إضافة إلى تلك التبريرات فإنهم ـ أي التعدديين ـ يسطّرون أدلة يشرعنون من خلالها فكرة التعددية! وأول الأدلة التي قالوها هو أن النصوص الدينية الإسلامية وقع عليها كثير من التفسيرات والاجتهادات والآراء, التي لا يمكن بحال من الأحوال إنكار اختلاف المفسرين والمجتهدين والمتكلمين, وهو ما يكشف عن تعددية في فهم النص وتفسيره كتعددية فهم النص الأدبي شعرا ونثرا, وهذا التعدد التفسيري واختلاف الأفهام لا ينكره علماء الدين[19]. إذ إن اختلاف مستويات الفكر لدى الناس أمر طبيعي, وبالتالي فهذا الاختلاف لا محال سيولّد قراءات مختلفة تبعا لاختلاف المستويات الفكرية وأنساقها المعرفية. ومن الأدلة التي يحاول التعدديون التشبث بها نظرية (التأويل) ونظرية (البطون), وقد جاء في الحديث أن للقرآن سبعة وسبعين بطنا, وهو ما يعني ـ كما يذهبون ـ الى تعددية معاني الآيات القرآنية.
وهنالك من يرى أن الاختلاف في الفتوى الشرعية يقع ضمن دائرة الاختلاف الاجتهادي إن صح التعبير, ولا يتعداه الى القول بمشروعية التغير في الأحكام والمعتقدات الضرورية والمتيقن منها, كحكم الحجاب وسهام الإرث والديات وما شاكل ذلك, معتمدين في ذلك على شرعنة جميع القراءات المختلفة للنص الديني, ولو تناولنا الاختلاف الاجتهادي نجده يجري وفق سياقات معروفة ومعايير متفق عليها في أصول الفقه الإسلامي, فمن مجالات تغير الأحكام واختلافها بين الفقهاء العناوين الثانوية والتزاحم وأحكام تتعلق بمنطقة الفراغ تترك للفقيه الولي أو الحاكم الشرعي أن يتعامل معها وفق المصلحة العامة والضرورات, كما يحصل التبدل أو التغير في التطبيق والمصاديق كتغير أساليب الجهاد وأسلحته, وبذلك يتبين أن الاختلاف في بعض الموارد التي لم يتضح أمرها بسبب النصوص الظنية والمجملة وما الى ذلك, وأن معنى النص واحد هو المراد والمطلوب, لكن بسبب الغموض وعوامل أخرى اختلف فيه, أما تعددية الأفهام فتذهب الى أن الحق متعدد بتعدد المعنى المطلوب! وبالتالي فالاجتهاد شيء واختلاف القراءات وتعددها شيء آخر, فتعدد القراءات يؤدي في النتيجة الى تغير الشريعة حسب الزمان والمكان, وان كل المذاهب والتيارات والأديان والملل على حق! حتى ذهب البعض الى أن النبي صلى الله عليه وآله لو بُعث في حاضرنا هذا لوجدناه قد أتى بشريعة جديدة غير تلك الشريعة التي أتى بها قبل أربعة عشر قرنا!! ويستند هذا الرأي الى التعددية الدينية وبعض النظريات الحديثة الأخرى في فهم النص[20].
وفي المجمل فإن التعددية في القراءات الدينية قد اصطبغت بعناصر ثلاثة: الأنسنة والعقلنة والأرخنة. فالأنسنة تعني تنزيل مستوى النص المقدس الى مستوى النص الإنساني والتعامل معه كأي نص آخر أنتجه الإنسان! أما العقلنة فتعني عند هؤلاء ادراك كل شيء بالعقل وتحكيمه حتى على القضايا الغيبية التي يُعتمد فيها على الجانب النقلي, والعنصر الثالث وهو الأرخنة فتعني عند التعدديين حدّ النص الديني بتاريخه الذي نزل فيه, وعدم امتداده كحكم الى باقي الأزمنة اللاحقة, أي عدم جريانه مع الزمن أو تطبيقه على موارده في كل زمان ومكان, وهذه العناصر الثلاثة عناصر مستجلبة من الواقع الغربي الغريب عن واقعنا الإسلامي. وإجمالا فإن أصحاب هذه النظرية يدعون الى تحديث الدين واستخلاص مفاهيم من النص الديني تنسجم مع فلسفة الحداثة وتقوم على الإيمان الفردي, وعلى قدر التخلص من أشكال التدين التراثية يكون نهوض الدين بمقتضى التحديث[21].
أما فائدة النظرية على المستوى الاجتماعي ولا سيما في إشاعة السلم والأمان فالمسلمون في غنى عنها, وهم غير محتاجين إليها, إذ ضمن هذا الدين للجميع حرية التعبد والفكر, وأكد على إشاعة الأمن والسلام والتسامح وتحية السلام, فمن ينكر تلك الوثيقة التي أقرّها النبي محمد (ص) في المدينة, التي كانت دستورا ضمن لليهودي والنصراني كما للمسلم العيش بحرية وكرامة ضمن دولة الإسلام! لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كغيرهم مع اختلاف العناوين! ومن ينكر ابن الراوندي الذي عاش في القرن الخامس الهجري مع كونه ملحدا لم يمسه أحد بأذى الى أن مات! فالشريعة ضامنة للإنسان حياته وسلامته على أن لا يتجاوز الحد في السلوك والأفعال وإثارة الفتن بين الناس, أما مسألة تناقض النص الديني مع العلم, فلا يوجد دين كالإسلام يدعو الى احترام العلم والحث على طلبه ولو كان في الصين التي تبعد مسافات يبلغ سفرها أشهرا! هذا إن لم نقل أن العلم في العصر الحديث ونظرياته ابتُليت بالهرمنة والغثيان كما في نظريات: النسبية, والكم, والأوتار, والثقوب السوداء, وهلم جر! نعم هي صحيحة من جانب بيد أنها انخرطت في الوهم من جانب آخر. والنص الديني متفاعل مع الواقع وينسجم مع متطلبات المرحلة, وخير شاهد على ذلك ما روي عن الإمام الرضا (ع), إذ قال: ((سأل رجل أبا عبد الله الصادق (ع): ما بال هذا القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض الى يوم القيامة))[22].
[1] ـ ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية, ابن زهرة: 2/ 394.
[2] ـ ينظر: التعددية البلورالية الدينية ـ نقد وتحليل ـ الشيخ جعفر السبحاني: 6 ـ 7.
[3] ـ ينظر: نقد الخطاب الديني, نصر حامد أبو زيد: 130.
[4] ـ ينظر: الشيخ محمد عبده مفكرا عربيا ورائدا للإصلاح الديني والاجتماعي, عاطف العراقي: 389 ـ 395.
[5] ـ ينظر: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث, عطية سليمان: 102 ـ 105.
[6] ـ القرآن والتفسير العصري, عائشة بنت الشاطئ: 38 ـ 39.
[7] ـ الهرمونطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائق النص ونسبية المعرفة, معتصم السيد أحمد: 20.
[8] ـ ينظر: المعجم الفلسفي, جميل صليبا: 2/ 392 ـ 394.
[9] ـ ينظر: موسوعة لالاند الفلسفية, اندريه لالاند, المجلد3, تعريب: خليل أحمد خليل: 1201 ـ 1204.
[10] ـ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي, محمد حسين الطباطبائي: 195.
[11] ـ ينظر: نقد العقل المحض, عمانوئيل كانت, ترجمة: أحمد الشيباني: 47.
[12] ـ ينظر: فلسفة أوكست كونت, ليفي بريل, ترجمة: محمود قاسم ومحمد بدوي: 69 ـ 71.
[13] ـ ينظر: المدخل الى الهرمونطيقا, أحمد الواعظي: 49.
[14] ـ ينظر: الوجودية المؤمنة والوجودية الملحدة, محمد غلاب: 26.
[15] ـ ينظر: الوجودية, جون ماكوري, ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام: 200.
[16] ـ ينظر: نداء الحقيقة, مارتن هايدجر, ترجمة عبد الغفار مكاوي: 155.
[17] ـ ينظر: طريق الفيلسوف, جان فال, ترجمة: أحمد حمدي محمود: 321.
[18] ـ ينظر: مستقبل الثقافة في مصر, طه حسين: 28.
[19] ـ ينظر: التأويل في مختلف الآراء والمذاهب: محمد هادي معرفة: 154.
[20] ـ ينظر: الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية, محمود شكري الآلوسي البغدادي: 61.
[21] ـ ينظر: تجديد المنهج في تقويم التراث, طه عبد الرحمن: 10 ـ 25.
[22] ـ عيون أخبار الرضا, الصدوق: الحديث 32.
1










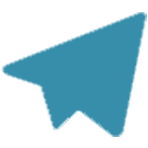
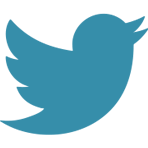





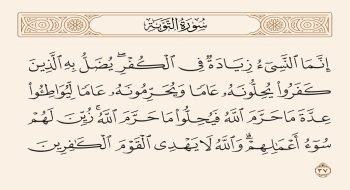






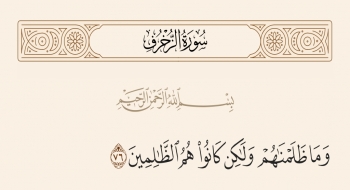



 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)