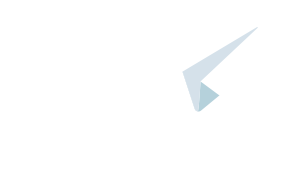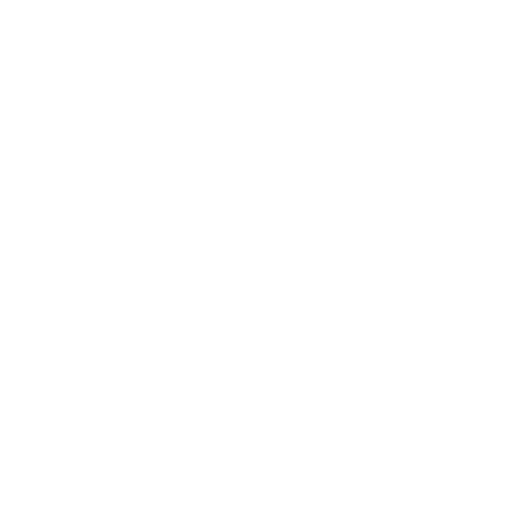تنزيه الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله) عن الوزر

نصّ الشبهة:
فإن قيل فما معنى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ أوليس هذا صريحًا في وقوع المعاصي منه (صلى الله عليه وآله)؟
الجواب:
قلنا: أمّا الوزر في أصل اللغة فهو الثقل، وإنّما سُمّيت الذنوب بأنّها أوزارًا؛ لأنَّها تثقل كاسبها وحاملها، فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكلّ شيء أثقل الإنسان وغمّه وكدّه وجهده جاز أن يُسمّى وزرًا، تشبيهًا بالوزر الذي هو الثقل الحقيقيّ.
وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية إنّما أراد به غمّه (صلى الله عليه وآله) وهمّه بما كان عليه قومه من الشرك، وأنّه كان هو وأصحابه بينهم مستضعفًا مقهورًا، فكلّ ذلك ممّا يتعب الفكر ويكدّ النفس.
فلمّا أنّ أعلى الله كلمته ونشر دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيرًا له بمواقع النعمة عليه، ليقابله بالشكر والثناء والحمد.
ويقوّي هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وقوله (عزّ وجلّ): ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ والعسر بالشدائد والغموم أشبه، وكذلك اليسر بتفريج الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه.
فإن قيل: هذا التأويل يبطله أنّ هذه السورة مكيّة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في الحال الذي ذكرتم أنّها تغمّه من ضعف الكلمة وشدّة الخوف من الأعداء، وقبل أن يعلي الله كلمة المسلمين على المشركين، فلا وجه لما ذكرتموه.
قلنا: عن هذا السؤال جوابان: أحدهما أنّه تعالى لمّا بشره بأنّه يعلي دينه على الدين كلّه ويظهره عليه ويشفى (صلى الله عليه وآله) من أعدائه وغيظه، وغيظ المؤمنين به، كان بذلك وضعًا عنه ثقل غمّه بما كان يلحقه من قومه، ومطيّبًا لنفسه ومبّدلاً عسره يسرًا؛ لأنّه يثق بأنّ وعد الله تعالى حقّ ما يخلف، فامتنَّ الله تعالى عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدمته.
والجواب الآخر: أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره الماضي، فالمراد به الاستقبال.
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال. قال الله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾، إلى غير ذلك ممّا شهرته تغني عن ذكره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: تنزيه الأنبياء (عليهم السلام) للسيّد المرتضى علم الهدى، دار الأضواء: ص 161 ـ 162.
1










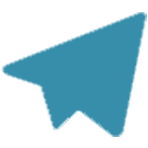
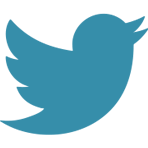





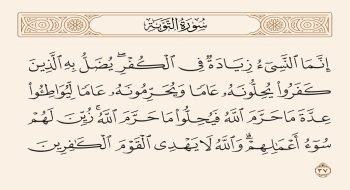






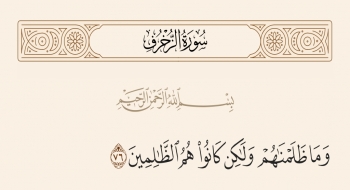



 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)