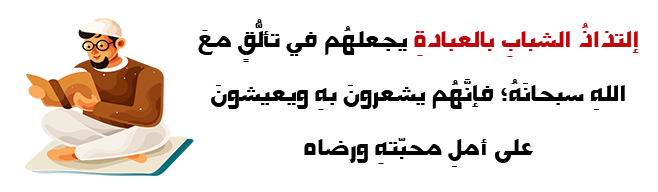
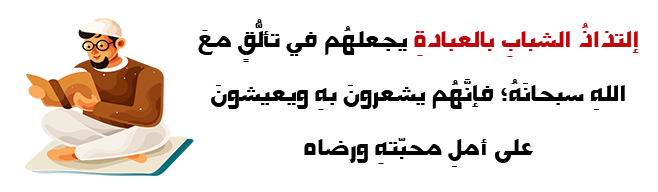

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2016
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 24-8-2016
التاريخ: 24-8-2016
|
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعية.
ومفادها: الاذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك، ولما كانت القاعدة الاولى مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة.
منها: قوله سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].
وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن إسم الموصول فيها، أما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع، والاول هو المتيقن لانه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لأثبات الاحتمال الاخير، فيكون معنى الآية الكريمة، ان الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه واوصله إلى المكلف، فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له.
فينتج ان الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب.
وقد اعترض الشيخ الانصاري على هذا الاستدلال، بأن إرادة الجامع من إسم الموصول غير ممكنة، لان إسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الاولى هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير، فيلزم من إستعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع ان كل لفظ لا يستعمل الا في معنى واحد.
ومنها: قوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة، إنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول، وليس الرسول إلا كمثال للبيان، فكأنه قال لا عقاب بل بيان. ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف، لان الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول الفعلي إلى المكلف. وما نحن بصدده، إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع.
ومنها: قوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [الأنعام: 145] وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أن الله تعالى لقن نبيه (صلى الله عليه وآله) كيفية المحاجة مع اليهود، فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان، وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف للتأمين. ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما اوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعية.
ومنها: قوله تعالى {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115] وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن المراد بالإضلال فيها، أما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، وأما نوع من العقاب، كالخذلان والطرد من ابواب الرحمة، وعلى أي حال فقد أنيط الاضلال ببيان ما يتقون لهم، وحيث أضيف البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال، وهو معنى البراءة.
وأما الروايات فعديدة أيضا.
منها: ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي). والاطلاق يساوق السعة والتأمين، والشاك يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المطلوب.
وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور، وأخرى بمعنى الوصول، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فلا يتم الاستدلال، لان الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية، وإذا كان مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة. وقد يجاب على ذلك بان الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء فلا يطلق على حثيثة الصدور البحتة. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله اليه، بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي، فكأنه النهي يرد على المادة فهناك مورود عليه ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف، وهذا يعني ان الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة، سواء وصل إلى المكلف أو لا، فلا يتم الاستدلال.
ومنها: حديث الرفع وهو الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله )، ومفاده: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
وتقريب الاستدلال بفقرة (رفع ما لا يعلمون) يتم على مرحلتين: الاولى: أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا إحتمالان: أحدهما: أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الاحكام الواقعية الالزامية بغرض العلم بها. والآخر: أن يكون رفعا ظاهريا، بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب
الاحتياط تجاه، وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، لان التكليف المشكوك منفي اما واقعا، واما ظاهرا، ولكن الاحتمال الاول ساقط، لانه يؤدي إلى تقيد الاحكام الواقعية الالزامية بالعلم بها، وقد سبق ان اخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل.
فإن قيل: أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.
قلنا: نعم. ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شى واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، فإذا افترضنا ان العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول، فهذا معناه ان العلم لوحظ متعلقا بالجعل، وان الرفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فلا بد اذن من إفتراض ان الرفع يتعلق بالمجعول، وكذلك العلم فكأنه قال الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به. وعلى هذا الاساس يتعين حمل الرفع على إنه ظاهري لا واقعي، وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محال.
الثانية: أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الارانب مثلا، وعليه، فالرفع الظاهري في فقرة (رفع ما لا يعلمون) قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين.
أما الاحتمال الاول فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة، إذ من الواضح أن المقصود منه، فيما إضطروا إليه ونحوه الموضوع الخارجي او الفعل الخارجي لا نفس التكليف فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، فيكون مفاد الجملة حينئذ، أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، كما ان الفعل المضطر اليه مرفوع الحرمة فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية.
والتحقيق أن وحدة السياق، إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، فإذا افترضنا ان اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، غير ان مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي.
وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر (ما لا يعلمون) أن يكون نفس ما بأزاء اسم الموصول غير معلوم، فان كان ما بأزائه التكليف فهو بنفسه ليس مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا. فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف، ومعه يختص بالشبهة الحكمية.
ويرد عليه أولا: أن بالإمكان أن يكون ما بأزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة. وثانيا: لو سلمنا ان ما بأزاء اسم الموصول ينبغي ان يكون هو التكليف فأن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكيمة، لان التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا. وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية، وهذا الجامع له فرضيتان:
الاولى: ان يراد باسم الموصول الشيء، سواء كان تكليفا او موضوعا خارجيا.
واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لانه قابل للرفع بنفسه واسناده إلى الموضوع مجازي وبلحاظ حكمه، ولا يمكن الجمع بين الاسناد الحقيقي والمجازي في إستعمال واحد.
والجواب: إن اسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا، لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان.
الثانية: أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الاولى عدم العلم بالجعل، وفي الثانية عدم العلم بالموضوع.
والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الاطلاق فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط. ومنها: رواية زكريا بن يحيى عن آبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم). فان الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط.
وقد يلاحظ على الاستدلال أمران: أحدهما: أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الاحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض إتفاقية. ويرد عليه: أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، بل أسند إليه بما هو رب العالمين، وبيده الامر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم.
والآخر: أن موضوع القضية ما حجب عن العباد، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض.
وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي لا العموم المجموعي.
ومنها: رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (كل شى فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) وتقريب الاستدلال أنها تجعل الحلية مع إفتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية، وهي تمييز الحرام.
فهذه الحلية ظاهرية إذن وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين: الاولى: أن ظاهر قوله (كل شيء فيه حلال وحرام) افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى افراد محللة وافراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم.
الثانية: أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة (بعينه) تأكيدا صرفا، لان العلم بالحرام فيها مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة. وما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الاجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجي؟ وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا؟ وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا، لان التأكيد الصرف خلاف الظاهر. هذه هي أهم النصوص التي إستدل بها على البراءة من الكتاب والسنة. وقد لا حظنا أن بعضها تام الدلالة.
وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين:
الاول: أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول: أن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا لان تشريع الاحكام كان تدريجيا فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. الثاني: أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، كحالة صغره مثلا، فيقول: أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه.
وقد إعترض المحقق النائيني (قدس سره) على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بأن إستصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، إنما يجري إذا كان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث، فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله ان نشك في حدوث النجاسة في الماء، والاثر المطلوب تصحيح الوضوء به، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري إستصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي إن الوضوء به صحيح، وأما إذا كان الاثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، فيكون ذلك الاثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء إستصحاب عدم الحدوث، ومثال ذلك: محل الكلام لان الاثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي إستحقاق العقاب، وهذا الاثر مترتب على مجرد عدم البيان، وعدم العلم بحدوث التكليف - وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - فهو حاصل وجدانا واي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب، وهل هو الا نحو من تحصيل الحاصل.
وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة إعتبارات.
منها: أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه، إذن مجرد عدم العلم، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة.
ومنها: أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته.
والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الاعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الادنى، فليس هناك تحصيل للحاصل.



|
|
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
|
|
لتعزيز التواصل مع الزائرات الأجنبيات : العتبة العلويّة المقدّسة تُطلق دورة لتعليم اللغة الإنجليزية لخادمات القسم النسويّ
|
|
|