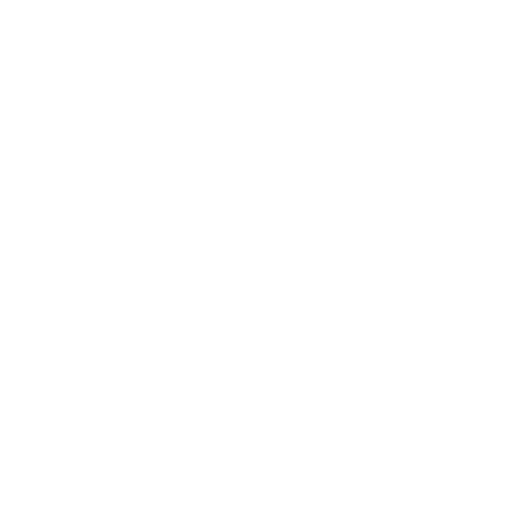الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات


قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية
علاقة العمل بالأخلاق
المؤلف:
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
الأخلاق في القرآن
الجزء والصفحة:
ج1 / ص 168 ـ 176
2024-11-04
1172
صحيح أنّ أعمال الإنسان تتبع أخلاقه الظاهريّة والباطنيّة، بحيث يمكن القول أنّ الإنسان يتأثّر في سلوكه العمليّ، بأخلاقه الباطنيّة الكامنة في عالم اللّاشعور، ولكن من جهةٍ أخرى، يمكن لأعمال الشّخص أن تؤُثّر في أخلاقه، من خلال صياغة المضمون للصّفات الأخلاقيّة في واقع الإنسان ومحتواه الباطني، ومعناه أنّ عمليّة الممارسة المستمرة، لعملٍ ما حسناً كان أو قبيحاً، سيؤثّر في نفسيّة الإنسان، ويحوّل ذلك العمل إلى حالةٍ باطنيّةٍ، وبالاستمرار يصبح من ملكات الإنسان الأخلاقيّة الحسنة، أو القبيحة، وبناءً عليه فإنَّ من الطرق المؤثّرة لتهذيب النّفوس، هو تهذيب الأعمال في حركة الواقع الخارجيّ، فمن مارس الأعمال القبيحة، فسوف تتحوّل على أثر التّكرار إلى ملكةٍ سيّئةٍ في أعماق روحه، وتكون السّبب في ظهور الرّذائل الأخلاقيّة في دائرة السّلوك والممارسة.
وبناءً على ذلك نرى التأكيد في الرّوايات على أنّ يستغفر الناس بسرعةٍ عند الخطأ، ويغسلوا تلك الآثار بماء التوبة، كي لا تخلّف آثارها السّلبيّة على القلب، وتتحوّل إلى ملكاتٍ أخلاقيّةٍ قبيحةٍ.
وبعكسها نجد التأكيد على تكرار الأعمال الصّالحة، بشكلٍ مستمرٍ كي تصبح عادةً عند الإنسان، في واقعه النفسي والروحي.
بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، ونستعرض الآيات الشّريفة التي تشير إلى هذا المعنى:
1 ـ {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطفّفين: 14].
2 ـ {كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [يونس: 12].
3 ـ {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [فاطر: 8].
4 ـ {وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} [النمل: 24].
5 ـ {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 103 - 105].
6 ـ {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 17].
7 ـ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
تفسير واستنتاج:
في «الآية الأولى»: نجد إشارةً إلى معطيات الذّنوب السّلبية على قلب روح الإنسان، فهي تسلب الصّفاء والنّورانيّة منه، وتحلُّ الظّلمة مكانه، فيقول اللَّه تعالى في القرآن الكريم: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.
فجملة: «مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، جاءت بصيغة الفعل المضارع، الذي يدلّ على الاستمرار، بمعنى أنّ الأعمال القبيحة، بإمكانها أن توجد تغييرات وتحوّلات كبيرة، في قلب الإنسان وروحه، فهي كالصّدأ الذي يحجب نورانيّة وصفاء المرآة ويكدّرها.
فالرّذيلة تُقسّي القلب وتسلبه الحَياء، في مقابل الذّنب، فيغلب عليه الشّقاء والظّلمة، أمّا «الرّين» على وزن «عين»، فهو الصّدأ يعلو على الأشياء الثمينة، نتيجةً لرطوبة الجوّ، فيكوّن طبقةً حمراء تُغطّي ذلك الشّيء، وهو علامة على فساد ذلك الفِلِز.
فاختيار هذا التعبير هو اختيار مُناسب جدّاً، حيث أكّدت عليه الرّوايات الإسلاميّة، مراراً وتكراراً، وبحثنا الآتي سيكون حول هذا الموضوع.
وفي «الآية الثانية»: تعدّت مرحلة الرّين وأشارت إلى مرحلة «التّزيين»، وبناءً عليه فالتكرار لعملٍ ما، يبعث على تزيينه في عين الإنسان ونظره، وتتوافق معه النفس الإنسانيّة، لدرجةٍ يعتبره الإنسان من المواهب والافتخارات التي يتميّز بها على الآخرين، فيقول اللَّه تعالى: {كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
فجملة: «مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، وكذلك «المسرفين»، هي دليلٌ واضحٌ على تكرارِ الذّنب من قبلهم، فالتّكرار لها، لا يمحو قُبحها فقط، بل وبالتّدريج ستتحوّل الخطيئة إلى فضيلةٍ في نظرهم، وهذا يعني في الحقيقة المسخ لشخصيّة الإنسان، وهو من النتائج المشؤومة لتكرار الذّنوب.
وهناك خلافٌ حول الفاعل، الذي يزيّن لهؤلاء الأفراد أعمالهم القبيحة فقد ورد في بعض الآيات الكريمة، انتساب ذلك الفعل إلى الباري تعالى، واعتبر كعقابٍ لهم؛ لأنّهم أصرّوا على الذّنوب، فالتّزيين هو استدراج لهم، وليذوقوا وبال أعمالهم فقال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ لا يؤمنونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ}.
وفي الآية (43) من سورة الأنعام، نسب ذلك الفعل للشّيطان الرّجيم، فيقول عن الكفّار المعاندين، الذين لا يحبون النّاصحين: {وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون}.
ومرةً أخرى نسب ذلك الفعل للأصنام، فيقول اللَّه تعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}. وأخرى (وكما ورد في الآية التي هي مورد بحثنا الآن)، ورد بصورة الفعل المبني للمجهول: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً}.
وبنظرةٍ فاحصةٍ نرى أنّ هذه التّعابير لا تتقاطع فيما بينها، بل أحدها يكمّل الآخر، فمرةً تكون الزّينة عاملًا على تكرار العمل، فالتّكرار يُقلّل من قبح العمل، ويصل إلى مرحلةٍ لا يحسّ معها بالذّنب، وبالاستمرار يحسُن في نظر صاحبه، فيُقيّده ولا يستطيع التّحرر من ذلك الفخ، الذي نُصب له، وهي حقيقةٌ يمكن للإنسان أن يلمسها بالتتبّع والنّظر لحال المجرمين.
وفي موارد أخرى، فإنّ الوساوس الشّيطانيّة الخارجيّة، والوساوس الباطنيّة النفسيّة، تزيّن للإنسان سوء عمله، ويصل الأمر به إلى ارتكاب الكبائر، بحجة أنّه يؤدّي واجبه الدّيني فيغتاب شخصاً ما، بدون ذنبٍ وهو يتصوّر أنّه على حقٍّ، ولكن الحسد في الواقع هو الذي يدفعه الى ذلك، والتاريخ مليء بمثل هذه الجنايات الفظيعة، فوساوس النّفس والشّيطان لا تعمل على التّستر على قبح العمل فقط، بل تجعله من افتخاراته.
وربّما يعاقب الباري تعالى أشخاصاً لعنادهم وعدم قبولهم النصيحة، ولا يكون العقاب إلّا بتزيين سوء عمل الإنسان، لتشتدّ عقوبته ويفتضح أكثر فأكثر.
ويجب التّنويه، إلى أنّه وطبقاً للتّوحيد الأفعاليّ، فإنّ كلّ عملٍ وأثرٍ موجودٍ في هذا العالم، يمكن أن يُنسب إلى اللَّه تعالى؛ لأنّ ذاته المقدّسة هي علّةٌ العلل، ولا يعني هذا الأمر أنّ الأفراد قد اجبروا على أفعالهم، فالحمد للَّه الذي جعل القوّة والقدرة على الفعل ومنَحها لِعباده، واللعنة على الذين يستعملون تلك القوّة في دائرة الشر والذّنوب.
وربّما تقتضي طبيعة الأشياء، التّزيين والزخرفة، فنقرأ في الآية (14) من سورة آل عمران: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: 14].
وإحدى العوامل لتزيين الأعمال القبيحة في نظر الشّخص، التّكرار لها، فهو يُؤثّر في نفس وروح الإنسان، ويغيّر أخلاقه، والعكس صحيحٌ، فإنّ تكرار الأعمال الحسنة يصبح ملكةً بالتدريج عند الإنسان، ويبدّله إلى أخلاقٍ فاضلةٍ، ولذلك ولأجل تهذيب النّفوس ونمو الفضائل الأخلاقيّة، نوصي السّالكين في هذا الطّريق، بالاستعانة بتكرار الأعمال الصّالحة، وأن يحذروا من تكرار الأعمال السيئة، فالأوّل هو المعين الناصح للإنسان، والثاني عدوّ غدّار.
و«الآية الثالثة»: تتحدّث عن تزيين سوء أعمال الإنسان أيضاً، فيقول تعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً}.
فكما جاء في تفسير الآية السّابقة: فإنّ من العوامل لتزيين سوء الأعمال هو التّكرار، والتّطبيع عليها، والتّدريج يؤدّي إلى أن يفقد الإنسان، الإحساس بِقُبحها، وسوف يولع بها ويفتخر أيضاً.
واللّطيف أنّ القرآن الكريم، عندما يسأل ذلك السّؤال، لا يذكر النّقطة المقابلة لها، بصورةٍ مباشرةٍ، ويفسح المجال للسّامع أن يتصوّر النّقطة المقابلة بنفسه، ويتفهّمها أكثر، فهو يريد أن يقول: هل أنّ هذا الفرد، يتساوى مع من يميّز الحق من الباطل في حركة الحياة؟، أو هل أنّ هؤلاء الأفراد، يشبهون الأفراد من ذوي القلوب الطّاهرة، الذين يعيشون حالة الاهتمام بمحاسبة أنفسهم، والبعد عن القبائح...؟!
ويجب الانتباه، الى أنّ اللَّه تعالى يقول، في ذيل الآية مخاطباً رسوله الكريم: {فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} وهو في الحقيقة عقابٌ للّذين يفعلون القبائح، فيجب أن تكون عاقبتهم كذلك.
وقد جاء في تفسير «في ظلال القرآن»: أنّ الباري تعالى إذا أراد أن يهدي الإنسان للخير، «بسبب نيّته وعمله»، فيجد في قلبه الحساسيّة والتّوجه الخاص لسوء الأعمال، فهو دائماً على حذرٍ من الشّيطان والخطأ والزّيغ ولا يأمن الإختبار، وينتظر المَدد الإلهي دائماً، وهنا يكون الفصل بين طريق الهداية والفلاح، وبين خطّ الضّلال والهلاك(1).
وقد ورد أنّ أحد أصحاب الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ (أو أحد أصحاب الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ)، قال: سألت الإمام (عليه السلام) ما هو العجب الذي يبطل عمل الإنسان؟ فقال (عليه السلام): ((العجب درجات منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسنًا فيعجبه ويحسب أنّه يحسن صنعًا ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله (عزّ وجلّ) والله عليه فيه المنّ)) (2).
و«الآية الرابعة»: تتحدّث عن مَلِكَة سَبأ، وعاقبتها والأخبار التي جاء بها الهدهد لسليمان ـ عليه السلام ـ من تلك الأرض وأولئك القوم: {وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ}.
فالشّمس مع نورها الوهّاج، وعظمتها وفائدتها؛ لكنّ طلوعها وغروبها وانحجابها بالغيوم، تبيّن أنّها هي بدورها أيضاً تابعة لقوانين الكون، ولا إرادة لها أبداً، ولا تستحق التقدير. ولكنّ الآباء علّمت الأبناء، والتربية الخاطئة والسُنّة الضّالة، وتكرار العمل، حَدَت بالنّاس لتصوّر القبيح في صورةٍ حسنةٍ، وفي بعض البلدان، يعبدون البقر، ويؤدّون الطّقوس أمامها، وهو مدعاةٌ للسّخريّة والضَّحِك، ولكنهم يفتخرون بذلك.
ومن العوامل المهمّة لذلك، هو التّكرار لذلك العمل الذي عوّد الإنسان على القبيح وجعله حسناً.
وقد يُنسب هذا الفعل للشّيطان، ولكن في الحقيقة، الشّيطان له وسائل متعدّدة للغواية، ومنها التّكرار للقبيح والتعوّد عليه.
«الآية الخامسة»: لها نفس المحتوى الوارد في الآيات السابقة، ولكن بتعبيراتٍ جديدةٍ، حيث قال تعالى، مخاطباً رسوله الكريم: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً».
فالكلام عن المتضرّر الأوّل في المعركة، وهو الذي يصرف عمره وفكره وطاقته في الطّريق الغلط، وهو يحسب أنّه يُحسن صُنعاً، وهو فرحٌ ومسرورٌ ويفتخر بذلك.
فلماذا يُبتلى الإنسان بهذه المصائب؟ ليس ذلك إلّا لأنّه تعوّد على القبائح، وإتّباع هوى النّفس، والأنانية والعجب، فتجعل الحُجب على قلبه وعقله، فلا يرى الحقيقة واضحةً صائبةً كما هي.
والنتيجة لهذا الأمر، جاءت في الآية التي بعدها فقال تعالى: {اولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالَهُمُ}.
وفسّرت الروايات الإسلاميّة، هذه الآية بتفسيرٍ وتعبيراتٍ متعددةٍ، وكلٌّ منها هو في الحقيقة مصداقٌ للآية، فبعضها فسّرت الآية بالمنكرين لولاية أميرالمؤمنين (عليه السلام) وبعضها فسّرت الآية بالرّهبان المسيحيّين، فهم الذين يتركون الدنيا بالكامل ولذائذها، وهم في الحقيقة مخطئون، ويتحرّكون في دائرة الفكر والعمل في الطّريق المنحرف.
والبعض الآخر من الروايات، ذكرت في تفسيرها أنّهم أهل البدع من المسلمين؛ وأخرى فسّروها، بخوارج النّهروان، وقال آخرون: أنّها نزلت في أهل البدع من اليهود والنّصارى، فكلّ هؤلاء الأشخاص على خطأ وأعمالهم مليئةٌ بالإجرام والظّلم، ولكنّهم كانوا يحسبون أنّهم على صواب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جملة: «حبطت أعمالهم»، التي جاءت في ذيل الآية، هي من مادة «حبط» ومن معانيها المعروفة هو البعير أو حيوان آخر، يأكل العلف بشراهةٍ، حتّى العلف السّام والضار بحيث يؤدي إلى انتفاخ بطنه، وقد يؤدّي به في بعض الأحيان للموت، فالبعض يتصوّر أنّ ذلك هو دليل على قوته وقدرته، ولكنّ الحقيقة هي غير ذلك، بل هو المرض بعينه، أو مقدّمةٌ لموته، ولكن الجهّال يعتبرونها من القوّة والقدرة.
وقسمٌ من النّاس يبتلون بمثل هذه العاقبة، فيكون كلّ سعيهم وقوتهم لهلاك أنفسهم، وهم يتصوّرون أنّهم سلكوا طريق السّعادة والرفاه.
الآية السادسة: تتناول مسألة قبول التّوبة من قبل اللَّه تعالى، لمن تتوفّر فيهم بعض الشّرائط:
ـ الّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ولا يعرفون عواقب الذّنوب على نحو الحقيقة.
ـ الّذين تابوا بسرعةٍ من أعمالهم القبيحة، فأولئك الّذين تشملهم الرّحمة الإلهيَّة، ويقبل اللَّه تعالى توبتهم، فقال: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً}.
والمراد من كلمة «الجهالة»، التي وردت في الآية، ليس هو الجهل المطلق الذي يوجب العذر؛ لأنّ العمل في حالات الجهل المطلق، لا يعتبر من الذنب، بل هو الجهل النّسبي الذي لا يعلم معه عواقب ومعطيات الذّنوب في حركة الواقع والحياة.
وأمّا جملة: «يتوبون من قريب»، فقال البعض أنّها قبل الموت، ولكن إطلاق كلمة «قريب»، على فترة ما قبل الموت، التي ربّما تستغرق (50) سنة أو أكثر، لا تكون مناسبة لهذا النوع من التّفسير، واستدلّ مؤيّدو هذه النظريّة، برواياتٍ لا تشير إلى هذا التفسير، ولكنّها بيانٌ مستقلٌ ومنفصلٌ عنه.
وقال البعض الآخر: إنّها الزّمان القريب لارتكاب الذّنب، حتّى تمسح التوبة الآثار السّيئة للذنب في روح ونفس الإنسان، وفي غير هذه الصّورة، فستبقى الآثار في القلب، وهو ما يناسب كلمة القريب عُرفاً ولغةً.
الآية السابعة: تناولت مسألة الزكاة ومعطياتها، فجاء الأمر للرّسول الكريم: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}.
ويتحدّث القرآن الكريم عن الزّكاة، وبيان معطياتها الأخلاقيّة والمعنويّة، في خطّ التربية، ويقول: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.
نعم، فإنّ دفع الزكاة يحدّ من الرّكون إلى الدنيا وزخارفها، ويقمع البخل في واقع النفس
البشريّة، ويحث الإنسان على مراعاة حقوق الآخرين، ويغرس فيه حبّ السّخاء والإنسانيّة.
وعلاوةً على ذلك، فإن دفع الزّكاة يقف بوجه المفاسد النّاشئة عن الفقر والحرمان، وبأداء تلك الفريضة الإلهيّة، نكون قد شاركنا في إزالتها نهائياً، من واقع المجتمع، لذلك فإنّ الزّكاة تسهم في رفع الرّذيلة والفقر في حركة الإنسان والحياة، وتُحلّي الإنسان بالفضائل الأخلاقيّة، وهذا الأخير هو موضوع بحثنا، وهو دور العمل الصّالح والطّالح، في تحريك عناصر الخير والشّر، والفضائل والرذائل الأخلاقية، في واقع الإنسان والمجتمع.
وجاء نفس هذا التعبير بشكلٍ آخر في آية الحجاب فيقول تعال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
فهذه الآية الشّريفة، تبيّن بوضوح أنّ التعفف في العمل يبعث على طهارة ونظافة القلب، وبالعكس فإنّ الجرأة على ارتكاب المنكر وعدم الحياء، يلوّث روح وقلب الإنسان، ويعمّق في نفسه الميل إلى الرذائل الأخلاقيّة.
النّتيجة:
كان الهدف من شرح الآيات الآنفة الذّكر، هو معرفة تأثير الأعمال في الأخلاق، وبلورتها لروح الإنسان، فلأجل بناء الذّات وتهذيب النّفس، يتوجّب مراقبة أعمالنا من موقع الحذر والانضباط والمسؤوليّة؛ لأنّ تكرار الذّنب والإثم يذهب بقبحه من جهة، ومن جهة أخرى يمنح الإنسان التعوّد عليه، وبالتدريج يصبح ذلك العمل ملكةً لديه، ولا يزعجه فقط، بل ويتحول إلى عنصر فخرٍ من افتخاراته.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











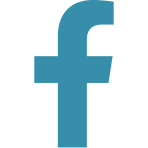

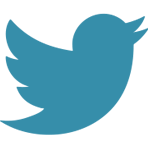

 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)