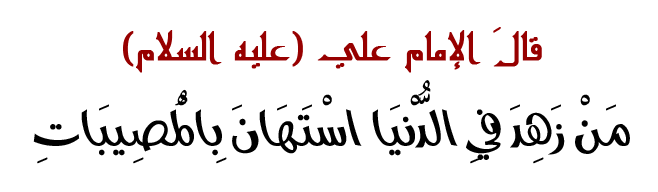
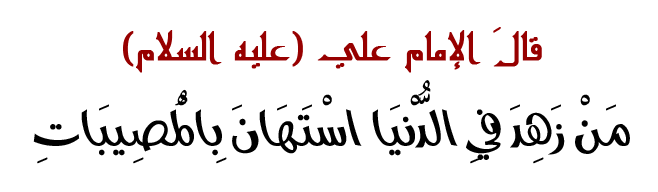

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-26
التاريخ: 2023-06-18
التاريخ: 2023-09-11
التاريخ: 2024-03-12
|
احكام اللباس
يقول تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]
خلقناه لكم بتدبيرات [1] سماوية وأسباب نازلة منه ، ونظيره قوله تعالى {وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر: 6] وقوله {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: 25] فنبّه على أنّ للأمور السماوية كالمطر دخلا في حصول اللباس وغيره أو إشارة إلى علوّ رتبته وجلال مرتبته تعالى ، فان منه إلينا نزول من العليا الى السفلى ، وفي الكشاف : جعل ما في الأرض من السماء لأنّه قضي ثمّ وكتب.
وفي الكنز لأنّ التأثير بسبب العلويّات أو عند مقابلاتها وملاقياتها على اختلاف الرأيين ، فليتأمل ، وقال القرطبيّ : وقيل ألهمناكم كيفية صنعته ، وقيل هذا الانزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء ليكون مثلا لغيره.
{يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} [الأعراف: 26] صفة لباسا أى يستر عوراتكم وكلّ ما يسوء كشفه منكم ، روي أنّ العرب [2] كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت ، قال القاضي [3] لعلّ ذكر قصّة آدم تقدمة لذلك حتّى يعلم أنّ انكشاف العورة أوّل سوء أصاب الإنسان من الشيطان ، وأنه أغويهم في ذلك كما أغوى أبويهم.
{وَرِيشًا } [الأعراف: 26] [4] عطف على لباسا ، وهو لباس الزينة ، أستعير من ريش الطير لأنّه لباسه وزينته ، فالأول ظاهره وجوب ستر العورة باللباس مطلقا ، فإنّ (يُوارِي سَوْآتِكُمْ) يومئ إلى قبح الكشف ، وأنّ الستر مراد الله تعالى ، وظاهر الثاني استحباب التجمّل باللباس ، ولا يبعد فهم أشراط كون اللباس مباحا ، لأنّ الله تعالى لا يمنّ بالحرام ، وقيل الريش بمعنى الجمال والزينة وأنّه اللباس الأوّل ، ويأتي ما يؤيّده في الآية الثانية ، فيمكن عطفه على (يُوارِي سَوْآتِكُمْ) ولو بتقدير.
وفي المعالم (وَرِيشاً) أي مالا في قول ابن عباس والكسائي ومجاهد والضحّاك والسدّي ، يقال تريّش الرجل إذا تموّل ، وقال القرطبيّ وقيل هو الخصب ورفاهية العيش ، والذي عليه أكثر أهل اللغة ، أنّ الريش ما يستر من لباس أو معيشة ، وقرئ «رياشا» [5] وهو ـ جمع ريش [6] كشعب وشعاب كما في القاضي والكشاف ، وعن الفرّاء أنهما واحد كلبس ولباس ، وفي الكنز ترجيحه بشهادة الجوهريّ. وبأنّ الجمع غير مراد هنا وفيه نظر.
{وَلِبَاسُ التَّقْوَى} [الأعراف: 26] قيل خشية الله ، وقيل العمل الصالح ، وقيل ما علّمه الله وهدى به ، وقيل استشعار تقوى الله فيما أمر ونهى [7] وهو الأظهر وكأنه مآل ما تقدّم من الأقوال ، ومراد الكلبي بأنّه العفاف ، وقول الكشاف أنه الورع والخشية من الله ، ويحتمل رجوع ما قيل إنّه الايمان ، وأنّه الحياء ، وأنّه السمت الحسن أيضا إلى ذلك بوجه.
وقيل ما يقصد به التواضع لله تعالى وعبادته كالصوف والشعر والخشن من الثياب وعن زيد بن علىّ (عليه السلام) أنّه ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ممّا يتّقى به في الحروب ، وقيل : مطلق اللباس الذي يتّقى من الضرر كالحرّ والبرد والجرح ، وفي الكنز تضعيفه بأنّ المتبادر من التقوى غير ذلك شرعا وعرفا.
ورفعه بالابتداء والخبر جملة {ذَلِكَ خَيْرٌ} [الأعراف: 26] أو المفرد الذي هو خير ، وذلك صفة للمبتدإ كأنه قيل : ولباس التقوى المشار إليه خير ، وذلك يراد به تعظيم لباس التقوى أو إشارة إلى مواراة السوءة فإنّه من التقوى ، تفضيلا له على نفس اللباس مطلقا كأنّه يريد أنّ الامتنان عليكم بهدايتكم لستر العورة والاحتراز من القبيح أقوى وأعظم.
وفي الكشاف أو إشارة إلى اللباس المواري للسوأة تفضيلا له على لباس الزينة وهو غير مناسب لما قدّمه من تفسير لباس التقوى بالورع ، وبناء الكلام عليه ، نعم يناسب قول من قال بأنّ لباس التقوى هو اللباس الأوّل أعيد إشارة إلى أنّ ستر العورة من التقوى وأنّه خير من التعرّي في الطواف.
وقيل لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف أي وهو لباس التقوى ، ثمّ قيل : ذلك خير ، ويأتي عليه احتمالان : رجوع هو إلى اللباس الأوّل ، ورجوعه إلى مواراة السوءة ، فتأمل.
وفي قراءة ابن مسعود وابىّ «لباس التقوى خير» وذكره القرطبيّ عن الأعمش [8] وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب عطفا على لباسا وريشا.
وظاهر بعض مشايخنا [9] أنّ الراجح حينئذ أن يراد لباس يتّقى به عن الحرّ والبرد والجرح والقتل ، وأنّ اللباس حينئذ ثلاثة أقسام قد امتنّ الله بها على عباده قال : وحينئذ في (ذلِكَ خَيْرٌ) تأمّل.
ويمكن كونه خيرا لأنه يحصل به الستر والحفظ عن الحرّ والبرد والجرح بخلافهما ، ويحتمل رجوعه إلى اللباس مطلقا انتهى وفيه أما أوّلا منع رجحان ذلك حينئذ ، فان إرادة ما أريد على الرفع احتمال واضح ، نعم هذا القول حينئذ أقرب منه على الرفع ، وثانيا منع لزوم كون اللباس حينئذ ثلاثة فإنه يحتمل اثنين على ما قدّمنا وواحدا كما صرّح به في الكنز.
وأيضا لا إشكال في (ذلِكَ خَيْرٌ) حينئذ لما قاله وغيره ، ورجوعه إلى اللباس مطلقا أو إنزاله كاف بأن يراد بخير أنّه خير كثير كما هو المحتمل مطلقا لا التفضّل كما هو المشهور ، مع احتماله كما لا يخفى.
(ذلِكَ) يعني إنزال اللباس مطلقا أو جميع ما تقدّم (مِنْ آياتِ اللهِ) الدالّة على فضله ورحمته على عباده ، وقيل من آيات الله الدالّة على وجوده بأنّ لذلك خالقا (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) فيعرفون عظيم النعمة فيه أو يتّعظون فيتورّعوا عن القبائح.
في الكشاف : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد ، عقيب ذكر بدوّ السوءة ، وخصف الورق إظهارا للمنّة فيما خلق من اللباس ، ولما في العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة ، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى انتهى واستطراد الاية ينافي ما تقدّم عن القاضي فتأمل فيه ، ويمكن الاتّحاد ، ولكنّه خلاف الظاهر وقول القاضي أنسب بمقصود الشرع ، ولهذا أكّده خصوصا وعموما كرّة بعد أخرى فقال :
{يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 27] لا يوقعنّكم في فتنة وفضيحة بأن يدعوكم أن لا تتذكّروا بآيات الله ولا تتورّعوا عن القبائح ، فيخرجكم من محالّ فضل الله ومواضع رحمته ، فيسلبكم نعمة الله وستره عليكم ، ويحرمكم الجنّة ، أو لا يضلّنّكم عن الدين ولا يصرفنّكم عن الحقّ بأن يدعوكم إلى المعاصي الّتي تميل إليها نفوسكم فيحرمكم الجنّة ، أو لا يقنطنكم بأن لا تدخلوا الجنّة.
(كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) حال كونه (يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما) أو حال من أبويكم وإسناد النزع إليه للتسبّب فيه (لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما) يري كلّا منهما سوأته وسوأة الآخر ، قيل ليرى كلّ واحد سوءة الآخر ، وفيه نظر ، وفي ذلك إشارة إلى أنّ الشيطان لكمال عداوته كان قاصدا ذلك لمزيد الإهانة وفرط الفضيحة فيه ، فيمكن أن يكون إشارة إلى أنّ انكشاف العورة وإن كان فيما بين الزوجين لا يخلو من فضيحة وقبح فليتأمّل فيه.
(إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ) جنوده من الشياطين ، عطف على مؤكّد هو وضمير «أنه» للشأن قصدا للتفخيم المناسب للمقام ، ويمكن كونه لإبليس ، وقرئ «قبيله» بالنصب [10] فهو إمّا عطف على اسم إنّ على أنه لإبليس ، أو يكون الواو بمعنى مع.
(مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) وذلك تعليل للنهي وتحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدوّ المراجى يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون ، فهو شديد المؤنة ، فالحذر كلّ الحذر منه.
في الكشاف : فيه دليل بين أنّ الجنّ لا يرون ، وأنّ إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم ، وأنّ دعوى رؤيتهم زور ومخرفة ، وفيه نظر ، وعن ابن عباس [11] أنّ الله تعالى جعلهم يجرون من بنى آدم مجرى الدم ، وصدور بني آدم مساكن لهم.
(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) أي أعوانا لهم وسلّطناهم عليهم يزيدون في غيّهم عن الزجّاج ، وذلك بأن خلّي بينهم وبينهم لن يكفّ عنهم حتّى تولّوهم ، أو أطاعوهم فيما سوّلوا لهم من مخالفة الله كما في الجوامع.
وفي البيضاوي : بما أوجدنا بينهم من التناسب ، أو بارسالهم عليهم وتمكينهم من جذبهم وخذلانهم ، وحملهم على ما سوّلوا لهم ، وفيهما نظر ، ويمكن أن يقال بأن أوجدهم على ما بينهم من التناسب والتمكّن من التسويل ، ثمّ لم يكفّ عنهم ، ولا يبعد كونه مراد الجوامع ، فلا يجوز للمؤمن أن يأخذه وليا ؛ بل لا يكون حينئذ مؤمنا بل لا يجوز متابعته والميل إلى ما يدعو ، وقد يومئ إلى أنّ الفاسق ليس بمؤمن والله أعلم.
{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [الأعراف: 28] هي ما تبالغ في القبح من الذنوب ، عن ابن عباس [12] ومجاهد هي هنا طوافهم بالبيت عراة ، وعن عطاء هو الشرك ، واللفظ مطلق والتقيد خلاف الظاهر.
(قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها) أي إذا ما نهوا عنها وسئلوا ، اعتذروا واحتجّوا بأمرين : بتقليد الآباء ، والافتراء على الله ، وهو أقبح من الأوّل أو قالوا ذلك ترويجا لها أو تلبيسا وقيل هما جوابان لسؤالين مترتّبين [13].
(قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) بشيء منها فكيف يكون أمركم بها أو آباءكم ، فاذا لا يجوز تقليدهم فيها ، وقيل هو ردّ للثاني وإعراض عن التقليد لظهور فساده (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) إنكار يتضمّن النهى عن الافتراء على الله ، بل عن الأعم من الافتراء تأمل.
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: 29] [14] بالعدل الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كلّ أمر ، فلا يأمر بخلافه من الإفراط أو التفريط في شيء ، فكيف بالفاحشة ، ففي الآية دليل على أنّ الله لا يأمر بالقبيح بل ولا بالمكروه وخلاف الاولى ، وأنه لا يفعل القبيح وأنّ الفعل في نفسه قبيح من غير أمر الشارع ، ونحوه كثير كقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] وغيره.
فقول الأشعريّ أنّ الحسن مجرّد قول الشارع افعل ، والقبيح مجرّد قوله لا تفعل ، واضح البطلان ؛ وعن الحسن إنّ الله بعث محمّدا (صلى الله عليه وآله) إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ، وتصديقه قول الله عزوجل {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} [الأعراف: 28] وأما التقليد فقيل يدلّ على عدم جوازه. وأطلق ، وقال القاضي : يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه ، لا مطلقا فافهم.
{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] أي خذوا بثيابكم الّتي تتزيّنون بها عند كلّ صلاة ، وروي [15] عن الحسن بن عليّ (عليه السلام) أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنّ الله جميل يحبّ الجمال فأتجمّل لربّي ، وقرأ الآية.
وقيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة والطواف ، وكانوا يطوفون عراة ، وقالوا : لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ، وقيل : أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة ، كذا في الجوامع ، وعلى الأوّل اعتماد الكشاف أيضا ظاهرا إلّا أنّه قال : كلّما صلّيتم أو طفتم وكانوا يطوفون عراة.
وفي الكنز [16] اتّفق المفسّرون على أنّ المراد به ستر العورة في الصلاة ، والمعالم جعله قول أهل التفسير ، لكن قال لطواف أو صلاة ، وعليه اعتمد القاضي ساكتا عن غيره من الأقوال.
وما روي عن الحسن بن علىّ (عليه السلام) لا ينافي ذلك فان في التعبير بالزينة تنبيها على أنّ لبس الثياب مطلوب من حيث أنها زينة مطلقا ، وإن كان أقلّ الواجب ما يستر العورة ، فيحتمل قراءته (عليه السلام) الآية كذلك ، ويؤيده ما رواه مسلم والنسائي [17] في شأن النزول وهذا يؤيد حمل الريش في الآية المتقدّمة على الجمال والزينة ، واتّحاده مع اللباس الأوّل ، فذلك يؤيد هذا أيضا فيكون الإضافة على تقديره للعهد ، ثمّ على هذا لا يبعد فهم استحباب التمشّط كما في القول الثالث.
وفي التذكرة وسئل الرضا (عليه السلام) [18] عن قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) قال من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة ، بل الطيب كما في الرابع ، بل ما في الخامس ، قال شيخنا [19] دام ظلّه : وقد فسّر بالمشط والسواك والخاتم والسجّادة والسبحة وعلى نحو ذلك ينبغي أن يحمل ما روي [20] في الصحيح ـ ظاهرا ـ عن الصادق (عليه السلام) في الآية أنّه قال في العيدين والجمعة وإن كان أبعد.
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) روي أنّ بني عامر كانوا في أيّام حجّهم لا يأكلون الطعام ، إلّا قوتا ، ولا يأكلون دسما يعظّمون بذلك حجّهم ، فقال المسلمون فأنّا أحقّ أن نفعل ، فنزلت.
(كُلُوا وَاشْرَبُوا) أي من الطيّبات كما سيأتي التنبيه عليه (وَلا تُسْرِفُوا) بتعدّي حدود الله مطلقا بتحريم حلال أو تحليل حرام ، أو غير ذلك ، أو في المأكل والمشرب والملبس ، فلا يجوز الأكل والشرب واللبس مما لا يحلّ ذلك منه ، ولا ينبغي أيضا ما لا يليق بحاله ، ولبس لباس التجمّل وقت النوم والخدمة ، ونحو ذلك ، كما بيّن وفصل في موضعه ، أو في الأكل والشرب واللبس وهو قريب من الثاني.
عن ابن عباس [21] كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك خصلتان : سرف ومخيلة أو في الأكل والشرب إشارة إلى كراهة الإكثار أو تحريمه أو تحريم المؤدّي منه إلى الضرر ، ولهذا قيل جمع الله الطبّ في نصف آية.
(إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) قيل أي يبغضهم ، فينبغي حمل لا تسرفوا على فعل الحرام ، في تفسير البيضاوي : أي لا يرتضي فعلهم وفيه نظر.
{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [الأعراف: 32]
وقد أكد ما تقدّم بقوله (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) الثياب وسائر ما يتجمّل به (الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ) من النبات كالقطن والكتّان ، من الحيوان كالحرير والصوف من المعادن : كما يعمل منه الدروع وغيرها.
(وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) المستلذّات من المآكل والمشارب أو المباحات والاستفهام للإنكار ، ففي الآية دلالة واضحة على أنّ الأشياء المذكورة أو مطلقا لعدم الفرق على الإباحة دون الحرمة ، كما في غيرها كما صرّح الكشاف في قوله (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أي لانتفاعكم بجميع ما خلق فيها ، بل هي وما فيها ، كما دلّ عليه العقل ، فاجتمع العقل والنقل على أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة فغيرها يحتاج إلى دليل فتأمّل.
(قُلْ هِيَ) أي الزينة والطيّبات من الرزق (لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الظرف متعلّق بآمنوا (خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) حال عن المستتر في متعلّق للّذين ، ويوم القيمة ظرف لخالصة ، أي لا يشاركهم غيرهم فيها كما يشاركهم في الدنيا ، أو متعلّق بمتعلّق للّذين أي هي حاصلة للّذين آمنوا في الحيوة الدنيا غير خالصة لهم ، خالصة لهم يوم القيمة ، قيل : ولم يقل ولغيرهم لينبّه على أنّها خلقت لهم بالأصالة ، وأنّ غيرهم تبع كقوله {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 126] وقرئ [22] خالصة بالرفع على أنها خبر بعد خبر.
(كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ثم أكّد عدم حرمة الأشياء بحصر المحرّمات حقيقة أو إضافة بقوله {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] ما تفاحش قبحه أي تزايد ، وقيل هو ما يتعلّق بالفروج (ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) ظاهرها وخفيّها ، قيل ما ظهر طواف الرجال عراة نهارا ، وما بطن طواف النساء كذلك ليلا ، وقيل الزنا سرّا وعلانية.
(وَالْإِثْمَ) أي ما يوجب الإثم عامّ لكلّ ذنب ، فعمم بعد التخصيص ، وقيل شرب الخمر ، وقيل الذنب الذي لا حدّ فيه عن الضحّاك (وَالْبَغْيَ) الظلم والكبر أفرده للمبالغة (بِغَيْرِ الْحَقِّ) متعلّق بالبغي مؤكّد له معنى.
(وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي برهانا وحجّة ، وإفراده كذلك للمبالغة وفيه تهكّم بالمشركين ، حيث أشركوا بالله ما يستحيل منه الإتيان ببرهان لو أمكن ، بل ما لا يقدر على شيء أصلا فكيف على إنزال البرهان ، وتنبيه على حرمة اتّباع ما لم يدلّ عليه برهان.
ويمكن أن يفهم منه وجوب اتّباع البرهان ، لأنّ ترك مقتضى البرهان اتّباع لما لم يدلّ عليه برهان ، فافهم.
(وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) بالإلحاد في صفاته ، والافتراء عليه ، وإسناد ما لم يصدر منه إليه ، ويقال منها أنّ الحكم في المسئلة كذا مع أنه ليس كذلك ، وأن الله يعلم كذا ولم يكن كذلك ، وقيل يدخل فيه الفتوى والقضاء بغير استحقاق ، ولا ريب في وجود محرمات غير المذكورات على بعض الأقوال ، فحينئذ «إنّما» على ذلك للتأكيد أو الحصر إضافيّ أو الآية مخصوصة بها ، فافهم.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3]
كأنّه بيان المستثنى في قوله {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: 1] فمن المحرّمات المتلوّة الميتة ، ولعلّها ما فارقته الروح من الحيوان بغير تذكية شرعية ، وقيل يحتمل أن يكون المراد من الحيوان المأكول اللحم فيكون التحريم من الموت خاصّة كما هو ظاهر السياق ، وفيه منع لعدم منافاته أن يكون هناك جهة أخرى أيضا للحرمة ، مع إطلاق اللفظ أو عمومه.
ثمّ ظاهر ذلك مشعر بأن ما لم تحلّ فيه الحيوة منها لا يدخل في الحرمة ، ولهذا استثناه الأصحاب مؤيّدا بالإجماع على الظاهر والأخبار ، ولا في الميتة حقيقة ، فالاستثناء على التجوّز فافهم.
ثمّ لا ريب أنّ إسناد الحرمة إلى الذوات ليس حقيقة فلا بدّ من اعتبار ما به يصحّ ذلك ، ومع احتمال أمور وعدم أولويّة البعض ، الأولى ما يعمّ الجميع لئلّا يلزم الإجمال ، ولا الترجيح من غير مرجّح ، وهو هنا الانتفاع مطلقا ، وحينئذ فيدلّ على عدم جواز لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرها دبغت أم لا [23] بل سائر الاستعمالات والانتفاعات كما تدلّ عليه الاخبار ، بل إجماع الأصحاب ظاهرا.
أمّا دلالة الآية على نجاسة الميتة فلا ، بل ربّما يقال المتبادر من تحريم الميتة هنا تحريم أكلها كما في الدم ولحم الخنزير ، كتبادر حلّه من قوله (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) فلا يستلزم محذورا ، ولا يدلّ على غيره من الانتفاعات فان ثبت فبغيرها ، تأمّل فيه وسيأتي البحث في التتمّة في الأطعمة إن شاء الله تعالى.
{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5]
الانعام الأزواج الثمانية ، وأكثر ما يقع على الإبل ، وانتصابها بمضمر يفسّره الظاهر ، أو بالعطف على الإنسان في قوله (خَلَقَ الْإِنْسانَ) و (خَلَقَها لَكُمْ) بيان ما خلق لأجله.
الكشاف : أي ما خلقها إلّا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان.
الدفء اسم ما يدفأ به فيتّقى البرد ، وهو اللّباس المعمول من صوف أو وبر أو شعر وكأنّه يشمل الفراء ، وقرئ دف [24] بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء.
(وَمَنافِعُ) هي نسلها ودرّها وظهورها وغير ذلك ، قيل إنّما عبّر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وغيرها وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص ، لأنّ الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم ، والأكل من غيرها من الدجاج والبطّ وصيد البرّ والبحر ، فكغير المعتدّ به وكالجاري مجرى التفكه ، ويحتمل : إنّ طعمتكم منها ، لأنكم تحرثون بالبقر ، فالحبّ والثمار الّتي تأكلونها منها ، وتكتسبون باكراء الإبل ، وتبتغون نتاجها وألبانها وجلودها.
ويمكن أن يقال ذلك باعتبار إفادة «من» التبعيض ، أو لعدم حلّ أكلها لحرمة بعضها ممّا يحرم من الذبيحة ، أو لعدم جواز أكل الكلّ ، وقطع جنسها ، أو باعتبار بعض ذلك مع آخر ممّا يمكن اعتباره معه فيه ، والله أعلم. وظاهر القاضي قوّة أن يكون التقديم للمحافظة على رؤس الآي فقط فافهم.
{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ } [النحل: 80] أي الله هو الذي جعل من جملة بيوتكم الّتي تسكنونها من الحجر والمدر والخيام والأخبية وغيرها سكنا ، والسكن فعل بمعنى مفعول ، وهو ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو ألف قاله الكشاف ، وقيل موضعا تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتّخذة من الحجر والمدر ، فالأوّل مفاد اللغة والثاني مفاد الآية. (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً) كالقباب والأبنية المتّخذة من الأدم والأنطاع قال القاضي ويجوز أن يتناول المتّخذة من الوبر والصوف والشعر ، فإنّها من حيث أنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها فليتأمل.
(تَسْتَخِفُّونَها) تجدونها خفيفة وقت ترحالكم رفعا ولمّا وزمّا ونقلا ، ووقت نزولكم وإقامتكم حلا ونصبا ، ويمكن أن يكون ذلك كلّه يوم الظعن أي السفر ونحوه أيّام الإقامة أي الحضر وإن قلّ فتأمل ، وقيل : الظاهر أنّ الأصواف تختصّ بالضائنة منها ، والأوبار بالإبل ، والأشعار بالمعز ، أو والبقر ، وفيه نظر ، والإضافة إلى ضمير الأنعام لأنّها من جملتها فلا يقدح لو ثبت شيء من ذلك والأثاث أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية ، وقيل المال والمتاع ما يتجر به من سلعة أو ينتفع به مطلقا.
(إِلى حِينٍ) إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى حين مماتكم ، وزاد القاضي : إلى مدة من الزّمان ، فإنّها لصلابتها تبقى مدّة مديدة ، وفي مجمع البيان إلى يوم القيمة عن الحسن. وقيل إلى وقت الموت ، يحتمل أنه أراد به موت المالك أو موت الأنعام ، وقيل إلى وقت البلى والفناء ، وفيه إشارة إلى أنها فانية ، فلا ينبغي للعاقل أن يختارها انتهى.
وقيل الأوّل بعيد ويمكن أن يقال المراد انقضاء الدنيا وانقطاع الإنسان منها فليس ببعيد ، وفي الآية دلالة على جواز اتّخاذ الملابس والفرش وغيرها ، وأنواع انتفاع يمكن من أصوافها وأوبارها وإشعارها ، وجواز الصلاة فيها وعليها إلّا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود ونحوه ، وطهارتها ولو من الميتة لإطلاق اللفظ ، إن قيل فكذا الجلد ، قيل فرق ، على أنّ الجلد من الميتة فتذكّر وتأمل.
{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} [النحل: 81]
(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً) أشياء تستظلّون بها في الحرّ والبرد كالأشجار والأبنية وغيرها ، أو ممّا خلق من المستظلّات ظلالا.
(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً) جمع كنّ وهو ما يستكنّ به من البيوت المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف.
(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ) هي القمصان والثياب من الكتّان والقطن والصوف وغيرها (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي والبرد وترك لدلالة الكلام عليه عرفا ، لجريان العادة بذكر الحرّ والبرد كذلك معا ، وشيوعه حتّى يفهم بالأوّل منهما الثاني أيضا ، فاكتفى به على أنّ البرد أولى بالحكم هنا لأنّ وقاية الثياب من البرد أظهر ، وقصد دفعه بها أكثر ، فيكون مرادا بالطريق الاولى.
وفي الكشاف : لم يذكر البرد لأنّ الوقاية من الحرّ أهمّ عندهم ، وقلّ ما يهمّ البرد لكونه يسيرا محتملا وقيل ما يقي من الحرّ يقي من البرد ، فدلّ ذكر الحر على البرد.
وقال شيخنا دام ظلّه [25] ترك البرد لأنّ ما يقيه يقيه ، واختار الحرّ على البرد ، لانّ المخاطبين أهل الحرّ ، وليس البرد إلّا قليلا ، فالحفظ عنه أهمّ عندهم وقيل إنّ الحر يقتل دون البرد ، ويحتمل أن يكون لأنّ البرد يمكن دفعه بشيء آخر مثل النّار والدّخول في البيوت ، وخصّه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين ، أو لأنّ وقاية الحرّ كانت أهمّ عندهم.
(وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) شدّة الطعن والضرب في الحروب ، والسر بال عام يقع على ما كان من حديد وغيره ، والمراد هنا نحو الدروع والجواشن ، وفي الآية دلالة على إباحة هذه الأشياء عملا وانتفاعا خصوصا في الأغراض المذكورة بل استحبابها أو وجوبها ، وهو ظاهر.
(كَذلِكَ) كإتمام هذه النعم (يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) تنظرون في نعمه الفائضة فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه ، وقرئ تسلمون من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب ، أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك ، وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع.
{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} [النحل: 82، 83] يعرفون نعمه وأنّها منه ثمّ ينكرونها بعبادة غيره ، وقولهم إنّها بشفاعة آلهتنا أو باعراضهم عن شكرها ، وقيل نعمة الله نبوّة محمّد (صلى الله عليه وآله) ، وقيل إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا.
وقيل قولهم لو لا فلان ما أصبت كذا ، لبعض نعم ، وإنّما لا يجوز التكلّم بنحو هذا إذا لم يكن باعتقاد [يعتقد] أنّها من الله ، وأنّه أجراها على يد فلان ، وجعله سببا في نيلها ، فيدلّ على تحريم هذا القول ، ويدلّ عليه بعض الاخبار أيضا فلا بدّ من الاحتياط والاجتناب.
[1] الحق أن الإنزال في القرآن يستعمل كثيرا في إسداء النعمة من الخالق الى المخلوق ، تشبيها للعلو الرتبي بالعلو الحسي ومع هذا المعنى للإنزال يحل كل مشكل في كل مورد استعمل فيه كلمة الانزال ، مثل انزل القرآن وإنزال الحديد واللباس وغيره والله العالم
[2] انظر المجمع ج 2 ص 410 والدر المنثور ج 3 ص 75 الى 78.
[3] البيضاوي ج 2 ص 223 ط مصطفى محمد.
[4] قال في مقاييس اللغة ج 2 ص 466 الراء والياء والشين أصل واحد يدل على حسن الحال وما يكتسب الإنسان من خير فالريش الخير والرياش المال ورشت فلانا أريشه ريشا إذا قمت بمصلحة حاله.
[5] انظر شواذ القرآن لابن خالويه ص 43 وكنز العرفان ج 1 ص 93 وروح المعاني ج 8 ص 90 والقرطبي ج 7 ص 184 والدر المنثور ج 3 ص 76.
[6] قال المؤلف قدسسره في هامش الأصل وفي إيجاز البيان : الريش ما يستر الرجل في معيشته وفي جسده ، وعن على (ع) أنه اشترى ثوبا بثلاثة دراهم وقال : الحمد لله الذي هذا من ريشه ، وفي القرطبي : وأنشد سيبويه :
فريشى منكم وهواي معكم
وان كانت زيارتكم لماما
وحكى أبو حاتم عن أبى عبيدة : «وهبت له دابة بريشها» أى بكسوتها وما عليها من اللباس. انتهى.
أقول : راجع في ذلك القرطبي ج 7 ص 184.
[7] قال المؤلف قده في الهامش : ومنه قيل :
إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تقلب عريانا وان كان كاسيا
فخير لباس المرء طاعة ربه
ولا خير فيمن كان لله عاصيا
انتهى ، وأقول : أنشده في القرطبي 7 / 184.
[8] انظر القرطبي ج 7 ص 185 وشواذ القرآن لابن خالويه ص 43 وفيه نقل قراءة ولبوس التقوى أيضا وأما قراءة ولباس التقوى بنصب اللباس فهو مروي عن قراء المدينة والكسائي انظر المجمع ج 2 ص 408.
[9] انظر زبدة البيان ص 70 ط المرتضوي.
[10] انظر شواذ القرآن ص 43 وروح المعاني ج 8 ص 91 عن اليزيدي.
[11] المجمع ج 3 ص 409.
[12] الدر المنثور ج 3 ص 77.
[13] كأنه لما فعلوها قيل : لم فعلتم؟ فقالوا وجدنا عليها آباءنا ، فقيل : ومن أين أخذ آباؤكم فقالوا : الله أمرنا بها. كذا في هامش الأصل.
[14] قال ابن فارس في مقاييس اللغة ج 5 ص 85 القاف والسين والطاء أصل وصحيح يدل على معنيين متضادين والبناء واحد فالقسط العدل ويقال منه أقسط يقسط قال الله تعالى ان الله يحب المقسطين والقسط بفتح القاف الجور انتهى ما أردنا نقله وسرد الكلمة ابن الأنباري في الأضداد بالرقم 26 ص 58 ط كويت.
[15] المجمع ج 2 ص 412 والعياشي ج 2 ص 14 والبرهان ج 2 ص 10 ونور الثقلين ج 2 ص 19.
[16] كنز العرفان ج 1 ص 95.
[17] راجع القرطبي ج 7 ص 189 وانظر أيضا الدر المنثور ج 3 ص 78 أخرجه عن أبي أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس.
[18] انظر البرهان ج 2 ص 9 وص 10.
[19] انظر زبدة البيان ص 72 ط المرتضوي.
[20] انظر البرهان ج 2 ص 9 الحديث 1 وفيه أحاديث أخر أيضا بهذا المضمون فانظر ص 9 وص 10 من الكتاب.
[21] ترى هذا المضمون مرويا عن ابن عباس في الدر المنثور ج 3 ص 79 بألفاظ مختلفة.
[22] انظر المجمع ج 2 ص 412.
[23] انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 من ص 97 الى ص 101.
[24] انظر روح المعاني ج 14 ص 89 وص 90 وفيه نقل قراءة دف بضم الفاء وشدها وتنوينها ودف بنقل الحركة والحذف بدون التشديد ودف بضم الفاء من غير همزة وهي محركة بحركتها ولم ينقل هذه القراءات ابن خالويه في شواذ القران وفي المقاييس ج 2 ص 287 الدال والفاء والهمزة أصل واحد يدل على خلاف البرد.
[25] زبدة البيان 75 ط المرتضوي.



|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تشارك في انطلاق فعاليات أسبوع الولاية المُقام في قضاء الهاشمية
|
|
|