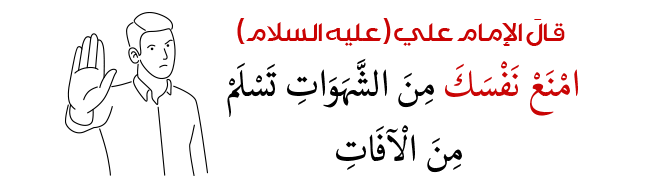
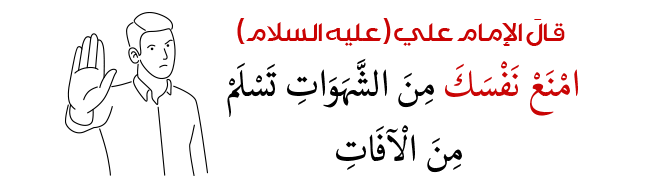

 علم الكيمياء
علم الكيمياء 
 الكيمياء التحليلية
الكيمياء التحليلية 
 الكيمياء الحياتية
الكيمياء الحياتية 
 الكيمياء العضوية
الكيمياء العضوية 
 الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء الفيزيائية
 الكيمياء اللاعضوية
الكيمياء اللاعضوية 
 مواضيع اخرى في الكيمياء
مواضيع اخرى في الكيمياء
 الكيمياء الصناعية
الكيمياء الصناعية |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-7-2018
التاريخ: 11-9-2020
التاريخ: 22-10-2019
التاريخ: 23-8-2019
|
هنالك العديد من استعمالات البوليمرات ثنائية الاستيلين يمكن اجمالها بما ياتي:
1. ان البوليمرات ثنائية الاستيلين تتاثر بالحرارة وتعطي الوانا غير عكسية ثابتة لذلك استخدمت احبارا في الطباعة(1).
2. استعملت في بعض العمليات الالكترونية الضوئية مثل (الافلام) وذلك لتاثرها باشعة السينية (X-ray).
3. تستخدم كمقياس للجرع الاشعاعية لاسيما اشعة كاما( 3،2).
4. تستخدم للسيطرة على الوميض الضوئي السريع الشدة.
5. تستخدم لجعل الضوء مركزا في نقطة واحدة بدلا من مسار عريض.
6. تستخدم البوليمرات الثنائية الاستيلين بمدى واسع في التطبيقات البصرية، اذ استطاع الباحثان (Srikhirin and Cham)(4) من تحضير بوليمرات لثنائي الاستيلين امتازت بكونها غير خطية واظهرت فعالية ضوئية، واستخدمت في العديد من التطبيقات البصرية ومن هذه البوليمرات (Biphenyl)-10,12-tetradecadiynoic acid nitromethoxyl biphenyl-10,12-tetradecadiynoic acid
وحضر الباحث (Chen) وجماعته(5) بوليمرات من الثنائي استيلين محتوية على (Copolyester) مع نسب مختلفة من (Dipropargyl terephthalate, dipropargyl-1,10-decanate) واثبت فعاليته في بعض التطبيقات البصرية والالكترونية. وقام الباحث (Sukwattanasinitt) وجماعته(6) بتحضير البوليمر (Poly(1,6-di-n-Carbazolyl-2,4-hexadiyne)) وامتاز بفعاليته الضوئية وامكن استخدامه في بعض التطبيقات البصرية.
وحضرت بوليمرات قابلة للتشابك تمتاز بخواص ضوئية (المركب 34)، وتم بهذا التحضير تحسين خواص تلك البوليمرات وجعلها تتحمل درجات حرارية عالية كما مبين في المعادلة الاتية(7):
7. ان امتلاك البوليمرات ثنائية الاستيلين خواصا ضوئية جعلها تستخدم في التقنات الضوئية، اذ تمكن الباحث (Sarkar) وجماعته(8) من تحضير بوليمر ثنائي استيلين من المونومر (8-(2-Thienyl)-5,7-octadiynyle-N-phenyl carbamate)، واثبت انه فعال ضوئياً، واستخدم لدراسة الخواص البصرية من الدرجة الثالثة.
8. تعد البوليمرات ثنائية الاستيلين عوامل شابكة لبوليمرات اخرى وذلك لاحتوائها على اواصر ثنائية(10،9).
9. استخدمت في قولبة الشكل المظهري للاغشية الصناعية، حيث قام الباحث (Song) وجماعته(11) بتحضير البوليمر (Bolaamphiphilic) من الشريط الحلزوني الى الياف متناهية الدقة الحمراء ووجد انها تعمل على تحفيز الـ (pH) للانتقال النوعي والانتقالية للـ (Nano-structure).
10. تمكن الباحث (Dutremez) وجماعته(12) من تحضير بوليمر هجين (Metal alkoxide) وهو (Hexa-2,4-diyne-1,6-diol) وقد استخدمه كسيراميك (Carbides).
ان استعمالات البوليمرات ثنائية الاستيلين وجدت لها مجالاً واسعاً في حقل الالكترونيات والمجالات الضوئية والتطبيقات الطبية، حيث استخدمت لتعيين كميات من الفيروسات والبكتريا في جسم الكائن الحي، فمثلا تمكن الباحث Pan و Charych وجماعتهما(14،13 ) من قياس سموم الكوليرا(Cholera toxin) باستعمال (10,12-PDAS). وتمكن باحثين(140) من قياس وجود بكتريا E. coli باستعمال بوليمرات ثنائية الاستيلين مثل
(2,4-PDAS) . وقد استخدم الباحث Reichert وجماعته واخرون(15،14 ) بوليمرات ثنائية الاستيلين الحاوية على الببتيد المتصل بـ lipid في حساب وجود فيروس الانفلونزا وقد استخدمت هذه البوليمرات ايضا لقياس كمية الـ Toxin لحد/ml) m (100، وقد استخدمت البوليمرات ثنائية الاستيلين الحاوية على الببتيدات (peptides) للحصول على تركيب حلزوني حساس لقياس فعالية الادوية المضادة للاحياء المجهرية (Antimicrobial)(16) فضلا عن استخدامها في قياس نسبة السكر بالدم.
وعموما فان قياس تلك المؤثرات الحياتية باستعمال البوليمرات ثنائية الاستيلين يعتمد على تغير التركيب لجسم البوليمر (Polymer backbone)، والذي يتخذ الشكل السلمي (Ladder like structure) حاويا على نظام مقترن من عدم التشبع مما يعطيه صفة تكوين الوان مرئية في المحاليل وان أي تاثير يغير هذا التركيب السلمي يؤدي بالنتيجة الى تغير اللون وهذا يعتمد على الميكانيكية او الآلية التي تؤثر على ذلك وحسب القياس المطلوب، حيث عادة ما تستخدم الببتيدات الحاوية على تراكيب مكونة لجدار الخلية الـ (Liposone) من هذه البوليمرات الثنائية، الاستيلين والحاوية على مجاميع اما فوسفاتية، او كاربوهيدراتية، او دهون، او حاوية على تراكيب ما يشبه تركيب الانزيم، او مثبط الانزيم.
ان أي تاثير على هذه المجاميع سيحدث تغيرا في جسم البوليمر الناتج وبالنتيجة يحدث تغير باللون نتيجة لهذا التغير في التركيب ويعود ذلك الى التاثير المباشر (Interaction) للفيروس او الجسم المضاد، او الانزيم، وهذا التغير باللون يكبر ويعتبر مقياسا للمؤثر (Chromic response) .
ولتوضيح هذه العملية باستخدامات البوليمرات ثنائية الاستيلين كمتحسسات حياتية، نود توضيح ذلك بالايجاز الاتي:
بدأ اهتمام الباحثين باستخدام هذه البوليمرات تطبيقيا نتيجة لنجاح الباحثين في استخدام هذه البوليمرات كمواد تشخيصية لامراض عديدة وتم ذلك بطريقتين هما:
الطريقة الاولى: تعتمد على استخدام المونومر المكون من ثنائي الاستيلين ووضعه على شريحة زجاجية بعد ان يحول الى ليبوسوم (Liposomes) في المحلول المائي عند pH معينة مقاربة لـ pH جسم الكائن الحي.
الطريقة الثانية: تعتمد على استخدام المونومر على شكل اكياس (حويصلات) (Vesicles) وقد وجد ان الطريقة الثانية هي اسهل واكفأ من الطريقة الاولى، لذلك اعتمدت في معظم الابحاث الجارية في الوقت الحاضر(17-18).
ان اول من استخدم الجمع بين الطريقتين هو Singh وجماعته(19) عام (2001) وذلك باستخدام (Vesicle) مثبت على صفيحة من ذهب، حيث ان البروتين الذي هو جزء من وحدة بولي ثنائي الاستيلين الحاوي على مجموعة دهنية (Lipids) وان هذه المجموعة حاوية على مجموعة ثنائي السلفايت (disulfide) تقوم بتثبيت الحويصلة او الاكياس على سطح الذهب وثنائي السلفايت المؤكسد يمنع تجمع هذه الحويصلات، لقد وجد بان صفائح الذهب تحافظ على هذه الحويصلات دون تاثير بشكل مستقر لمدة ثلاثة ايام بمحلول منظم معين. ان استقرارية هذه الحويصلات يعد عاملا مهما جدا لاستخدامها كمتحسسات، اذ ان البوليمرات ثنائية الاستيلين بشكلها الحويصلي المذكور اعلاه هي مستقرة عند (4) °م وبمحلول منظم لمدة سنوات مما يضمن نجاح هذه الطريقة في كل الاوقات كمتحسسات حياتية تشخيصية لمختلف الامراض. وكذلك وجد ان الاملاح المستعملة في تحضير المحاليل المنظمة لا تحطم السلاسل البوليمرية وجعلها بهيئة تكتلات(20).
ان سهولة تحضير البوليمرات ثنائية الاستيلين الحاوية على هذه المجاميع الحساسة يعد عاملا ايجابيا لتسهيل تصميم هذه البوليمرات كمتحسسات(21)، وان هذه البوليمرات تعمل كمتحسسات باعتبار ان لها طرفين الاول مستقطب، والثاني غير مستقطب، والمستقطب هو الذي يحمل المجموعة الوظيفية التي تكون بهيئة دهون (Lipids) حاوية على المتحسس وهو عادة ما يكون اما انزيما او مضادا حياتيا او جزئيا يتم اختياره تبعا للقياس المطلوب (المطلوب تحسسه)، وعادة ما يستخدم الكولين الذي هو جزء مهم من جدار الخلية لهذا الغرض. اما الطرف غير المستقطب فيمثل النهايات الالكيلية من البولي ثنائي الاستيلين وكما مبين في الشكل الاتي:
يتصرف هذا البوليمر الحاوي على الحساس بوصفه طبقة ثنائية (bilayer) وهذه الطبقة الثنائية مشابهة لجدار الخلية، ولذلك فان أي تاثير مرضي سوف يقوم المتحسس اما بعمل فجوة او تغير في تركيب البولي ثنائي الاستيلين السلمي وهذا بدوره يؤثر على اللون ويعطي حساسية لونية معينة. فضلا عن ذلك فان التغير اللوني ينتج عن التغير التركيبي للدهون التي هي جزء من تركيب البولي ثنائي الاستيلين (التي هي رأس البوليمر).
وقد قام Okada وجماعته وباحثين اخرين(22 ) باستخدام بولي ثنائي الاستيلين يحوي على فوسفولايبيز (Phospholipase) وهذا الانزيم هو جزء من عائلة الانزيمات المتخصصة في تحليل الفوسفولايبيز للخلية. وان كل انزيم يكسر الفوسفولايبيز من موقع معين، واذا تعرض البولي ثنائي الاستيلين الذي هو بهيئة حويصلات لهذا التاثير (كسر الاواصر) سوف يؤدي الى تغير في تركيبه وبالنتيجة يؤثر على لونه، وبذلك يكون تحسسه مقترنا بذلك التاثير وكما مبين في الشكل ادناه.
كذلك تم دراسة قابلية الليبدات الفوسفاتية الحاوية على نواة ثنائي الاستيلين [1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sm-glycero-3-phosphocholine] على التشكيل الذاتي لتركيب انبوبة صغيرة في الوسط المائي ومزيج (كحول-ماء) من قبل الباحث (Stvenson)(23) وهي تستعمل للاغراض الطبية، وان البحوث الجارية حاليا تصب بهذا الاتجاه ومن هنا جاء اهتمامنا في دراسة هذا النوع من البوليمرات.
---------------------------------------------------------------------------------------
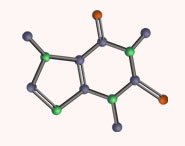


|
|
|
|
ما أبرز التغيرات التي تحدث عند الرجال عندما يصبحون آباءً؟
|
|
|
|
|
|
|
حقائق مثيرة للاهتمام حول الأرض
|
|
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تشارك في انطلاق فعاليات أسبوع الولاية المُقام في قضاء الهاشمية
|
|
|