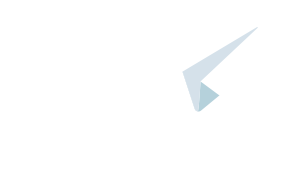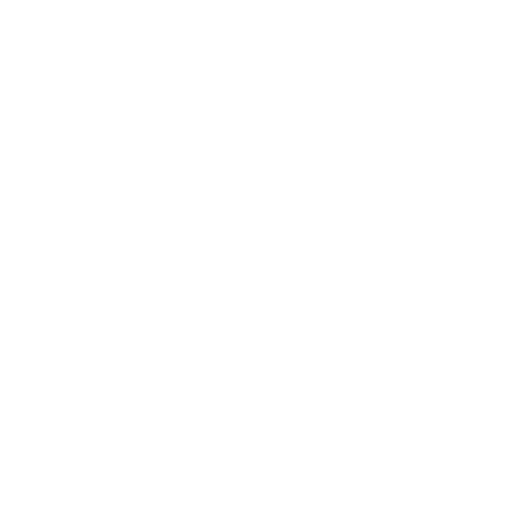تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
إشكالات الشفاعة
المؤلف:
محمد حسين الطباطبائي
المصدر:
تفسير الميزان
الجزء والصفحة:
ج1 , ص139-145
24-09-2014
9261
قد عرفت : أن الشفاعة ثابتة في الجملة لا بالجملة، و ستعرف أن الكتاب و كذلك السنة لا يثبتان أزيد من ذلك، بل التأمل في معناها وحده يقضي بذلك، فإن الشفاعة كما مر يرجع بحسب المعنى إلى التوسط في السببية و التأثير، و لا معنى للإطلاق في السببية و التأثير فلا السبب يكون سببا لكل مسبب من غير شرط و لا مسبب واحد يكون مسببا لكل سبب على الإطلاق فإن ذلك يؤدي إلى بطلان السببية و هو باطل بالضرورة.
و من هنا اشتبه الأمر على النافين للشفاعة حيث توهموها مطلقة من غير شرط فاستشكلوا فيها بأمور و بنوا عليها بطلان هذه الحقيقة القرآنية من غير تدبر فيما يعطيه كلامه تعالى و هاك شطرا منها:
الإشكال الأول: أن رفع العقاب عن المجرم يوم القيامة بعد ما أثبته الله تعالى بالوعيد إما أن يكون عدلا أو ظلما.
و ثانيا: بالحل، فإن رفع العقاب أولا بواسطة الشفاعة إنما يغاير الحكم الأول فيما ذكر من العدل و الظلم لو كان رفع العقاب بالشفاعة نقضا للحكم الأول أو نقضا للحكم باستتباع العقوبة و قد عرفت أنه ليس كذلك بل أثر الشفاعة بالحكومة لا بالمضادة فيها إخراج المجرم عن كونه مصداقا لشمول العقاب بجعله مصداقا لشمول الرحمة من صفات أخرى له تعالى من رحمة و عفو و مغفرة، و منها إفضاله للشافع بالإكرام و الإعظام.
الإشكال الثاني: أن سنة الله تعالى جرت على صون أفعاله من التخلف و الاختلاف، فما قضى و حكم به يجريه على وتيرة واحدة من غير استثناء، و على هذا جرت سنة الأسباب، قال تعالى: {هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ } [الحجر: 41 - 43] ، و قال تعالى {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ} [الأنعام: 153] ، و قال تعالى: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر: 43] و تحقق الشفاعة موجب للاختلاف في الفعل فإن رفع العقاب بالشفاعة عن جميع المجرمين في جميع جرائمهم موجب لنقض الفرض المحال، و لعب ينافي الحكمة قطعا، و رفعه عن بعض المجرمين أو في بعض جرائمهم و ذنوبهم اختلاف في فعله تعالى و تغير و تبدل في سنته الجارية و طريقته الدائمة، إذ لا فرق بين المجرمين في أن كل واحد منهم مجرم و لا بين الذنوب في أن كلا منها ذنب و خروج عن زي العبودية فتخصيص بعضهم أو بعض من أعمالهم بالصفح و الإغماض دون بعض بواسطة الشفاعة محال، و إنما تجري الشفاعة و ما يشبهها في سنة هذه الحياة من ابتناء الأعمال و الأفعال على الأهواء و الأوهام التي ربما تقضي في الحق و الباطل على السواء، و تجري عن الحكمة و عن الجهالة على نسق واحد.
و الجواب أنه لا ريب في أن صراطه تعالى مستقيم و سنته واحدة لكن هذه السنة الواحدة الغير المختلفة ليست قائمة على أصل صفة واحدة من صفاته تعالى كصفة التشريع و الحكم مثلا حتى لا يتخلف حكم عن مورده و لا جزاء حكم عن محله قط بل هي قائمة على ما يستوجبه جميع صفاته المربوط علت صفاته.
توضيح ذلك: أن الله سبحانه هو الواهب المفيض لكل ما في الوجود من حياة أو موت أو رزق أو نعمة أو غير ذلك.
و هي أمور مختلفة لا ترتبط به سبحانه على السواء و لا لرابطة واحدة كيف كانت، فإن فيه بطلان الارتباط و السببية، فهو تعالى لا يشفي مريضا من غير سبب موجب و مصلحة مقتضية و لا يشفيه لأنه الله المميت المنتقم شديد البطش بل لأنه الله الرؤوف الرحيم المنعم الشافي المعافي مثلا و لا يهلك جبارا مستكبرا من غير سبب، لأنه رءوف رحيم به، بل لأنه الله المنتقم الشديد البطش القهار مثلا و هكذا.
و القرآن بذلك ناطق فكل حادث من الحوادث بما يشتمل عليه من جهات الوجود يسند إليه من جهة صفة أو أكثر من صفاته العليا تتسبب إليه بالتلاؤم و الائتلاف الواقع بينها و الاقتضاء المستنتج من ذلك، و إن شئت قلت: كل أمر من الأمور يرتبط به تعالى من جهة ما يتضمنه من المصالح و الخيرات.
إذا عرفت هذا علمت: أن استقامة صراطه و عدم تبدل سنته و عدم اختلاف فعله إنما هي بالنسبة إلى ما يفعله بجميع صفاته المربوطة لا بالنسبة إلى مقتضى صفة قاصرة و إن شئت قلت: بالنسبة إلى ما يتحصل من الفعل و الانفعال و الكسر و الانكسار الواقع بين الحكم و المصالح المرتبطة بالمورد لا بالنسبة إلى مقتضى مصلحة واحدة.
فلو كان هناك سبب الحكم المجعول فقط لم يتغير و لم يختلف في بر و لا فاجر و لا مؤمن و لا كافر.
لكن الأسباب كثيرة ربما استدعى توافق عدة منها غير ما يقتضيه بعضها فافهم ذلك.
فوقوع الشفاعة و ارتفاع العقاب - و ذلك إثر عدة من الأسباب كالرحمة و المغفرة و الحكم و القضاء و إعطاء كل ذي حق حقه و الفصل في القضاء - لا يوجب اختلافا في السنة الجارية و ضلالا في الصراط المستقيم.
الإشكال الثالث: أن الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك أراد غيره حكم به أو لا فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة و نسخها لأجل الشفيع فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به، كأن أخطأ ثم عرف الصواب و رأى أن المصلحة أو العمل في خلاف ما كان يريده أو حكم به.
و أما الحاكم المستبد الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء و هو عالم بأنه ظلم و أن العدل في خلافه و لكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب عنده على العدالة، و كل من النوعين محال على الله تعالى لأن إرادته على حسب علمه و علمه أزلي لا يتغير.
و الجواب أن ذلك منه تعالى ليس من تغير الإرادة و العلم في شيء و إنما التغير في المراد و المعلوم، فهو سبحانه يعلم أن الإنسان الفلاني سيتحول عليه الحالات فيكون في حين كذا على حال كذا لاقتران أسباب و شرائط خاصة فيريد فيه بإرادة، ثم يكون في حين آخر على حال آخر جديد يخالف الأول لاقتران أسباب و شرائط أخر فيريد فيه بإرادة أخرى و كل يوم هو في شأن، و قد قال تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد: 39] ، و قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] ، مثال ذلك: أنا نعلم أن الهواء ستغشاه الظلمة فلا يعمل أبصارنا و الحاجة إليه قائمة ثم تنجلي الظلمة بإنارة الشمس فتتعلق إرادتنا عند إقبال الليل بالاستضاءة بالسراج و عند انقضائه بإطفائه و العلم و الإرادة غير متغيرتين و إنما تغير المعلوم و المراد، فخرجا عن كونهما منطبقا عليه للعلم و الإرادة، و ليس كل علم ينطبق على كل معلوم، و لا كل إرادة تتعلق بكل مراد، نعم تغير العلم و الإرادة المستحيل عليه تعالى هو بطلان انطباق العلم على المعلوم و الإرادة على المراد مع بقاء المعلوم و المراد على حالهما و هو الخطأ و الفسخ، مثل أن ترى شبحا فتحكم بكونه إنسانا ثم يتبين أنه فرس فيتبدل العلم، أو تريد أمرا لمصلحة ما ثم يظهر لك أن المصلحة في خلافه فتنفسخ إرادتك، و هذان غير جائزين في مورده تعالى، و الشفاعة و رفع العقاب بها ليس من هذا القبيل كما عرفت.
الإشكال الرابع: أن وعد الشفاعة منه تعالى أو تبليغها من الأنبياء (عليهم السلام) مستلزم لتجري الناس على المعصية و إغراء لهم على هتك محارم الله تعالى و هو مناف للغرض الوحيد من الدين من سوق الناس إلى العبودية و الطاعة فلا بد من تأويل ما يدل عليه من الكتاب و السنة بما لا يزاحم هذا الأصل البديهي.
و الجواب عنه، أولا: بالنقض بالآيات الدالة على شمول المغفرة و سعة الرحمة كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ، و الآية - كما - مر في غير مورد التوبة بدليل استثنائه الشرك المغفور بالتوبة.
و ثانيا: بالحل: فإن وعد الشفاعة أو تبليغها إنما يستلزم تجري الناس على المعصية و إغراءهم على التمرد و المخالفة بشرطين: أحدهما: تعيين المجرم بنفسه و نعته أو تعيين الذنب الذي تقع فيه الشفاعة تعيينا لا يقع فيه لبس بنحو الإنجاز من غير تعليق بشرط جائز.
الإشكال الخامس: أن العقل لو دل فإنما يدل على إمكان وقوع الشفاعة لا على فعلية وقوعها على أن أصل دلالته ممنوع، و أما النقل فما يتضمنه القرآن لا دلالة فيه على وقوعها فإن فيها آيات دالة على نفي الشفاعة مطلقا كقوله، {لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ } [البقرة: 254] ، و أخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48] و أخرى تفيد النفي بمثل قوله تعالى: "إلا بإذنه": البقرة - 255 و قوله: "إلا من بعد إذنه": يونس - 3، و قوله تعالى: {إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] ، و مثل هذا الاستثناء أي الاستثناء بالإذن و المشية معهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي للإشعار بأن ذلك بإذنه و مشيته سبحانه كقوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6، 7] ، و قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} [هود: 107] ، فليس في القرآن نص قطعي على وقوع الشفاعة و أما السنة فما دلت عليه الروايات من الخصوصيات لا تعويل عليه، و أما المتيقن منها فلا يزيد على ما في الكتاب دلالة.
و الجواب: أما عن الآيات النافية للشفاعة فقد عرفت أنها لا تنفي مطلق الشفاعة بل الشفاعة بغير إذن الله و ارتضائه، و أما عن الآيات النافية لمنفعة الشفاعة على زعم المستشكل فإنها تثبت الشفاعة و لا تنفيه فإن الآيات واقعة في سورة المدثر و إنما تنفي الانتفاع عن طائفة خاصة من المجرمين لا عن جميعهم، و مع ذلك فالشفاعة مضافة لا مجردة مقطوعة عن الإضافة، ففرق بين أن يقول القائل: فلا تنفعهم الشفاعة و بين أن يقول: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فإن المصدر المضاف يشعر بوقوع الفعل في الخارج بخلاف المقطوع عن الإضافة، نص عليه الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز فقوله: شفاعة الشافعين يدل على أن شفاعة ما ستقع غير أن هؤلاء لا ينتفعون بها على أن الإتيان بصيغة الجمع في الشافعين يدل على ذلك أيضا كقوله: "كانت من الغابرين" و قوله: "و كان من الكافرين" و قوله: "فكان من الغاوين" و قوله: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124] و أمثال ذلك، و لو لا ذلك لكان الإتيان بصيغة الجمع و له مدلول زائد على مدلول المفرد لغوا زائدا في الكلام فقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الآيات المثبتة للشفاعة دون النافية.
و أما عن الآيات المشتملة على استثناء الإذن و الارتضاء فدلالة قوله: "إلا بإذنه" و قوله: "إلا من بعد إذنه" على الوقوع و هو مصدر مضاف مما لا ينبغي أن ينكره عارف بأساليب الكلام و كذا القول: بكون قوله: "إلا بإذنه" و قوله: {إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] ، بمعنى واحد و هو المشية مما لا ينبغي الإصغاء إليه، على أن الاستثناء واقع في مورد الشفاعة بوجوه مختلفة كقوله: "إلا بإذنه و إلا من بعد إذنه" و قوله "إلا لمن ارتضى"، و قوله: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86] إلى غير ذلك، فهب: أن الإذن و الارتضاء واحد و هو المشية فهل يمكن التفوه بذلك في قوله: "إلا من شهد بالحق و هم يعلمون".
فهل المراد بهذا الاستثناء استثناء المشية أيضا؟ هذا و أمثاله من المساهلة في البيان مما لا يصح نسبته إلى كلام سوقي فكيف بالكلام البليغ! و كيف بأبلغ الكلام! و أما السنة فسيأتي الكلام في دلالتها على ما يحاذي دلالة الكتاب.
الإشكال السادس: أن الآيات غير صريحة في رفع العقاب الثابت على المجرمين يوم القيامة بعد ثبوت الجرم و لزوم العقاب بل المراد بها شفاعة الأنبياء بمعنى توسطهم بما هم أنبياء بين الناس و بين ربهم بأخذ الأحكام بالوحي و تبليغها الناس و هدايتهم و هذا المقدار كالبذر ينمو و ينشأ منه ما يستقبله من الأقدار و الأوصاف و الأحوال فهم (عليهم السلام) شفعاء المؤمنين في الدنيا و شفعاؤهم في الآخرة.
و الجواب: أنه لا كلام في أن ذلك من مصاديق الشفاعة إلا أن الشفاعة غير مقصورة فيه كما مر بيانه، و من الدليل عليه قوله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء": النساء - 48، و قد مر بيان أن الآية في غير مورد الإيمان و التوبة، و الشفاعة التي قررها المستشكل في الأنبياء إنما هي بطريق الدعوة إلى الإيمان و التوبة.
الإشكال السابع : أن طريق العقل لا يوصل إلى تحقق الشفاعة، و ما نطق به القرآن آيات متشابهة تنفيها تارة و تثبتها أخرى، و ربما قيدتها و ربما أطلقتها، و الأدب الديني الإيمان بها، و إرجاع علمها إلى الله تعالى.
و الجواب عنه: أن المتشابهة من الآيات تصير بإرجاعها إلى المحكمات محكمات مثلها، و هو أمر ميسور لنا غير مضروب دونه الستر، كما سيجيء بيانه عند قوله تعالى {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7].
 الاكثر قراءة في شبهات وردود
الاكثر قراءة في شبهات وردود
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











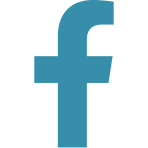

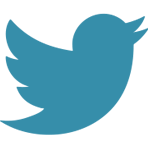

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)