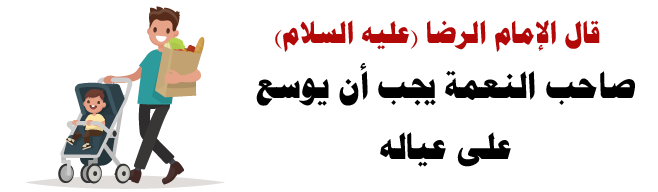
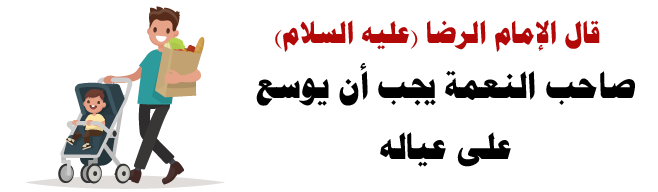

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2020
التاريخ: 11-9-2020
التاريخ: 11-9-2020
التاريخ: 5-9-2020
|
قال تعالى: { وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَويُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُولَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه: 113-122]
{وكذلك} أي: وكما أخبرناك بأخبار القيامة {أنزلناه} أي: أنزلنا هذا الكتاب { قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ} أي: كررنا فيه من الوعيد وذكرناه على وجوه مختلفة وبيناه بألفاظ متفرقة { لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } المعاصي وقيل: ليتقي العرب من قبل أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك { أَويُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا } معناه: أو يجدد القرآن لهم عظة واعتبارا أي: يذكروا به عقاب الله للأمم فيعتبروا وقيل: يحدث لهم شرفا بإيمانهم به وإنما أضاف إحداث الذكر إلى القرآن لأنه يقع عنده كما قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
{ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ } أي: ارتفعت صفاته عن صفات المخلوقين فلا يشبهه أحد في صفاته لأنه أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم وكل عالم وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه وكل قادر وعالم قادر على شيء عاجز عن شيء عالم بشيء جاهل بشيء وما هو عالم به يجوز أن ينساه أويسهوعنه فهو معرض الزوال والله سبحانه لم يزل عالما قادرا ولا يزال كذلك والملك الذي يملك الدنيا والآخرة والحق الذي يحق له الملك وكل ملك سواه يملك بعض الأشياء ويبيد ملكه ويفنى { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ } فيه وجوه (أحدها) أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل (عليه السلام) من إبلاغه فإنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه وهذا كقوله {لا تحرك به لسانك لتعجل به} عن ابن عباس والحسن والجبائي (وثانيها) أن معناه ولا تقرأه لأصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه عن مجاهد وقتادة وعطية وأبي مسلم (وثالثها) إن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه لأنه تعالى إنما ينزله بحسب المصلحة وقت الحاجة.
{ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } أي: استزد من الله سبحانه علما إلى علمك روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بارك الله لي في طلوع شمسه وقيل معناه زدني علما بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك وقيل زدني قرآنا لأنه كلما ازداد من نزول القرآن عليه ازداد علما عن الكلبي { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا } معناه: أمرناه وأوصينا إليه أن لا يقرب الشجرة ولا يأكل منها فترك الأمر عن ابن عباس ولم نجد له عقدا ثابتا وقيل: معناه فنسي من النسيان الذي هو السهو ولم نجد له عزما على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمد عن ابن زيد وجماعة وقيل ولم نجد له حفظا لما أمر به عن عطية وقيل صبرا عن قتادة وروي عن ابن عباس أنه قال إنما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي ومن حمله على النسيان فما الذي نسيه فيه أقوال (أحدها) أنه نسي الوعيد بالخروج من الجنتان أكل (والثاني) أنه نسي قول الله سبحانه {إن هذا عدولك ولزوجك} (والثالث) أنه نسي الاستدلال على أن النهي عن الجنس وقد نهى عن الجنس فنسي وظن أن النهي عن العين .
ثم بين سبحانه تفصيل ما أجمله من قصة آدم (عليه السلام) فقال: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ } قد مر تفسيره {أبى} أي: امتنع من أن يسجد { فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُولَكَ وَلِزَوْجِكَ } حواء { فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى } أي: لا تطيعاه والمعنى لا يكونن سببا لخروجكما من الجنة بغروره ووساوسه {فتشقى} أي فتقع في تعب العمل وكد الاكتساب والنفقة على زوجتك ونفسك ولذلك قال فتشقى ولم يقل فتشقيا وقيل لأن أمرهما في السبب واحد فاستوى حكمهما لاستوائهما في السبب والعلة وقيل لتستقيم رءوس الآي قال سعيد بن جبير أنزل على آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويرشح العرق عن جبينه وذلك هو الشقاوة.
{ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى } أي: في الجنة لسعة طعام الجنة وثيابها { وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى } أي: لا تعطش ولا يصيبك حر الشمس عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة قالوا ليس في الجنة شمس وإنما فيها ضياء ونور وظل ممدود ويسأل هاهنا فيقال كيف جمع بين الجوع والعري وبين الظمأ والضحى والجوع من جنس الظمأ والعري من جنس الضحى وأجيب عن ذلك بجوابين (أحدهما) أن الظمأ أكثر ما يكون من شدة الحر والحر إنما يكون من الضحى وهو الانكشاف للشمس فجمع بينهما لاجتماعهما في المعنى وكذلك الجوع والعري متشابهان من حيث أن الجوع عري في الباطن من الغذاء والعري للجسم في الظاهر (والثاني) إن العرب تلف الكلامين بعضهما ببعض اتكالا على علم المخاطب وأنه يرد كل واحد منهما إلى ما يشاكله كما قال امرؤ القيس :
كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال
ولم أسبإ الزق الروي ولم أقل لخيلي كر كرة بعد إجفال(2)
وكان حقه أن يقول كما قال عبد يغوث :
كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا
ولم أسبإ الزق الروي ولم أقل لأيسار صدق أظهروا ضوء ناريا
وقد يؤول قول امرىء القيس على الجواب الأول { فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ } قد تقدم بيانه { قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ } أي: على شجرة من أكل منها لم يمت {وملك لا يبلى} جديده ولا يفنى وهذا كقوله {ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر} الآية { فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ } هذا مفسر في سورة الأعراف { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } معناه: خالف آدم ما أمره ربه به فخاب من ثوابه والمعصية مخالفة الأمر سواء كان الأمر واجبا أوندبا قال الشاعر
((أمرتك أمرا جازما فعصيتني)). ولا يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب يقولون فلان أمرته بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ذلك واجبا ولا شبهة إن لفظة غوى يحتمل الخيبة قال الشاعر .
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائما(3)
ويجوز أن يكون معناه فخاب مما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من الخلود { ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ } أي: اصطفاه الله تعالى واختاره للرسالة { فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى } أي: قبل توبته وهداه إلى ذكره وقيل: هداه للكلمات التي تلقاها منه .
______________
1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي،ج7،ص59-63.
2- السبا:تجارة الخمر.
3- قائله:قعنب المزاري.ونسبه بعض الى المرقش.يريد:إن من ظفر بمطلوبه ،حمده الناس.ومن لم يظفر ،عابوه مع أنه لم يكن مقصراً.
{ وكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَويُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً }. أنزل سبحانه القرآن على عبده محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بلغة العرب ، وخوّف العباد بأساليب شتى من حسابه وعذابه ليتقوه ويطيعوه في جميع أحكامه ، أويتذكروه إذا أذنبوا فيتوبوا إليه ويسألوه العفووالصفح ، وأوهنا للإباحة ، مثلها في : كن عالما أوزاهدا ، لأن التقوى تجتمع مع التذكر كما يجتمع العلم والزهد ، وتقدم نظير هذه الآية في سورة يوسف الآية 2 ج 4 ص 286 ، وأجبنا هناك مفصلا عن سؤال السائل : لما ذا نزل القرآن بلغة العرب مع أن محمدا (صلى الله عليه واله وسلم) ما أرسل إلا للناس كافة .
أوصاف القرآن :
ذكر سبحانه في كتابه العزيز الكثير من أوصافه ، منها :
1 - العربي : كما في هذه الآية ، والآية 2 من سورة يوسف .
2 - الذكر : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ } - 9 الحجر . و{ ذِي الذِّكْرِ } { والْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ } - 2 ص .
3 - النور : { قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ } - 15 المائدة .
4 - القول الفصل : « إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ } - 13 الطارق .
5 - الهدى : { ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ } - 2 البقرة .
6 - الحكيم : { والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ } - 2 يس .
7 - المجيد : { والْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } - 2 ق .
8 - الروح :{ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ } - 15 غافر .
9 - الحق : { إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ } - 17 هود .
10 - النبأ العظيم : { قُلْ هُو نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ } - 68 ص .
11 - الشفاء : { قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وشِفاءٌ } - 44 فصلت .
12 - الرحمة : { وإِنَّهُ لَهُدىً ورَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } - 77 النمل .
13 - التنزيل : { تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ } - 80 الواقعة .
14 - البشير النذير : { كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيراً ونَذِيراً } - 4 فصلت .
15 - العزيز : { وإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ } - 41 فصلت .
16 - العظيم : { ولَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي والْقُرْآنَ الْعَظِيمَ } - 87 الحجر .
17 - المبين : { والْكِتابِ الْمُبِينِ } - 2 الزخرف .
وأولى الحقائق التي تدل عليها هذه الصفات ان اللَّه سبحانه انما أنزل القرآن على نبيه الكريم لهداية الناس وسعادتهم وأمنهم واستقرارهم .
{ فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ } . قال الإمام علي ( عليه السلام ) مناجيا ربه : سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك ! وما أصغر عظيمه في جنب قدرتك ! وما أهول ما نرى من ملكوتك ! وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك ! وما أسبغ نعمك في الدنيا ! وما أصغرها في نعم الآخرة ! .
{ ولا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ } . جاء في الحديث ان النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتابعه قراءة خوفا أن يفوته شيء منه ، فأمره تعالى ان يصغي ولا يتابع ، وان يطمئن ولا يخشى النسيان ، ويدل على صحة هذا الحديث الآية 17 من سورة القيامة : « لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وقُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ » .
زدني علما :
( وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ) . والعلم الذي أمر اللَّه نبيه أن يستزيده منه هو العلم الذي ينتفع به صاحبه ، وينفع به غيره . . فلا القيم والعقائد ، ولا الفلسفة والشرائع ولا الأدب والفن ، كل هذه ليست بشيء عند اللَّه إلا إذا كانت وسيلة لحياة طيبة كريمة لا مشاكل فيها ولا تعقيد ، حتى الحياة الآخرة ترتبط ، وتلتحم التحاما كليا بالعمل النافع في الحياة الدنيا ، قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله وسلم ) : خير الناس عند اللَّه أنفع الناس للناس ، وليس من شك ان أنفع الناس هو الذي يعمل من أجل حياة أفضل ، ومجتمع أرقى .
وكل شيء في هذا العصر يدل بوضوح على أنه لا حياة فاضلة للإنسان إلا بالعلم . . من غير فرق بين حياته المادية والاجتماعية والثقافية ، فكما ان المجتمع ، أي مجتمع ، لا يمكنه أن يحيا حياة طيبة بلا مطابع ولا مصانع تنتج الملابس ووسائل النقل والأدوات المنزلية وغيرها من الضرورات ، كذلك لا يمكنه أن يعيش حرا كريما بلا علم السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها من العلوم التي لها أثرها الفعال في القضاء على استغلال الإنسان للإنسان .
هذا هو العلم الصحيح ، وهو المقصود من كلمة العلم في قوله تعالى : « وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » ، وقول الرسول الأعظم : « من سلك طريقا إلى العلم سلك به طريقا إلى الجنة » . ومن فسر العلم بحفظ المتون والحواشي فهو من الذين يؤمنون بأن العلم ألفاظ وكلمات ، والدين تكبير وتسبيحات .
{ ولَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ولَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً } . والعهد الذي عهده اللَّه لآدم هوان لا يقرب من الشجرة المعهودة ، ولا يستجيب لدعوة إبليس ووسوسته ، والمراد بنسي خالف ، وبالعزم الثبات { وإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى }. تقدم في الآية 34 من سورة البقرة ج 1 ص 82 والآية 10 من سورة الأعراف و30 من سورة الحجر و61 من سورة الإسراء و51 من سورة الكهف .
{ فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُولَكَ ولِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها ولا تَعْرى وأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها ولا تَضْحى } أي لا تكدح في حر الشمس ، وخص الضحى بالذكر حيث يكون الحر فيه على أشده . . حذر سبحانه آدم من وسوسة إبليس ، وقال له : أنت بين أمرين : إما ان تطيعني وتعصي إبليس ، فجزاؤك عندي هذه الجنة ، وهي - كما رأيت - هناء وصفاء . .
لا جوع فيها ، ولا ظمأ ، ولا عري ، ولا مرض . . لا آلام وأحزان ، لا موت ودماء ودموع ، ولا كدح في حر ولا برد . . لا شيء إلا الأمن والأمان والراحة والجنان . واما ان تعصيني وتطيع إبليس ، فتخرج من الجنة إلى دنيا كلها متاعب ونوائب ، وطغيان وأسقام . . فنسي آدم هذا التحذير ، وتراكمت المحن والخطوب عليه وعلى نسله ، ابتداء من قتل قابيل هابيل إلى جرائم إسرائيل . . . إلى ما لا نهاية .
وغير بعيد ان يكون إخراج آدم من الجنة درسا وعظة لمن يتبع الأهواء والشهوات ، وان جزاءه عند اللَّه العذاب والشقاء . انظر ما قلناه بعنوان : ضعف الإرادة وسيلة للحرمان ج 1 ص 85 .
{ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ ومُلْكٍ لا يَبْلى فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ } . تقدم مثله في سورة الأعراف الآية 19 وما بعدها ج 3 ص 311 .
{ وعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى } . وتسأل : ان آدم نبي ، والنبي معصوم عن الخطأ والخطيئة ، فكيف نسب سبحانه إليه المعصية والغواية ؟ .
وأجابوا عن ذلك بأجوبة ، منها ان المراد بالمعصية هنا مخالفة الندب دون الوجوب ، وهذه المعصية لا تتنافى مع العصمة ، ومنها ان آدم حين كان في الجنة كان في الدار الآخرة ، وهذه الدار لا تبليغ فيها ولا تكليف كي تحتاج إلى أنبياء . . ونبوة آدم كانت في الدنيا ، لا في الجنة . . وعلى أية حال فان آدم تاب وطلب الصفح من ربه { ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وهَدى }. تكلمنا عن ذلك مفصلا بعنوان عصمة الأنبياء ج 1 ص 86 .
____________
1- التفسير الكاشف، ج 5، محمد جواد مغنية، ص247-250.
قوله تعالى:{ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا } ظاهر سياقها أن الإشارة بكذلك إلى خصوصيات بيان الآيات، و{قرآنا عربيا} حال من الضمير في{أنزلناه} والتصريف، هو التحويل من حال إلى حال، والمعنى وعلى ذلك النحومن البيان المعجز أنزلنا الكتاب والحال أنه قرآن مقروعربي وأتينا فيه ببعض ما أوعدناهم في صورة بعد صورة.
وقوله:{ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا} قد أورد فيما تقدم من قوله:{لعله يتذكر أويخشى} الذكر مقابلا للخشية ويستأنس منه أن المراد بالاتقاء هاهنا هو التحرز من المعاداة واللجاج الذي هو لازم الخشية باحتمال الضرر دون الاتقاء المترتب على الإيمان بإتيان الطاعات واجتناب المعاصي، ويكون المراد بإحداث الذكر لهم حصول التذكر فيهم وتتم المقابلة بين الذكر والتقوى من غير تكلف.
والمعنى - والله أعلم - لعلهم يتحرزون المعاداة مع الحق لحصول الخشية في قلوبهم باحتمال الخطر لاحتمال كونه حقا أويحدث لهم ذكرا للحق فيعتقدوا به.
قوله تعالى:{ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} تسبيح وتنزيه له عن كل ما لا يليق بساحة قدسه، وهو يقبل التفرع على إنزال القرآن وتصريف الوعيد فيه لهداية الناس والتفرع عليه وعلى ما ذكر قبله من حديث الحشر والجزاء وهذا هو الأنسب نظرا إلى انسلاك الجميع في سلك واحد وهو أنه تعالى ملك يتصرف في ملكه بهداية الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم ثم إحضارهم وجزائهم على ما عملوا من خير أوشر.
فتعالى الله الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا لا مانع من تصرفه ولا معقب لحكمه يرسل الرسل وينزل الكتب لهداية الناس وهو من شئون ملكه ثم يبعثهم بعد موتهم ويحضرهم فيجزيهم على ما عملوا وقد عنوا للحي القيوم وهذا أيضا من شئون ملكه فهو الملك في الأولى والآخرة وهو الحق الثابت على ما كان لا يزول عما هو عليه.
ويمكن أن يتفرع على جميع ما تقدم من قصة موسى وما فرع عليها إلى هنا ويكون بمنزلة ختم ذلك بالتسبيح والاستعظام.
قوله تعالى:{ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} السياق يشهد بأن في الكلام تعرضا لتلقي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحي القرآن، فضمير{وحيه} للقرآن، وقوله:{ولا تعجل بالقرآن} نهي عن العجل بقراءته، ومعنى قوله:{من قبل أن يقضى إليك وحيه} من قبل أن يتم وحيه من ملك الوحي.
فيفيد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان إذا جاءه الوحي بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحي فنهى عن أن يعجل في قراءته قبل انقضاء الوحي وتمامه فيكون الآية في معنى قوله تعالى في موضع آخر:{ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ:} القيامة: 18.
ويؤيد هذا المعنى قوله بعد:{وقل رب زدني علما} فإن سياق قوله: لا تعجل به وقل رب زدني، يفيد أن المراد هو الاستبدال أي بدل الاستعجال في قراءة ما لم ينزل بعد، طلبك زيادة العلم ويئول المعنى إلى أنك تعجل بقراءة ما لم ينزل بعد لأن عندك علما به في الجملة لكن لا تكتف به واطلب من الله علما جديدا بالصبر واستماع بقية الوحي.
وهذه الآية مما يؤيد ما ورد من الروايات أن للقرآن نزولا دفعة واحدة غير نزوله نجوما على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلولا علم ما منه بالقرآن قبل ذلك لم يكن لعجله بقراءة ما لم ينزل منه بعد معنى.
وقيل: المراد بالآية ولا تعجل بقراءة القرآن لأصحابك وإملائه عليهم من قبل أن يتبين لك معانيه، وأنت خبير بأن لفظ الآية لا تعلق له بهذا المعنى.
وقيل: المراد ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يقضي الله وحيه إليك، وهو كسابقه غير منطبق على لفظ الآية.
قصة دخول آدم وزوجه الجنة وخروجهما منها بوسوسة من الشيطان وقضائه تعالى عند ذلك بتشريع الدين وسعادة من اتبع الهدى وشقاء من أعرض عن ذكر الله.
وقد وردت القصة في هذه السورة بأوجز لفظ وأجمل بيان، وعمدة العناية فيها - كما يشهد به تفصيل ذيلها - متعلقة ببيان ما حكم به من تشريع الدين والجزاء بالثواب والعقاب، ويؤيده أيضا التفريع بعدها بقوله:{ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ} إلخ، نعم للقصة تعلق ما أيضا من جهة ذكرها توبة آدم بقوله فيما تقدم:{ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}.
والقصة - كما يظهر من سياقها في هذه السورة وغيرها مما ذكرت فيها كالبقرة والأعراف - تمثل حال الإنسان بحسب طبعه الأرضي المادي فقد خلقه الله سبحانه في أحسن تقويم وغمره في نعمه التي لا تحصى وأسكنه جنة الاعتدال ومنعه عن تعديه بالخروج إلى جانب الإسراف باتباع الهوى والتعلق بسراب الدنيا ونسيان جانب الرب تعالى بترك عهده إليه وعصيانه واتباع وسوسة الشيطان الذي يزين له الدنيا ويصور له ويخيل إليه أنه لو تعلق بها ونسي ربه اكتسب بذلك سلطانا على الأسباب الكونية يستخدمها ويستذل بها كل ما يتمناه من لذائذ الحياة وأنها باقية له وهو باق لها، حتى إذا تعلق بها ونسي مقام ربه ظهرت له سوآت الحياة ولاحت له مساوىء الشقاء بنزول النوازل وخيانة الدهر ونكول الأسباب وتولي الشيطان عنه فطفق يخصف عليه من ظواهر النعم يستدرك بموجود نعمة مفقود أخرى ويميل من عذاب إلى ما هو أشد منه ويعالج الداء المؤلم بآخر أكثر منه ألما حتى يؤمر بالخروج من جنة النعمة والكرامة إلى مهبط الشقاء والخيبة.
فهذه هي التي مثلت لآدم (عليه السلام) إذ أدخله الله الجنة وضرب له بالكرامة حتى آل أمره إلى ما آل إلا أن واقعته (عليه السلام) كانت قبل تشريع أصل الدين وجنته جنة برزخية ممثلة في عيشة غير دنيوية فكان النهي لذلك إرشاديا لا مولويا ومخالفته مؤدية إلى أمر قهري ليس بجزاء تشريعي كما تقدم تفصيله في تفسير سورتي البقرة والأعراف.
قوله تعالى:{ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} المراد بالعهد الوصية وبهذا المعنى يطلق على الفرامين والدساتير العهود، والنسيان معروف وربما يكنى به عن الترك لأنه لازمه إذ الشيء إذا نسي ترك، والعزم القصد الجازم إلى الشيء قال تعالى:{ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ:} آل عمران: 159 وربما أطلق على الصبر ولعله لكون الصبر أمرا شاقا على النفوس فيحتاج إلى قصد أرسخ وأثبت فسمي الصبر باسم لازمه قال تعالى:{ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}.
فالمعنى وأقسم لقد وصينا آدم من قبل فترك الوصية ولم نجد له قصدا جازما إلى حفظها أوصبرا عليها والعهد المذكور - على ما يظهر من قصته (عليه السلام) في مواضع من كلامه تعالى – هو النهي عن أكل الشجرة، بمثل قوله:{لا تقربا هذه الشجرة:} الأعراف: 19.
قوله تعالى:{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى} معطوف على مقدر والتقدير اذكر عهدنا إليه واذكر وقتا أمرنا الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس حتى يظهر أنه نسي ولم يعزم على حفظ الوصية، وقوله:{أبى} جواب سؤال مقدر تقديره ما ذا فعل إبليس؟ فقيل: أبى.
قوله تعالى:{ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} تفريع على إباء إبليس عن السجدة أي فلما أبى قلنا إرشادا لآدم إلى ما فيه صلاح أمره ونصحا: إن هذا الآبي عن السجدة - إبليس - عدولك ولزوجك إلخ.
وقوله:{فلا يخرجنكما من الجنة} توجيه نهي إبليس عن إخراجهما من الجنة إلى آدم كناية عن نهيه عن طاعته أوعن الغفلة عن كيده والاستهانة بمكره أي لا تطعه أولا تغفل عن كيده وتسويله حتى يتسلط عليكما ويقوى على إخراجكما من الجنة وإشقائكما.
وقد ذكر الإمام الرازي في تفسيره وجوها لسبب عداوة إبليس لآدم وزوجه وهي وجوه سخيفة لا فائدة في الإطناب بنقلها، والحق أن السبب فيها هو طرده من حضرة القرب ورجمه وجعل اللعن عليه إلى يوم القيامة كما يظهر من قوله لعنه الله على ما حكاه الله:{ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: الحجر: 39.
وقوله:{ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا:} الإسراء: 62، ومعلوم أن تكريم آدم عليه هو تكريم نوع الإنسان عليه كما أن أمره بالسجدة له كان أمرا بالسجدة لنوع الإنسان فأصل السبب هو تقدم الإنسان وتأخر الشيطان ثم الطرد واللعن.
وقوله:{فتشقى} تفريع على خروجهما من الجنة والمراد بالشقاء التعب أي فتتعب إن خرجتما من الجنة وعشتما في غيرها وهو الأرض عيشة أرضية لتهاجم الحوائج وسعيك في رفعها كالحاجة إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن وغيرها.
والدليل على أن المراد بالشقاء التعب الآيتان التاليتان المشيرتان إلى تفسيره:{ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}.
وهو أيضا دليل على أن النهي إرشادي ليس في مخالفته إلا الوقوع في المفسدة المترتبة على نفس الفعل وهو تعب السعي في رفع حوائج الحياة واكتساب ما يعاش به وليس بمولوي تكون نفس مخالفته مفسدة يقع فيها العبد وتستتبع مؤاخذة أخروية.
على أنك عرفت أنه عهد قبل تشريع أصل الدين الواقع عند الأمر بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض.
وأما إفراد قوله:{فتشقى} ولم يقل فتشقيا بصيغة التثنية فلأن العهد إنما نزل على آدم (عليه السلام) وكان التكليم متوجها إليه، ولذلك جيء بصيغة الإفراد في جميع ما يرجع إليه كقوله:{فنسي ولم نجد له عزما}{فتشقى}{ألا تجوع فيها ولا تعرى}{لا تظمؤا فيها ولا تضحى}{فوسوس إليه} إلخ{وعصى} إلخ{ثم اجتباه ربه فتاب عليه} نعم جيء بلفظ التثنية فيما لا غنى عنه كقوله:{عدولك ولزوجك فلا يخرجنكما}{فأكلا منها فبدت لهما}{وطفقا يخصفان عليهما}{ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} فتدبر وقيل إن إفراد:{تشقى} من جهة أن نفقة المرأة على المرء ولذا نسب الشقاء وهو التعب في اكتساب المعاش إلى آدم وفيه.
أن الآيتين التاليتين لا تلائمان ذلك ولوكان كما قال لقيل: إن لكما أن لا تجوعا إلخ، وقيل: إن الإفراد لرعاية الفواصل وهو كما ترى.
قوله تعالى:{ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} يقال: ضحى يضحى كسعى يسعى ضحوا وضحيا إذا أصابته الشمس أوبرز لها وكأن المراد بعدم الضحوأن ليس هناك أثر من حرارة الشمس حتى تمس الحاجة إلى الاكتنان في مسكن يقي من الحر والبرد.
وقد رتبت الأمور الأربعة على نحواللف والنشر المرتب لرعاية الفواصل والأصل في الترتيب أن لا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى.
قوله تعالى:{ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} الشيطان هو الشرير لقب به إبليس لشرارته، والمراد بشجرة الخلد الشجرة المنهية والبلى صيرورة الشيء خلقا خلاف الجديد.
والمراد بشجرة الخلد شجرة يعطي أكلها خلود الحياة، والمراد بملك لا يبلى سلطنة لا تتأثر عن مرور الدهور واصطكاك المزاحمات والموانع فيئول المعنى إلى نحوقولنا هل أدلك على شجرة ترزق بأكل ثمرتها حياة خالدة وملكا دائما فليس قوله:{لا يبلى} تكرارا لإفادة التأكيد كما قيل.
والدليل على ما ذكره ما في سورة الأعراف في هذا المعنى من قوله:{ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ:} الأعراف: 20} ولا منافاة بين جمع خلود الحياة ودوام الملك هاهنا بواو الجمع وبين الترديد بينهما في سورة الأعراف لإمكان أن يكون الترديد هناك لمنع الخلو لا لمنع الجمع، أويكون الجمع هاهنا باعتبار الاتصاف بهما جميعا والترديد هناك باعتبار تعلق النهي كأنه قيل: إن في هذه الشجرة صفتين وإنما نهاكما ربكما عنها إما لهذه، أولهذه أوإنما نهاكما ربكما عنها أن لا تخلدا في الجنة مع ملك خالد أوأن لا تخلدا بناء على أن الملك الخالد يستلزم حياة خالدة فافهم ذلك وكيف كان فلا منافاة بين الترديد في آية والجمع في أخرى.
قوله تعالى:{ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} تقدم تفسيره في سورة الأعراف.
قوله تعالى:{وعصى آدم ربه فغوى} الغي خلاف الرشد الذي هو بمعنى إصابة الواقع وهو غير الضلال الذي هو الخروج من الطريق، والهدى يقابلهما ويكون بمعنى الإرشاد إذا قابل الغي كما في الآية التالية وبمعنى إراءة الطريق، أوالإيصال إلى المطلوب بتركيب الطريق إذا قابل الضلال فليس من المرضي تفسير الغي في الآية بمعنى الضلال.
ومعصية آدم - ربه كما أشرنا إليه آنفا وقد تقدم تفصيله - إنما هي معصية أمر إرشادي لا مولوي والأنبياء (عليهم السلام) معصومون من المعصية والمخالفة في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحى إليهم من جهة تلقيه فلا يخطئون، ومن جهة حفظه فلا ينسون ولا يحرفون، ومن جهة إلقائه إلى الناس وتبليغه لهم قولا فلا يقولون إلا الحق الذي أوحي إليهم وفعلا فلا يخالف فعلهم قولهم ولا يقترفون معصية صغيرة ولا كبيرة لأن في الفعل تبليغا كالقول، وأما المعصية بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي الذي لا داعي فيه إلا إحراز المأمور خيرا أومنفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق الأصلح كما يأمر وينهى المشير الناصح نصحا فإطاعته ومعصيته خارجتان من مجرى أدلة العصمة وهو ظاهر.
وليكن هذا معنى قول القائل إن الأنبياء (عليهم السلام) على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولى ومنه أكل آدم (عليه السلام) من الشجرة والآية من معارك الآراء وقد اختلفت فيها التفاسير على حسب اختلاف مذاهبهم في عصمة الأنبياء وكل يجر النار إلى قرصته.
قوله تعالى:{ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى } الاجتباء - كما تقدم مرارا - بمعنى الجمع على طريق الاصطفاء ففيه جمعه تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فيه أحد وجعله من المخلصين بفتح اللام، وعلى هذا المعنى يتفرع عليه قوله:{فتاب عليه وهدى}، كأنه كان ذا أجزاء متفرقة متشتتة فجمعها من هنا وهناك إلى مكان واحد ثم تاب عليه ورجع إليه وهداه وسلك به إلى نفسه.
وإنما فسرنا قوله:{هدى} وهو مطلق بهدايته إلى نفسه بقرينة الاجتباء، ولا ينافي مع ذلك إطلاق الهداية لأن الهداية إليه تعالى أصل كل هداية ومحتدها، نعم يجب تقييد الهداية بما يكون في أمر الدين من اعتقاد حق وعمل صالح، والدليل عليه تفريع الهداية في الآية على الاجتباء، فافهم ذلك.
وعلى هذا فلا يرد على ما قدمنا أن ظاهر وقوع هذه الهداية بعد ذكر تلك الغواية أن يكون نوع تلك الغواية مرفوعا عنه وإذ كانت غواية في أمر إرشادي فالآية تدل على إعطاء العصمة له في موارد الأمر المولوية والإرشادية جميعا وصونه عن الخطإ في أمر الدين والدنيا معا.
ووجه عدم الورود أن ظاهر تفرع الهداية على الاجتباء كونه مهديا إلى ما كان الاجتباء له والاجتباء إنما يتعلق بما فيه السعادة الدينية وهو قصر العبودية في الله سبحانه فالهداية أيضا متعلقة بذلك وهي الهداية التي لا واسطة فيها بينه تعالى وبين العبد المهدي ولا تتخلف أصلا كما قال:{ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ:} النحل: 37، والهداية إلى منافع الحياة أيضا وإن كانت راجعة إليه تعالى لكنها مما تتخلل الأسباب فيها بينها وبينه تعالى والأسباب ربما تخلفت، فافهم ذلك.
_____________
1- تفسير الميزان ،الطباطبائي،ج14،ص173-181.
قل: (ربّ زدني علماً)
الآيات محلّ البحث ـ في الواقع ـ إشارة إلى مجموع ما مرّ في الآيات السابقة حول المسائل التربوية المرتبطة بالقيامة والوعد والوعيد، فتقول: { وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا}.
التعبير بـ (كذلك) إشارة إلى المطالب التي بيّنت قبل هذه الآية، وهذا يشبه تماماً أن يذكر إنسان لآخر اُموراً من شأنها التوعية والعبرة، ثمّ يضيف: هكذا ينبغي التذكير والوعظ، وعلى هذا فلا حاجة إلى التفاسير التي ذكرت والبعيدة هنا عن معنى الآية).
كلمة «عربي» وإن كانت بمعنى اللغة العربية، إلاّ أنّها هنا إشارة إلى فصاحة القرآن وبلاغته وسرعة إيصاله للمفهوم والمراد من جهتين:
الأُولى: إنّ اللغة العربية ـ بشهادة علماء اللغة في العالم ـ واحدة من أبلغ لغات العالم، وأدبها من أقوى الآداب.
والثّانية: إنّ جملة (صرفنا) أحياناً تشير إلى التعبيرات القرآنية المختلفة حول حادثة واحدة، فمثلا نراه يبيّن مسألة الوعيد وعقاب المجرمين من خلال ذكر قصص الاُمم السابقة وحوادثها تارةً، وتارةً أُخرى على هيئة خطاب موجّه للحاضرين، وثالثة بتجسيد حالهم في مشهد القيامة، وهكذا.
إنّ إختلاف جملة (لعلّهم يتّقون) مع جملة (يحدث لهم ذكراً) قد يكون من جهة أنّ الجملة الأُولى تقول: إنّ الهدف هو إيجاد وغرس التقوى بصورة كاملة. وفي الجملة الثّانية: إنّ الهدف هو أنّ التقوى وإن لم تحصل كاملة، فليحصل على الأقل الوعي والعلم فعلا، ثمّ تكون في المستقبل مصدراً وينبوعاً للحركة نحو الكمال.
ويحتمل أيضاً أن تكون الجملة الأُولى إشارة إلى إيجاد وتحقيق التقوى بالنسبة لغير المتّقين، والثّانية إلى التذكّر والتذكير بالنسبة للمتقين، كما نقرأ في الآية (2) من سورة الأنفال: { وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}.
في الآية آنفة الذكر إشارة إلى أصلين مهمّين من اُصول التعليم والتربية المؤثّرة:
أحدهما: مسألة الصراحة في البيان، وكون العبارات بليغة واضحة تستقرّ في القلب.
والآخر: بيان المطالب بأساليب متنوعة، لئلاّ تكون سبباً للتكرار والملل، ولتنفذ إلى القلوب.
أمّا الآية التّالية فتضيف قائلة: { فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} ومن المحتمل أن يكون ذكر كلمة «الحقّ» بعد كلمة «المَلِك»، هو أنّ الناس ينظرون إلى الملك بمنظار سيء وتتداعى في أذهانهم صور الظلم والطغيان والجور والإستعلاء والتجبّر التي تكون في الملوك غالباً، ولذا فإنّ الآية تصف الله الملك سبحانه مباشرةً بـ «الحقّ».
وبما أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعجّل في إبلاغ الوحي وما ينزل به من القرآن لإهتمامه به وتعشّقه أن يحفظه المسلمون ويستظهروه، ولم يتمهّل أن يتمّ جبرئيل ما يلقيه عليه من الوحي فيبلغه عنه، فإنّ الآية محلّ البحث تذكّره بأنّ يتمهّل فتقول: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}.
ويستشفّ من بعض آيات القرآن الاُخرى أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تنتابه حالة نفسيّة خاصّة من الشوق عند نزول الوحي، فكانت سبباً في تعجّله كما في قوله تعالى: { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ }( سورة القيامة، الآية 15 ـ 16 ـ 17.)
آدم ومكر الشّيطان:
كان القسم الأهمّ من هذه السورة في بيان قصّة موسى (عليه السلام) وبني إسرائيل، والمواجهة بينهم وبين فرعون وأنصاره، إلاّ أنّ هذه الآيات وما بعدها تتحدّث عن
قصّة آدم وحواء، وعداء ومحاربة إبليس لهما. وربّما كانت إشارة إلى أنّ الصراع بين الحقّ والباطل لا ينحصر بأمس واليوم، وموسى (عليه السلام) وفرعون، بل كان منذ بداية خلق آدم وسيستمر كذلك.
وبالرغم من أنّ قصّة آدم وإبليس قد وردت مراراً في القرآن، إلاّ أنّها تمتزج في كلّ مورد بملاحظات ومسائل جديدة، وهنا تتحدّث أوّلا عن عهد الله إلى آدم فتقول: { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا }.
هناك عدّة آراء في ماهيّة العهد المذكور، فقال البعض: إنّه أمر الله بعدم الإقتراب من الشجرة الممنوعة، وهناك روايات متعدّدة تؤيّد هذا المعنى. في حين أنّ بعض المفسّرين إحتملوا إحتمالات أُخرى يمكن إعتبارها بمثابة الأغصان والأوراق لهذا المعنى، كإخطار الله لآدم بأنّ الشيطان عدوّ مبين له، ويجب أن لا يتبعه.
وأمّا «النسيان» هنا فمن المسلم أنّه ليس بالمعنى المطلق، لأنّه لا معنى للعتاب والملامة في النسيان المطلق، بل إنّه إمّا بمعنى الترك كما نستعمل ذلك في مكالماتنا اليوميّة، فقد نقول لمن لم يف بعهده: أنسيت عهدك؟ أي إنّك كالناسي. أو أنّه بمعنى النسيان الذي يطرأ نتيجة قلّة الإنتباه وشرود الذهن.
والمراد من «العزم» هنا هو التصميم والإرادة القويّة الصلبة التي تحفظ الإنسان من الوقوع تحت تأثير وساوس الشيطان القويّة.
وعلى كلّ حال، فلا شكّ أنّ آدم لم يرتكب معصية، بل بدر منه ترك الأُولى، أو بتعبير آخر، فإنّ مرحلة وجود آدم في الجنّة لم تكن مرحلة تكليف، بل كانت مرحلة تجريبيّة للإستعداد للحياة في هذه الدنيا وتقبل المسؤولية، خاصةً وإن نهي الله هنا كان نهياً إرشادياً، لأنّه قد أخبره بأنّه إن أكل من الشجرة الممنوعة فسيبتلى بالشقاء. وقد أوردنا تفصيل كلّ ذلك، وكذلك المراد من الشجرة الممنوعة وأمثال ذلك في ذيل الآيات 19 ـ 22 من سورة الأعراف.
ثمّ أشارت إلى جانب آخر من هذه القصّة، فقالت: { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى} ومن هنا يتّضح مقام آدم العظيم، آدم الذي سجدت له الملائكة، وأبدت هذه المخلوقات العظيمة إحترامها إيّاه. كما أنّ عداوة إبليس تجلّت له ضمناً من أوّل الأمر إذ لم يخضع لآدم ولم يعظمه.
لا شكّ أنّ السجدة لا تعني السجدة الخاصّة بعبادة الله، ولا أحد أو موجود يستحقّ أن يكون معبوداً من دون الله سبحانه، وبناءً على هذا فإنّ هذه السجدة كانت لله، غاية ما هناك أنّها كانت من أجل خلق هذا الموجود العظيم. أو أنّ السجدة هنا تعني الخضوع والتواضع.
على كلّ حال، فإنّ الله سبحانه تعالى أنذر آدم بقوله { فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى }.
من الواضح أنّ الجنّة هنا لا يراد منها جنّة الخلود في العالم الآخر، والتي هي نقطة تكامل لا يمكن الخروج منها أو التراجع عن نعيمها، بل كانت بستاناً فيه كلّ شيء ممّا في بساتين هذه الدنيا، ولم يكن فيها نصب ولا غصّة بلطف الله، ولذلك فإنّ الله سبحانه قد أنذر آدم بأنّك إن خرجت من هذا النعيم فإنّك ستشقى. وكلمة «تشقى» من مادّة الشقاء، وأحد معانيها الألم والمشقّة.
سؤال: لماذا خاطب الله الإثنين معاً ـ أي آدم وحواء ـ في بداية الأمر فقال: {فلا يخرجنكما} إلاّ أنّه ذكر نتيجة الخروج بصيغة المفرد في شأن آدم فقط فقال: (فتشقى)؟
والجواب هو: إنّ هذا الإختلاف في التعبير قد يكون إشارة إلى أنّ الآلام والأتعاب كانت تصيب آدم في الدرجة الأُولى، فإنّه كان مأموراً بتحمّل مسؤوليات زوجته أيضاً، وهكذا كانت مسؤولية الرجال من بداية الأمر. أو أنّ العهد لما كان من البداية على عاتق آدم، فإنّ النهاية أيضاً ترتبط به.
ثمّ يبيّن الله لآدم راحة الجنّة وهدوءها، وألم ومشقّة الخروج منها، فيقول: { إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}.(2)
وهنا سؤال يوجّه للمفسّرين، وهو: لماذا إقترن ذكر الظمأ بضحى الشمس، والجوع بالعري، في حين أنّ المعتاد ذكر العطش مع الجوع؟
قيل في الجواب: إنّ بين العطش وأشعّة الشمس علاقة لا يمكن إنكارها. («تضحى» من مادّة «ضحى» أي إشراق الشمس من دون أن يحجبها حاجب من سحاب وأمثاله).
وأمّا الجمع بين الجوع والعري فقد يكون بسبب أنّ الجوع نوع من عراء الجوف وخلوّه من الغذاء! والأفضل أن يقال: إنّ هذين الوصفين ـ الجوع والعري ـ علامتان واضحتان للفقر تأتيان معاً عادةً.
وعلى كلّ حال، فقد اُشير في هاتين الآيتين إلى أربع إحتياجات أصلية وإبتدائية للإنسان، أي: الحاجة إلى الغذاء، والماء، واللباس ـ للحماية من حرارة الشمس ـ والمسكن، وكان تأمين هذه الحاجات نتيجة توفّر النعمة، وذكر هذه الاُمور في الواقع توضيح لما جاء في جملة «فتشقى».
لكن، ومع كلّ ذلك، فإنّ الشيطان قد ربط رباط العداوة حول آدم، ولهذا لم يهدأ له بال: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى}.
«الوسوسة» في الأصل تعني الصوت المنخفض جدّاً، ثمّ قيلت لخطور الأفكار السافلة والخواطر السيّئة سواء كانت تنبع من داخل الإنسان، أو من خارجة.
إنّ الشيطان تتبّع رغبة آدم وأنّها في أي شيء، فوجد أنّ رغبته في الحياة الخالدة والوصول إلى القدرة الأزليّة، ولذلك جاء إليه عن هذين العاملين وإستغلّهما في سبيل جرّه إلى مخالفة أمر الله. وبتعبير آخر: فكما أنّ الله قد وعد آدم بأنّك إن تجنّبت الشيطان وخالفته فستحظى بالتنّعم في الجنّة دائماً، فإنّ الشيطان قد وسوس إليه عن هذا الطريق «أي أنّه سيخلد في الجنّة أيضاً».
أجل .. إنّ الشياطين يبدؤون دائماً في بادية خططهم من نفس النقاط والطرق التي يبدأ منها المرشدون إلى طريق الحقّ، لكن لا تمرّ الأيّام حتّى يجروهم إلى هاوية الإنحراف، ويجعلون جاذبية طريق الحقّ وسيلة للوصول إلى المتاهات.
وأخيراً وقع المحذور، وأكل آدم وحواء من الشجرة الممنوعة، فتساقط عنهما لباس الجنّة، فبدت أعضاؤهما: { فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا}(3) فلمّا رأى آدم وحواء ذلك إستحييا { وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ}(4). نعم، لقد كانت العاقبة المؤسفة { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى}.
«غوى» أُخذت من مادّة الغي، أي العمل الصبياني الناشىء من إعتقاد خاطىء، ولمّا كان آدم هنا قد أكل ـ جهلا وإشتباهاً ـ من الشجرة المحرّمة، نتيجة للظنّ الذي حصل له من قول الشيطان، فقد عُبّر عن عمله بـ(غوى).
وفسّره بعض المفسّرين بأنّه الجهل الناشىء عن الغفلة، والبعض فسّرها بالمحرومية، والبعض الآخر بالفساد في الحياة.
وعلى كلّ حال فإنّ «الغي» يقابل «الرشد»، والرشد هو أن يسلك الإنسان طريقاً يوصله إلى هدفه ومقصده، أمّا الغي فهو عدم الوصول إلى المقصود.
ولكن لمّا كان آدم نقيّاً ومؤمناً في ذاته، وكان يسير في طريق رضى الله سبحانه، وكان لهذا الخطأ الذي أحاط به نتيجة وسوسة الشيطان صفة إستثنائية، فإنّ الله سبحانه لم يبعده عن رحمته إلى الأبد، بل { ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى }.
________________
1- تفسير الامثل،ناصر مكارم الشيرازي،ج8،ص201-208.
2- (تضحى) من مادة (ضحى) بمعنى شروق الشمس دون أن يحجبها الغمام وأمثاله.
3ـ «سوءات» جمع سوءة، وهي في الأصل كلّ شيء غير سار ويسيء الإنسان، ولذلك تطلق أحياناً على جسد الميّت، وأحياناً على العورة، والمراد هنا هو المعنى الأخير.
4ـ «يخصفان» من مادّة خصف، وهي هنا تعني خياطة اللباس.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|