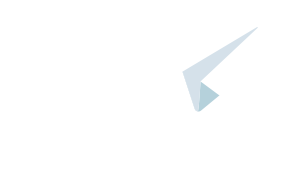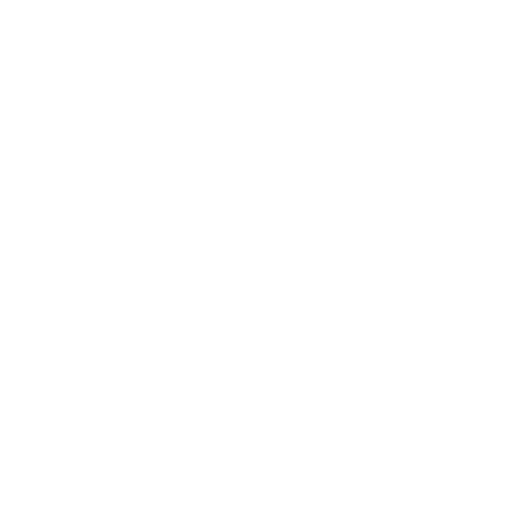الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
التزكية
المؤلف:
السيد عبد الاعلى السبزواري
المصدر:
الاخلاق في القران الكريم
الجزء والصفحة:
61- 71
29-4-2021
3627
{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 150، 151].
أصل الزكاة : هو النمو الحاصل من بركة الله تعالى ، سواء أكان في الأمور الدنيوية ، أم الأخروية ، أم هما معاً.
وقد استعملت في القرآن الكريم بأنحاء شتى ... فتارة : تضاف إلى الله عز وجل ، قال تعالى : { بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ } [النساء : 49].
وأخرى : إلى نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) ؛ كما في المقام.
وثالثة : الى ذات الفاعل ، قال تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } [الشمس : 9، 10].
وهذا هو شأن جمع الصفات ذات الإضافة.
والتزكية : هي الطهارة والتقديس عن الأدناس والأرجاس الظاهرية ،أو الرذائل المعنوية ، سواء كانتا بالنسبة إلى النفس ، كما في بعض النفوس السعيدة مما يفيض عليها الله تعالى على نحو الاقتضاء كما قال تعالى : {غُلَامًا زَكِيًّا} [مريم : 19] ، أو بالنسبة إلى الأعمال والأفعال.
والرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) هو المثل الأعلى في التزكية بجميع مراتبها ، والقدوة الحسنة في الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة، لا يدانيه أحد ولا يجاريه فرد، ولقد جاهد في تزكية أمته بدينه وتعاليمه وتشريعاته ، وبنفسه الشريفة ، قال تعالى : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب : 21]. وتطهيرهم من رذائل الأخلاق وسوء الاعتقاد، فإن بالتزكية يتخلى الإنسان عن الرذائل والخبائث ، ويتحلى بالفضائل ، فهي التربية العملية التي لها الأثر العظيم في مطلق التربية والتعليم .
وترتب التزكية على التلاوة من قبيل ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر)، وقد يكون من قبيل ترتب المطول على العلة التامة ، كما في بعض النفوس المستعدة .
ثم إنه تعالى قدم التزكية على التعليم في هذه الآية الشريفة ، وأخرها عنه في دعاء إبراهيم (عليه السلام) ، قال تعالى : {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة : 129].
ولعل الوجه في ذلك أن للتزكية مراتب كثيرة ، منها الإرشاد المحض وإتمام الحجة، ومنها التخلي عن الرذائل، ومنها التحلي بالفضائل، ومنها التجلي بمظاهر الأسماء والصفات الربوبية ، ولكل واحدة منها درجات ، فيحمل ما قدمت فيها التزكية على بعض المراتب ؛ وما أخرت فيها على البعض الآخر.
قال تعالى : {وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ } [البقرة : 151].
لأن بالتعليم يرتقي الإنسان من أدنى درجات البهيمية إلى أقصى درجات الإنسانية ، فقد كان الرسول (صلى الله عليه واله) المعلم الهادي لأمته ، يبين لهم ما انطوت عليه شريعته ، وما اشتمل عليه كتابه الكريم من الأسرار والمعارف الربوبية.
قال تعالى : { والحكمة }.(تقدم معنى الحكمة في الآية 32 من هذه السورة).
فإن قلنا بمقالة الفلاسفة من أن الحكمة ..
تارة : علمية ، وهي : العلم بحقائق الموجودات بقدر الطاقة البشرية.
وأخرى : عملية وهي صيرورة الإنسان أكبر حجة لله تعالى في خلقه ، فإن عظمة مقامها معلومة لكل أحد.
وإن قلنا بما يستفاد من الكتاب والسنة المقدسة - وهي متابعة الشريعة أصولا وفروعاً، ومعرفة حجة الله على الخلق - فالأمر أظهر وأبين ، وسيأتي شرح الحكمة في قوله تعالى : {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا } [البقرة : 269].
قال تعالى : {وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } [البقرة : 151] .
بفهم أسرار الكتاب العظيم ، وأخبار الأمم الماضين ، والعلوم التي تهمكم وتزيد في علومكم ، وتكون سبباً في تهذيب نفوسكم ، مما لم تكونوا تعلمونه سابقاً .
وهذه الآية على اختصارها تحتوي على أصول التربية والتعليم بالترتيب الذي أراده القرآن العظيم ، ابتداء بالتلاوة والتذكر بآيات الله تعالى ، ثم تزكية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل ، لتستعد لإفاضة العلوم عليها ، ثم التعليم ، ثم معرفة الأشياء بحقائقها ، والعمل بما عرفه ، كل ذلك من طريق الشرع المبين.
وعليه ترجع التلاوة والحكمة إلى الكتاب الذي هو القرآن العظيم ، فإنهما وإن اختلفتا في المؤدى ، ولكنهما متحدتان مصداقاً ، لكن الكتاب يظهر بأطوار مختلفة.
قال تعالى : {واذكروني}.
الذكر .. تارة : يطلق ويراد به التوجه والالتفات الفعلي ، وهو عبارة أخرى عن الحفظ ، والفرق بينهما بالاعتبار ، فإن الثاني يقال له باعتبار ذاته، والأول يقال له باعتبار التوجه الفعلي إلى الشيء ، ولو لوحظ ذات الحضور من حيث هو فهما سواء من هذه الناحية .
وقد يطلق أخرى : ويراد به إظهار الشيء باللسان ، أو القلب أو الجوارح ، فمن الأول آيات كثيرة منها قال تعالى : { هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي} [الأنبياء : 24].
ومن الثاني قوله تعالى : { فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة : 200] ، فإنه عام لذكر القلب واللسان.
ومن الأخير قوله تعالى : {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [طه : 14] ، حيث إن الصلاة ذكر الله تعالى بالجوارح أيضا.
بل يطلق الذكر على نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) الذي هو الفرد الأكمل والمرآة الأتم لصفات الجلال والجمال ، قال تعالى : {قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ} [الطلاق : 10، 11] ، بناء على لفظ " رسولا " من لفظ " ذكراً " ، كما أطلقت ، " الكلمة " على عيسى بن مريم (عليه السلام) ، قال تعالى : {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ} [النساء : 171].
وقد يكون بمعنى الشرف وعلو المنزلة، قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ} [الزخرف : 44] ، وقال تعالى : {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح : 4].
والذكرى كثرة الذكر وأبلغ منه ، قال تعالى : {رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [ص : 43] ، وذلك تعالى : { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات : 55].
والمراد به في المقام هو الالتفات الفعلي إليه تعالى ، قلباً ونولا وعملا ، عكس قوله تعالى : {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ } [الحشر : 19].
والالتفات إليه تعالى يتحقق بتذكر نعمه تعالى ، وإدمان الشكر عليها، والطاعة والعبادة له، وإتيان ما اختاره الله تعالى، مما فيه العادة في الدارين ، فإن الالتفات إليه عز وجل كذلك مبدأ العبودية المحضة المنتهية إلى الكمال المطلق ، لما ثبت في الفلسفة العملية من : أن آخر مقام الفناء في مرضاته تعالى ، أزل مقام البقاء به عز وجل ، وأن أخريات درجات التحلي ، مبشرات لأوليات مقامات التجلي.
وذلك لأن أنس النفس بالكامل بالذات والكمال المطلق ، والخير المحض العام ، والفيض الأقدس التام ، يوجب ترقي النفس وتعاليها عن حضيض البهيمية حينئذ إلى أوج الكمالات الحقيقية ، وكلما ازداد الأنس ازداد الارتقاء ، وأساس هذا الأنس يدور مدار الالتفات الفعلي إليه عز وجل ، كما يريده تعالى ، وهو المعبر عنه بــ (الذكر) في الكتاب والسنة الشريفة ، وبعبارات مختلفة أخرى ، كالتوجه ، والتقرب ، والتولية وغيرها.
والمناط كله أمران :
الأول : الالتفات الفعلي إلى الله تبارك وتعالى، المعبر عنه في الفقه بـ (القربة) ، كما يعبر عنه علماء الأخلاق بــ (الحضور، والتوجه)، ونحو ذلك.
الثاني : كون ما يذكر به الله عز وجل مأذوناً فيه من قبله تعالى ، فقد ورد الإذن فيه في الشريعة المقدسة بشرائطه المعينة، التي لا بد من مراعاتها، كما فضلها الفقهاء، فكن ما يكون مرضياً لله تعالى، ويؤتى به لوجهه عز وجل ، فهو ذكر الله تعالى ، سواء أكان من العقائد أم الأخلاق الحسنة ، أم العبادات والمعاملات أم غير ذلك ، فان ذكره تعالى - كرحمته - وسع كل شيء إذا لوحظ فيه التوجه إليه ، وقد جعله تعالى بهذه التوسعة تمهيلا لوصول عباده إليه عز وجل ، وما ورد في الفلسفة العملية من : " أن الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق" ، فيه إشارة إلى ما ذكرناه ، فكما لا حد للمذكور ، كذلك لا حد لمراتب الذكر :
فإن الذكر اللفظي ، كالتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والشكر لنعمائه.
والذكر العملي هو العبادة ، والطاعة، والأفعال المرضية له تعالى ، كعيادة المرضى ، وتشييع الموتى ، والسعي في قضاء حوائج الإخوان.
والذكر القلبي هو التوجه والخلوص والتقرب إليه تعالى.
وكلما ازدادت عبودية العبد لربه ازداد مقام توجهه إليه ؛ ولذا ورد عن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " لي مع الله حالات لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل" .
وفيه إشارة إلى بعض توجهاته الخاصة إلى مقامات ربه ، أو قوله (صلى الله عليه واله) : " إني أبيت عند ربي ، فيطعمني ويسقيني ربي ".
ثم إن ترتيب قوله تعالى : { فاذكروني} على الآيات السابقة ، ترتيب عقلي واجب من باب وجوب شكر المنعم ، الذي يحكم به العقل المستقل .
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أمور :
الأول : أن الذكر منبث على القلب واللسان والجوارح ، ولا يختص بخصوص الذكر اللفظي ، بل كان ما كان مضافاً إليه عز وجل، وكان مأذوناً فيه من قبله تعالى، وتقابله المعصية فإنها لا تصدر إلا مع الغفلة عنه عز وجل.
الثاني : أن حقيقته هو التوجه الفعلي إليه عز وجل ، أي العلم الفعلي بأصل العلم ، لا مجرد العلم فقط ، ولذلك مراتب كثيرة، منها ما ذكره بعضهم : " أن ينسى العبد ما سرى الله تعالى ، ويكون مقصوده من جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله - بل وخطرات قلبه - هو الله تعالى" .
الثالث : أن أمره بالذكر شامل لجميع المراتب، ولا يختص بخصوص بعضها.
الرابع : أن ما يقترفه الناس في كيفية ذكره تعالى لا أصل له إلا إذا ورد من الشرع المقدس الإذن فيه، فقد ورد في الأحاديث في ما يتعلق بالذكر - كمية وكيفية ، زماناً ومكاناً - ما يشفي العليل ويروي الغليل ، وقد وضع الأعلام فيه كتباً ورسائل .
الخامس : أقسام الذكر ستة ..
فتارة : يتعلق بالنعم الطبيعية ، قال تعالى : {أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا} [مريم : 67].
وأخرى : يتعلق بالنعم العارضة التي أفاضها الله سبحانه على الاسنان ، قال تعالى : {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج : 34].
وثالثة : يكون محبوباً بذاته على كل حال ، ومجرداً عن الإضافة ، قاًل تعالى : { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الشعراء : 227].
ورابعة : يكون عند اهتمام النفس بشيء غير مرضي له تعالى ، فيذكر الله ويرتدع عنه ، قال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف : 201] ، وقال تعالى : {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت : 45].
وخامسة : يكون بعد الارتكاب ، فيذكر طلباً لرضائه ، قال تعالى : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} [آل عمران : 135].
وسادسة : حين ارتكاب ما لا يرتضيه الله تعالى ، وقد ورد في الدعاء : " وعزتك وجلالك ما اردت بمعصيتي مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ، ولا لعقوبتك متعرض ، ولا لنظرك مستخف ، ولكن سولت لي نفسي".
إن قيل : ذكره تعالى حين ارتكاب ما لا يرتضيه الله عز وجل ، كيف يكون محبوباً له تعالى ؟
يقال : إن الذكر إذا كان على نحو الاستخفاف والاستهانة - نعوذ بالله - فلا ريب في أنه ليس من الذكر، بل يوجب الكفر والبعد عن ساحة الرحمن.
وأما إذا كان من باب أنه تعالى ستار العيوب ، وغفار الذنوب، فهذا يوجب الحياء منه تعالى ولو في ما بعد ، فينتهي إلى التوبة والاستغفار ، فيكون محبوباً له .
قال تعالى : {اذكركم} للمفسرين في بيان متعلق الذكر أقوال :
منها : اذكروني بطاعتي، أذكركم برحمتي ، أو أذكركم بمعونتي.
ومنها: اذكروني بالشكر على نعمائي ، أذكركم بالزيادة ، إلى غير ذلك مما قالوه.
والحق هو الحمل على العموم ، وهو ذكر الله تعالى في كل مظهر من مظاهر العبودية حتى يدرك ذكر الله تعالى في كل مظهر من مظاهر رحمته وجوده ، ومنه ما ورد في الحديث : " أنا عند ظن عبدي المؤمن إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإذا ذكرني في ملا ذكرته في ملأ , خير منه - الحديث " وهو يجازي عبده بالجزاء الأوفى ، ويعد له باللطف والكرامة والإحسان ومزيد من النعم ، ويضاعف لمن كان، إنه ذو فضل عظيم.
فلا يختص ذكره تعالى لذاكريه بعالم دون آخر ، ولا بحالة دون أخرى.
ثم إن ترتب قوله تعالى : {اذكركم} على " اذكروني " من باب ترتب المعلول على العلة التامة ، لأن التوجه الفعلي من العبد إلى الله عز وجل ، ذكر منه تعالى للعبد بعناياته الخاصة ، فيكون هذا المعنى من الذكر من الصفات ذات الإضافة ، فإن أضيف إلى العبد ، يكون ذكراً منه ، وإن أضيف إليه عز وجل ، يكون من ذكر الله تعالى له.
وقد يكون من باب ترتب المقتفى {بالفتح} على المقتضي ( بالكسر ) ، لاختلاف مراتب الذكر والذاكر كما هو معلوم ، والظاهر أن ملازمة الذكر للذكر ، من الملازمات المتعارفة بين العقلاء ، فهو حسن لديهم، يكون من الله تعالى أحسن.
قال تعالى : {وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة : 152].
مادة : (ش ك ر) كمادتي (ك ش ر) ، و (ك ش ف) تأتي بمعنى الإظهار ، ويقابلها مادة : (ك ف ر) التي تأتي بمعنى الستر ، ويختلف ذلك باختلاف المتعلق اختلافاً كثيراً.
والجامع القريب في الأولى الإظهار ، وفي الثانية الستر.
فإظهار وحدانية الله تعالى ، وصفاته الحسنى ، وأفعاله العليا ؛ إيمان ؛ وستر ذلك كفر ، ولهما مراتب.
كما أن إظهار نعمه شكر وسترها كفر ، ويطلق عليه الكفران أيضا. والإظهار تارة : يكون الاعتقاد.
وأخرى : بالقول .
وثالثة : بالعمل ، إما بفعل ما أوجبه الله تعالى ، أو ترك ما نهاه عنه تعالى ، وقد قال علي (عليه السلام) : " شكر كل نعمة ، الورع عن محارم الله تعالى".
والمعنى : أظهروا نعمائي ، ولا تكفروا بسترها.
وإنما قال تعالى : {وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ } [البقرة : 152] ، ولم يقل : واشكروا لي أشكركم ، لأمور :
أحدها : الإعلان بقبح الكفر والكفران استقلالا.
ثانيها : التنبيه على عظم النعمة ، وأنه بمنزلة كفر الذات.
ثالثها : أنه استفيد من مقابلة الذكر بالذكر - في قوله تعالى :
{ اذكروني أذكركم} - بالملازمة ، فلا وجه للتكرار بعد ذلك.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











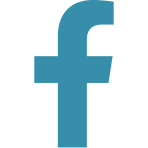

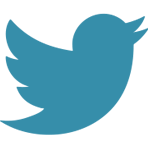

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)