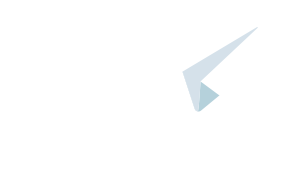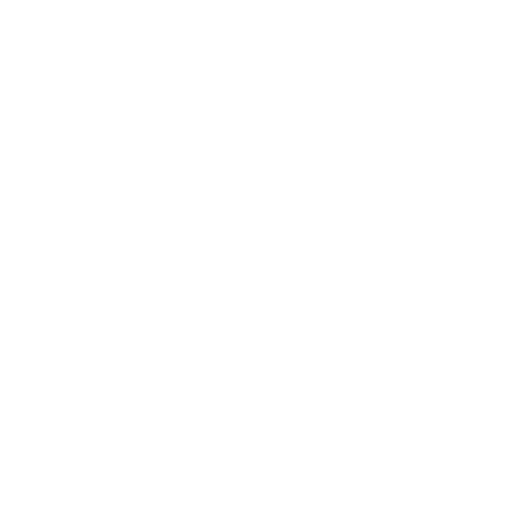تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير آية (178 - 181) من سورة الأعراف
المؤلف:
المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
9-8-2019
4152
قال تعالى : {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178) ولَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ولَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179) ولِلَّهِ الأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180) ومِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 178 - 181] .
قال تعالى : {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ} [الأعراف : 178] .
{من يهد الله فهو المهتدي} كتبت ههنا بالياء ليس في القرآن غيره بالياء ، وأثبت الياء ههنا في اللفظ جميع القراء ، ومعناه من يهده الله إلى نيل الثواب ، كما يهدي المؤمن إلى ذلك ، وإلى دخول الجنة ، فهو المهتدي للإيمان والخير ، عن الجبائي {ومن يضلل} أي : ومن يضلله الله عن طريق الجنة ، وعن نيل الثواب ، عقوبة على كفره وفسقه . {فأولئك هم الخاسرون} خسروا الجنة ونعيمها ، وخسروا أنفسهم والانتفاع بها . وقيل : المهتدي هو الذي هداه الله فقبل الهداية ، وأجاب إليها . والذي أضله الله هو الذي اختار الضلالة فخلى الله بينه وبين ما اختاره ، ولم يمنعه منه بالجبر ، عن البلخي .
- {ولَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ولَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179) ولِلَّهِ الأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180) ومِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 179 - 181] .
لما بين سبحانه أمر الكفار ، وضرب لهم الأمثال ، عقبه ببيان حالهم في المصير والمال ، فقال : {ولقد ذرأنا} أي : خلقنا {لجهنم كثيرا من الجن والإنس} يعني : خلقناهم على أن عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنكارهم ، وسوء اختيارهم ، ويدل على هذا المعنى قوله سبحانه : {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} فأخبر أنه خلقهم للعبادة ، فلا يجوز أن يكون خلقهم للنار . وقوله : {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} ، {ولقد صرفناه بينهم ليذكروا} في نظائر لذلك لا تحصى ، والمراد في الآية كل من علم الله تعالى ، أنه لا يؤمن ، ويصير إلى النار .
{لهم قلوب لا يفقهون بها} الحق لأنهم لا يتدبرون أدلة الله تعالى ، وبيناته {ولهم أعين لا يبصرون بها} الرشد {ولهم آذان لا يسمعون بها} الوعظ لأنهم يعرضون عن جميع ذلك ، إعراض من ليست له آلة الإدراك . وقد مر تفسيره في سورة البقرة ، عند قوله : {صم بكم عمي} الآية : {أولئك كالأنعام} أي : هؤلاء الذين لا يتدبرون آيات الله ، ولا يستدلون بها على وحدانيته ، وصدق أنبيائه ، أشباه الأنعام والبهائم التي لا تفقه ، ولا تعلم {بل هم أضل} من البهائم ، فإنها إذا زجرت انزجرت ، وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت ، وهؤلاء لكفرهم وعتوهم ، لا يهتدون إلى شيء من الخيرات ، مع ما ركب الله فيهم من العقول الدالة على الرشاد ، الصارفة عن الفساد . ولم يذكر {بل} ههنا للرجوع عن الأول . ولكن للإضراب عنه مع بقائه . وقيل : إنما قال {بل هم أضل} من الأنعام ، لأن الأنعام لم تعط آلة المعرفة والتمييز فلا تلحقها المذمة ، وهؤلاء أعطوا آلة المعرفة والتمييز فضيعوها ، ولم ينتفعوا بها ، ولأن الأنعام وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية ، وهؤلاء عصاة ، فهم أسوأ حالا منها {أولئك هم الغافلون} عن آياتي وحججي ، وعن الاستدلال والاعتبار بتدبرها ، والتفكر فيها ، دون البهائم التي هي مسخرة مصرفة . وقيل : الغافلون عما بحل بهم في الآخرة من العذاب {ولله الأسماء الحسنى} أخبر سبحانه أن له الأسماء الحسنى ، لحسن معانيها ، مثل : الجواد ، والرحيم ، والرازق ، والكريم . ويقال : إن جميع أسمائه داخلة فيه ، وإنها كلها حسنة متضمنة لمعان حسنة ، فمنها ما يرجع إلى صفات ذاته كالعالم ، والقادر ، والحي ، والإله ، والقديم ، والسميع ، والبصير . ومنها ما هي صفات فعله كالخالق ، والرازق ، والمبدع ، والمحي ، والمميت . ومنها ما يفيد التنزيه ، ونفي صفات النقص عنه كالغني ، والواحد ، والقدوس ، ونحو ذلك .
وقيل : المراد بالحسنى : ما مالت إليه النفوس من ذكر العفو والرحمة ، دون السخط والنقمة {فادعوه بها} أي : بهذه الأسماء الحسنى ، ودعاؤه بها أن يقال : يا الله! يا رحمن! يا رحيم!! يا خالق السماوات والأرض! وكل اسم لله سبحانه ، فهو صفة مفيدة ، لأن اللقب لا يجوز عليه ، فإنه بمنزلة الإشارة إلى الحاضر .
وقد ورد في الحديث : (إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدة ، من أحصاها دخل الجنة ، إنه وتر يحب الوتر) أورده مسلم في الصحيح . {وذروا الذين يلحدون في أسمائه} أي : دعوا الذين يعدلون بأسماء الله تعالى عما هي عليه ، فيسمون بها أصنامهم ، ويغيرونها بالزيادة والنقصان ، فاشتقوا اللات من الله ، والعزى من العزيز ، ومنات من المنان ، عن ابن عباس ، ومجاهد . وقيل : إن معنى {يلحدون في أسمائه} : يصفونه بما لا يليق به ، ويسمونه بما لا يجوز تسميته به .
وهذا الوجه أعم فائدة ، ويدخل فيه قول الجبائي أراد تسميتهم المسيح بأنه أبن الله ، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى ، إلا بما سمى به نفسه .
{سيجزون ما كانوا يعملون} في الآخرة . وقيل : في الدنيا والآخرة {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق} : أخبر سبحانه من جملة من خلقه جماعة وعصبة ، يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى ، وإلى دينه ، وهو الحق يرشدونهم إليه {وبه يعدلون} أي : وبالحق يحكمون . وروى ابن جريج ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (هي لأمتي بالحق يأخذون ، وبالحق يعطون . وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ، {ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} . وقال الربيع بن أنس : قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ، فقال : إن من أمتي قوما على الحق ، حتى ينزل عيسى بن مريم .
وروى العياشي بإسناده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، أنه قال : (والذي نفسي بيده ، لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار ، إلا فرقة واحدة {وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون} فهذه التي تنجو) وروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : (نحن هم) .
_________________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 397 - 400 .
{مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ} . ليس المراد ان من يخلق اللَّه فيه الهداية فهو المهتدي ، ومن يخلق فيه الضلال فهو الضال . .
كلا ، ان هذا المعنى تأباه الفطرة والبديهة . . لأن اللَّه ليس بظلَّام للعبيد ، وأيضا يأباه النص القرآني : {فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها} [يونس - 108] . وكيف يجمع اللَّه تعالى بين وصفي العدالة والإضلال ؟ . ان الشيطان هو المضل : {قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ} [القصص - 15] . {وأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ} .
والذي نراه ان المعنى المقصود من الآية ان المهتدي حقا هو من كان عند اللَّه مهتديا ، ولو كان عند الناس ضالا . . وليس من شك ان الإنسان لا يكون من المهتدين في الميزان الإلهي إلا إذا آمن وعمل صالحا : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ} [يونس - 9] . {والَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وإِنَّ اللَّهً لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت - 69] . وكذلك الضال فإنه من كان ضالا في حساب اللَّه ، لا في حساب الناس . وبكلمة ان الآية تحدد معنى كل من المهتدي والضال بأنه من كان كذلك عند اللَّه ، تماما كما قال الإمام علي ( عليه السلام ) : الغنى والفقر بعد العرض على اللَّه .
{ولَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ} . ذرأنا خلقنا . . واللَّه سبحانه لم يخلق ولن يخلق أحدا بقصد تعذيبه ، كيف ؟ . وهل يلتذ جلت عظمته بتعذيب المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ، ولا يهتدون سبيلا ؟ . في بعض ما قرأت ان الامريكيين كانوا إذا أرادوا الترويح عن النفس جاؤوا بأحد الملونين ، وتحلقوا حوله ، وأمطروه بوابل من رصاص مسدساتهم ، فيسقط على الأرض متخبطا بدمائه ، وهم يرسلون القهقهات عاليا . . واللَّه لن يشوي البشر بناره إلا إذا تجنس بالجنسية الأمريكية أو الصهيونية . . تعالى اللَّه عما يصفون .
ان اللَّه سبحانه خلق الإنسان للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وزوده بجميع المؤهلات لذلك ، وأعطاه العقل المميز بين الهدى والضلال ، وأرسل الرسل لإيقاظه وإرشاده ، وترك له الخيار في سلوك الطريق الذي يشاء منهما ، لأن الحرية هي قوام حقيقة الإنسان ، ولو سلبها منه لكان هو والجماد سواء ، فان اختار طريق الهدى أدى به إلى مرضاة اللَّه وثوابه ، وان سلك طريق الضلال فمآله جهنم وساءت مصيرا . . وعلى هذا تكون اللام في لجهنم لام العاقبة مثل اللام في ليكون من قوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ، ومثل : لدوا للموت وابنوا للخراب .
وتسأل : ان اللَّه سبحانه قال : {وما خَلَقْتُ الْجِنَّ والإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} وأنت تقول : خلق اللَّه الإنسان للعلم النافع ، والعمل الصالح .
الجواب ان العلم النافع والعمل الصالح من أفضل الطاعات ، فقد جاءت الرواية : عالم واحد أفضل من ألف عابد ، وألف زاهد ، وفي رواية ثانية : عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عابد .
{لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ولَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها} . كل شيء لا يؤدي الغاية المطلوبة منه فوجوده وعدمه سواء من هذه الحيثية .
ومن أهم الغايات المقصودة من القلب أن ينفتح لدلائل الحق ، ومن العين أن تبصر هذه الدلالة ، ومن الأذن أن تسمعها ، فإذا أعرضت هذه الأجهزة الثلاثة عن ذلك ، ولم تنتفع بشيء من دلائل الحق كان وجودها كعدمه ، قال تعالى : {إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ} [ق : 37] . فالقلب والسمع موجودان ، ومع ذلك يصح سلب الوجود عنهما إذا غفلا عن آيات الحق ودلائله {أُولئِكَ كَالأَنْعامِ} لهم قلوب وأعين وآذان ، ولكن قلوبهم لا تنفتح للحق ، وأعينهم لا تبصر دلائله ، وآذانهم لا تسمعها فكانوا كالأنعام بل تنفتح للحق ، وأعينهم لا تبصر دلائله ، وآذانهم لا تسمعها فكانوا كالأنعام {بَلْ هُمْ أَضَلُّ} لأن الأنعام تؤدي الغرض المطلوب منها على أكمل وجه ، ولأنها تعجز عن تحصيل الكمال ، ولا تحاسب وتعاقب ، وبالتالي هي تعرف خالقها بالفطرة ، والكافرون لا يؤدون المطلوب منهم ، وقادرون على الكمال ، ولا يفعلونه ، وهم محاسبون ومعاقبون {أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ} عن دلائل اللَّه في أنفسهم وفي الآفاق ، وعن مصيرهم وما سيحل بهم في الآخرة من الخزي والعذاب .
هل أسماء اللَّه توقيفية أو قياسية ؟
{ولِلَّهِ الأَسْماءُ الْحُسْنى} . كل أسماء اللَّه حسنة ، لأنها تعبر عن أحسن المعاني وأكملها ، وكلها على مستوى واحد في الحسن ، إذ ليس للَّه حالات متعددة ، ولا صفات متغايرة ، حتى عند القائلين بأن صفاته غير ذاته ، ولا أفعال متفاوتة ، فخلق جناح بعوضة وخلق الكون بأسره سواء لديه ، يوجد كلا بكلمة {كُنْ فَيَكُونُ} . . ومتى تساوت المعاني تساوت الألفاظ لأنها فرع ، والفرع يتبع الأصل .
( فَادْعُوهُ بِها} . أي اذكروا اللَّه ، وادعوه بأي اسم شئتم من أسمائه ، فكلها ألفاظ تعبر عن تنزيهه وتعظيمه على مستوى واحد ، وليس للَّه اسم أعظم ، واسم غير أعظم ، فكل ما دل عليه هو أعظم الدلالات ، لأن المدلول أعظم الموجودات . .
ومن أجل هذا لا نقول مع القائل : ان للَّه اسما خاصا هو الاسم الأعظم ، وان من عرفه فاضت عليه الخيرات ، وظهرت على يده المعجزات . . وقيل (ان للَّه تسعا وتسعين اسما ، وان من أحصاها دخل الجنة) . حتى كأنّ اللَّه خلق جنته لمؤلفي قواميس اللغة ، لا للمتقين ! .
{وذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} . . اللحد والإلحاد الميل عن القصد ، ومعنى الجملة النهي عن اطلاق أية كلمة تشعر بالربوبية على غيره ، سواء أكان ذلك الغير نبيا أو كوكبا أو صنما أو أي شيء ، وأيضا لا يجوز اطلاق أية كلمة عليه تشعر بغير الربوبية كالأب والابن .
واختلف علماء الكلام في أسماء اللَّه تعالى : هل هي توقيفية أو قياسية ؟ . ومعنى توقيفية الوقوف في أسمائه على ما جاء في الكتاب والسنة ، بحيث لا يجوز اطلاق أي اسم عليه إلا إذا نصت عليه آية أو رواية ، ومعنى قياسية ان أي لفظ كان معناه ثابتا في حق اللَّه فيجوز اطلاق هذا اللفظ عليه ، سواء أورد في كتاب اللَّه ، أم لم يرد .
وذهب أكثر العلماء إلى أن أسماء اللَّه توقيفية . أما نحن فنجيز مخاطبة اللَّه ومناجاته بكل ما يدل على التنزيه والتعظيم ، سواء أورد له ذكر في القرآن والحديث أم لم يرد ، ولا نمنع إلا عما منع اللَّه عنه ، عملا بالمبدأ القائل : كل شيء مباح ، حتى يرد فيه نهي على شرط التعظيم . . هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد العلمية الدينية ، بالإضافة إلى اجماع الأمة قديما وحديثا في كل زمان ومكان على ان لغير العرب أن يعبروا عن ذات اللَّه وصفاته وأفعاله بلغتهم الخاصة بهم .
{ومِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبِهِ يَعْدِلُونَ} . كل الناس منهم مؤمن وكافر ، وطيب وخبيث ، وما من أحد إلا ويعرف هذه الحقيقة ، فما هو القصد من بيانها ؟ .
الجواب : قال سبحانه في الآية السابقة : ان كثيرا من الجن والإنس مصيرهم إلى جهنم {ولَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ} فناسب ان يقول هنا : وان أمة منهم مصيرها إلى الجنة ، وان تكن هذه أقل من تلك كما تشعر لفظة من . وعبّر عن أهل الجنة بالذين يهدون بالحق وبه يعدلون إشارة إلى ان السبب الموجب لدخولهم الجنة هو الهدي والعدل .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج4 ، ص 423-427 .
قوله تعالى : ﴿من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون﴾ اللام في ﴿المهتدي﴾ و ﴿الخاسرون﴾ يفيد الكمال دون الحصر ظاهرا ، ومفاد الآية أن مجرد الاهتداء إلى شيء لا ينفع شيئا ولا يؤثر أثر الاهتداء إلا إذا كانت معه هداية الله سبحانه فهي التي يكمل بها الاهتداء ، وتتحتم معها السعادة ، وكذلك مجرد الضلال لا يضر ضررا قطعيا إلا بانضمام إضلال الله سبحانه إليه فعند ذلك يتم أثره ، ويتحتم الخسران .
فمجرد اتصال الأنسال بأسباب السعادة كظاهر الإيمان والتقوى وتلبسه بذلك لا يورده مورد النجاة ، وكذلك اتصاله وتلبسه بأسباب الضلال لا يورده مورد الهلاك والخسران إلا أن يشاء الله ذلك فيهدي بمشيئته من هدى ، ويضل بها من أضل فيئول المعنى إلى أن الهداية إنما تكون هداية حقيقية تترتب عليها آثارها إذا كانت لله فيها مشية ، وإلا فهي صورة هداية وليست بها حقيقة ، وكذلك الأمر في الإضلال ، وإن شئت فقل : إن الكلام يدل على حصر الهداية الحقيقية في الله سبحانه وكذلك الإضلال ولا يضل به إلا الفاسقين .
قوله تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾ إلى آخر الآية .
الذرء هو الخلق ، وقد عرف الله سبحانه جهنم غاية لخلق كثير من الجن والإنس ، ولا ينافي ذلك ما عرف في موضع آخر أن الغاية لخلق الخلق هي الرحمة وهي الجنة في الآخرة كقوله تعالى : ﴿إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾ هود : 119 فإن الغرض يختلف معناه بحسب كمال الفعل ونهاية الفعل التي ينتهي إليها .
بيان ذلك أن النجار إذا أراد أن يصنع بابا عمد إلى أخشاب يهيئها له ثم هندسه فيها ثم شرع في النشر والنحت والخرط حتى أتم الباب فكمال غرضه من إيقاع الفعل على تلك الخشبات هو حصول الباب لا غير ، هذا من جهة ومن جهة أخرى هو يعلم من أول الأمر أن جميع أجزاء تلك الخشبات ليست تصلح لأن تكون أجزاء للباب فإن للباب هيئة خاصة لا تجامع هيئة الخشبات ، ولا بد في تغيير هيئتها من ضيعة بعض الأجزاء لخروجها عن هندسة العمل فصيرورة هذه الأبعاض فضلة يرمى بها داخلة في قصد الصانع مرادة له بإرادة تسمى قصدا ضروريا فللنجار في صنع الباب بالنسبة إلى الأخشاب التي بين يديه نوعان من الغاية : أحدهما الغاية الكمالية وهي أن يصنع منها بابا ، والثاني الغاية التابعة وهي أن يصنع بعضها بابا ويجعل بعضها فضلة لا ينتفع بها وضيعة يرمى بها ، وذلك لعدم استعدادها لتلبس صورة الباب .
وكذا الزارع يزرع أرضا ليحصد قمحا فلا يخلص لذلك إلى يوم الحصاد إلا بعض ما صرفه من البذر ، ويذهب غيره سدى يضيع في الأرض أو تفسده الهوام أو يخصفه المواشي والجميع مقصودة للزراع من وجه ، والمحصول من القمح مقصود من وجه آخر .
وقد تعلقت المشية الإلهية أن يخلق من الأرض إنسانا سويا يعبده ويدخل بذلك في رحمته ، واختلاف الاستعدادات المكتسبة من الحياة الدنيوية على ما لها من مختلف التأثيرات لا يدع كل فرد من أفراد هذا النوع أن يجري في مجراه الحقيقي ويسلك سبيل النجاة إلا من وفق له ، وعند ذلك تختلف الغايات وصح أن لله سبحانه غاية في خلقة الإنسان مثلا وهو أن يشملهم برحمته ويدخلهم جنته ، وصح أن لله غاية في أهل الخسران والشقاوة من هذا النوع وهو أن يدخلهم النار وقد كان خلقهم للجنة غير أن الغاية الأولى غاية أصلية كمالية ، والغاية الثانية غاية تبعية ضرورية ، والقضاء الإلهي المتعلق بسعادة من سعد وشقاوة من شقى ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغاية فإنه تعالى يعلم ما يئول إليه حال الخلق من سعادة أو شقاء فهو مريد لذلك بإرادة تبعية لا أصلية .
وعلى هذا النوع من الغاية ينزل قوله تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾ وما في هذا المساق من الآيات الكريمة وهي كثيرة .
وقوله : ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها﴾ إشارة إلى بطلان استعدادهم للوقوع في مجرى الرحمة الإلهية ، والوقوف في مهب النفحات الربانية ، فلا ينفعهم ما يشاهدونه من آيات الله ، وما يسمعونه من مواعظ أهل الحق ، وما تلقنه لهم فطرتهم من الحجة والبينة .
ولا يفسد عقل ولا عين ولا أذن في عمله وقد خلقها الله لذلك ، وقد قال : ﴿لا تبديل لخلق الله﴾ الروم : 30 إلا أن يكون الذي يغيره هو الله سبحانه فيكون من جملة الخلق لكنه سبحانه لا يغير ما أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، قال تعالى ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ الأنفال : 53 .
فالذي أبطل ما عندهم من الاستعداد ، وأفسد أعمال قلوبهم وأعينهم وآذانهم هو الله سبحانه فعل بهم ما فعل جزاء بما كسبوا نكالا فهم غيروا نعمة الله بتغيير طريق العبودية فجازاهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يفقهون بها ، وجعل الغشاوة على أبصارهم فلا يبصرون بها ، والوقر على آذانهم فلا يسمعون بها فهذه آية أنهم مسيرون إلى النار .
وقوله : ﴿أولئك كالأنعام بل هم أضل﴾ نتيجة ما تقدم ، وبيان لحالهم فإنهم فقدوا ما يتميز به الإنسان من سائر الحيوان ، وهو تمييز الخير والشر والنافع والضار بالنسبة إلى الحياة الإنسانية السعيدة من طريق السمع والبصر والفؤاد .
وإنما شبهوا من بين الحيوان العجم بالأنعام مع أن فيهم خصال السباع الضارية وخصائصها كخصال الأنعام الراعية ، لأن التمتع بالأكل والسفاد أقدم وأسبق بالنسبة إلى الطبع الحيواني فجلب النفع أقدم من دفع الضر ، وما في الإنسان من القوى الدافعة الغضبية مقصودة لأجل ما فيه من القوى الجاذبة الشهوية ، وغرض النوع بحسب حياته الحيوانية يتعلق أولا بالتغذي والتوليد ، ويتحفظ على ذلك بإعمال القوى الدافعة فالآية تجري مجرى قوله تعالى : ﴿والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾ محمد : 12 .
وأما كونهم أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام ، ولازمه ثبوت ضلال ما في الأنعام فلأن الضلال في الأنعام نسبي غير حقيقي فإنها مهتدية بحسب ما لها من القوى المركبة الباعثة لها إلى قصر الهمة في الأكل والتمتع غير ضالة فيما هيئت لها من سعادة الحياة ولا مستحقة للذم فيما أخذت إليه ، وإنما تعد ضالة بقياسها إلى السعادة الإنسانية التي ليست لها ولا جهزت بما تتوسل به إليها .
وأما هؤلاء المطبوع على قلوبهم وأعينهم وآذانهم فالسعادة سعادتهم وهم مجهزون بما يوصلهم إليها ويدلهم عليها من السمع والبصر والفؤاد لكنهم أفسدوها وضيعوا أعمالها .
ونزلوها منزلة السمع والبصر والقلب التي في الأنعام ، واستعملوها فيما تستعملها فيه الأنعام وهو التمتع من لذائذ البطن والفرج فهم أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام ، وإليهم يعود الذم .
وقوله : ﴿أولئك هم الغافلون﴾ نتيجة وبيان حال أخرى لهم وهو أن حقيقة الغفلة هي التي توجد عندهم فإنها بمشية الله سبحانه ، ألبسها إياهم بالطبع الذي طبع به على قلوبهم وأعينهم وآذانهم والغفلة مادة كل ضلال وباطل .
قوله تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ الاسم بحسب اللغة ما يدل به على الشيء سواء أفاد مع ذلك معنى وصفيا كاللفظ الذي يشار به إلى الشيء لدلالته على معنى موجود فيه ، أو لم يفد إلا الإشارة إلى الذات كزيد وعمرو وخاصة المرتجل من ، الأعلام وتوصيف الأسماء الحسنى - وهي مؤنث أحسن - يدل على أن المراد بها الأسماء التي فيها معنى وصفي دون ما لا دلالة لها إلا على الذات المتعالية فقط لو كان بين أسمائه تعالى ما هو كذلك ، ولا كل معنى وصفي ، بل المعنى الوصفي الذي فيه شيء من الحسن ، ولا كل معنى وصفي حسن بل ما كان أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبر مع الذات المتعالية : فالشجاع والعفيف من الأسماء الحسنة لكنهما لا يليقان بساحة قدسه لإنبائهما عن خصوصية جسمانية لا يمكن سلبها عنهما ، ولو أمكن لم يكن مانع عن إطلاقهما عليه كالجواد والعدل والرحيم .
فكون اسم ما من أسمائه تعالى أحسن الأسماء أن يدل على معنى كمالي غير مخالط لنقص أو عدم ، مخالطة لا يمكن معها تحرير المعنى من ذلك النقص والعدم وتصفيته ، وذلك في كل ما يستلزم حاجة أو عدما وفقدا كالأجسام والجسمانيات والأفعال المستقبحة أو المستشنعة ، والمعاني العدمية : فهذه الأسماء بأجمعها محصول لغاتنا لم نضعها إلا لمصاديقها فينا التي لا تخلو عن شوب الحاجة والنقص غير أن منها ما لا يمكن سلب جهات الحاجة والنقص عنها كالجسم واللون والمقدار وغيرها ، ومنها ما يمكن فيه ذلك كالعلم والحياة والقدرة فالعلم فينا الإحاطة بالشيء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادية ، والقدرة فينا المنشأة للفعل بكيفية مادية موجودة لعضلاتنا ، والحياة كوننا بحيث نعلم ونقدر بما لنا من وسائل العلم والقدرة فهذه لا تليق بساحة قدسه غير أنا إذا جردنا معانيها عن خصوصيات المادة عاد العلم وهو الإحاطة بالشيء بحضوره عنده ، والقدرة هي المنشأة للشيء بإيجاده ، والحياة كون الشيء بحيث يعلم ويقدر ، وهذه لا مانع من إطلاقها عليه لأنها معان كمالية خالية عن جهات النقص والحاجة ، وقد دل العقل والنقل أن كل صفة كمالية فهي له تعالى وهو المفيض لها على غيره من غير مثال سابق فهو تعالى عالم قادر حي لكن لا كعلمنا وقدرتنا وحياتنا بل بما يليق بساحة قدسه من حقيقة هذه المعاني الكمالية مجردة عن النقائص .
وقد قدم الخبر في قوله : ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ وهو يفيد الحصر ، وجيء بالأسماء محلى باللام ، والجمع المحلى باللام يفيد العموم ، ومقتضى ذلك أن كل اسم أحسن في الوجود فهو لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد ، وإذ كان الله سبحانه ينسب بعض هذه المعاني إلى غيره ويسميه به كالعلم والحياة والخلق والرحمة فالمراد بكونها لله كون حقيقتها له وحده لا شريك له .
وظاهر الآيات بل نص بعضها يؤيد هذا المعنى كقوله : ﴿إن القوة لله جميعا﴾ البقرة : 165 .
وقوله : ﴿فإن العزة لله جميعا﴾ النساء : 139 ، وقوله : ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ البقرة : 255 ، وقوله : ﴿هو الحي لا إله إلا هو﴾ المؤمنون : 66 فلله سبحانه حقيقة كل اسم أحسن لا يشاركه غيره إلا بما ملكهم منه كيفما أراد وشاء .
ويؤيد هذا المعنى ظاهر كلامه أينما ذكر أسماؤه في القرآن كقوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى﴾ طه : 8 وقوله : ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ الإسراء : 110 ، وقوله : ﴿له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض﴾ الحشر : 24 فظاهر الآيات جميعا كون حقيقة كل اسم أحسن لله سبحانه وحده .
وما احتمله بعضهم أن اللام في ﴿الأسماء﴾ للعهد مما لا دليل عليه ولا في القرائن الحافة بالآيات ما يؤيده غير ما عهده القائل من الأخبار العادة للأسماء الحسنى .
وقوله : ﴿فادعوه بها﴾ إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولنا : دعوته زيدا ودعوتك أبا عبد الله أي سميته وسميتك ، وإما من الدعوة بمعنى النداء أي نادوه بها فقولوا : يا رحمن يا رحيم وهكذا .
أو من الدعوة بمعنى العبادة أي فاعبدوه مذعنين أنه متصف بما يدل عليه هذه الأسماء من الصفات الحسنة والمعاني الجميلة .
وقد احتملوا جميع هذه المعاني غير أن كلامه تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الرب يؤيد هذا المعنى الأخير كما في الآية السابقة : ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ وقوله :﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ المؤمنون : 60 حيث ذكر أولا الدعاء ثم بدله ثانيا من العبادة إيماء إلى اتحادهما ، وقوله : ﴿ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين﴾ الأحقاف : 6 ، وقوله : ﴿هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين﴾ المؤمنون : 65 يريد إخلاص العبادة .
ويؤيده ذيل الآية : ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون﴾ بظاهره فإنه لو كان المراد بالدعاء التسمية أو النداء دون العبادة لكان الأنسب أن يقال : بما كانوا يصفون كما قال في موضع آخر : ﴿سيجزيهم وصفهم﴾ الأنعام : 139 .
فمعنى الآية - والله أعلم - ولله جميع الأسماء التي هي أحسن فاعبدوه وتوجهوا إليه بها ، والتسمية والنداء من لواحق العبادة .
قوله تعالى : ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾ إلى آخر الآية .
اللحد والإلحاد بمعنى واحد وهو التطرف والميل عن الوسط إلى أحد الجانبين ، ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح الذي في الوسط فقراءة يلحدون بفتح الياء من المجرد ، ويلحدون بضم الياء من باب الإفعال بمعنى واحد ، ونقل عن بعض اللغويين : أن اللحد بمعنى الميل إلى جانب ، والإلحاد بمعنى الجدال والمماراة .
وقوله : ﴿سيجزون﴾ الآية بالفصل لأنه بمنزلة الجواب لسؤال مقدر كأنه لما قيل : ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾ قيل : إلى م يصير حالهم؟ فأجيب : ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ وللبحث في الأسماء الحسنى بقايا ستوافيك في كلام مستقل نورده بعد الفراغ عن تفسير الآيات إن شاء الله تعالى .
قوله تعالى : ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ قد مر بعض ما يتعلق به من الكلام في قوله تعالى : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ الآية 159 من السورة وتختص هذه الآية بأنها لوقوعها في سياق تقسيم الناس إلى ضال ومهتد ، وبيان أن الملاك في ذلك دعاؤه سبحانه بأحسن الأسماء اللائقة بحضرته والإلحاد في أسمائه ، تدل على أن النوع الإنساني يتضمن طائفة قليلة أو كثيرة مهتدية حقيقة إذ الكلام في الاهتداء والضلال الحقيقيين المستندين إلى صنع الله ، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ، والاهتداء الحقيقي لا يكون إلا عن هداية حقيقية ، وهي التي لله سبحانه ، وقد تقدم في قوله تعالى : ﴿فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين﴾ الأنعام : 89 ، وغيره أن الهداية الحقيقية الإلهية لا تتخلف عن مقتضاها بوجه وتوجب العصمة من الضلال ، كما أن الترديد الواقع في قوله تعالى : ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى﴾ يونس : 35 .
يدل على أن من يهدي إلى الحق يجب أن لا يكون مهتديا بغيره إلا بالله فافهم ذلك .
وعلى هذا فإسناد الهداية إلى هذه الأمة لا يخلو عن الدلالة على مصونيتهم من الضلال واعتصامهم بالله من الزيغ إما بكون جميع هؤلاء المشار إليهم بقوله : ﴿أمة يهدون بالحق﴾ متصفين بهذه العصمة والصيانة كالأنبياء والأوصياء ، وإما بكون بعض هذه الأمة كذلك وتوصيف الكل بوصف البعض نظير قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة﴾ الجاثية : 16 ، وقوله : ﴿وجعلكم ملوكا﴾ المائدة : 20 ، وقوله :﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ البقرة : 143 ، وإنما المتصف بهذه المزايا بعضهم دون الجميع .
والمراد بالآية - والله أعلم - أنا لا نأمركم بأمر غير واقع أو خارج عن طوق البشر فإن ممن خلقنا أمة متلبسة بالاهتداء الحقيقي هادين بالحق لأن الله كرمهم بهدايته الخاصة .
_____________________________
1. تفسير الميزان ، ج8 ، ص 334-346 .
قال تعالى : {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ومَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ } [الأعراف : 178] .
هذه الآية تحذّر الإنسان وتؤكّد له أن الخلاص من مثل هذا الانحراف وما يكيده الشياطين لا يمكن إلّا بتوفيق وتسديد من الله عزوجل {مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ} .
وتقدم كرّات بأنّ (الهداية) و (الإضلال) الإلهيين لا يعدان إجبارا ولا بدون حساب أو دليل ، ويقصد بهما إعداد الأرضية للهداية وفتح سبلها أو إيصادها ، وذلك بسبب الأعمال الصالحة أو الطالحة التي صدرت من الإنسان من قبل ، وعلى أية حال فالتصميم النهائي بيد الإنسان نفسه ... فبناء على هذا فإنّ الآية محل البحث تنسجم مع الآيات المتقدمة التي تذهب إلى أصل حرية الإرادة ... ولا منافاة بين هذه الآية وتلكم الآيات بتاتا ...
- {وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ * وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 179-181] .
علائم أهل النّار :
هذه الآيات تكمل الموضوع الذي تناولته الآيات المتقدمة حول العلماء الذين ركنوا إلى الدنيا ، وعوامل الهداية والضلال. والآيات ـ محل البحث ـ تقسم الناس إلى مجموعتين ... وتحكى عن صفاتهما وهما أهل النّار ، وأهل الجنّة .
فتتحدث عن المجموعة الأولى ـ أهل النّار أوّلا ، فتأتي بالقسم والتوكيد فتقول {وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} .
وكلمة «ذرأنا» مشتقّة من «ذرأ» ، وتعني هنا الإيجاد والخلق ، غير أنّها في أصل اللغة تعني نشر الشيء وتفريقه ، وقد وردت بهذا المعنى «الثّاني» في القرآن أيضا ، كما في عبارة {تَذْرُوهُ الرِّياحُ} [الكهف : 45] .
ولأنّ خلق الكائنات يستلزم تفريقها وتوزيعها وانتشارها على وجه الأرض ، فقد جاءت هذه الكلمة بمعنى خلق «المخلوق» أيضا : وعلى كل حال ، فإنّ الإشكال المهم في هذا التعبير هو كيف قال الله سبحانه {وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} ؟ في حين قال في مكان آخر {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56] وطبقا لمعنى هذه الآية فإنّ الجن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله والرقي والتكامل والسعادة ، أضف إلى ذلك أنّ هذا التعبير تشمّ منه رائحة الجبر في الخلق ، ومن هنا فقد استدل بعض مؤيدي مدرسة الجبر من أمثال الفخر الرازي بهذه الآية لإثبات مذهبه.
لكنّنا لو ضممنا آيات القرآن بعضها إلى بعض وبحثناها موضوعيّا دون أن نبتلى بالسطحيّة ، لوجدنا الجواب على هذا السؤال كامنا في الآية محل البحث ذاتها ، كما هو بيّن في آيات أخرى من القرآن الكريم أيضا ... بحيث لا يدع مجالا لأنّ تستغل الآية ليسا فهمها لدى بعض الأفراد. مثل هذا التعبير كمثل قول النجار إذ يقول مثلا : إنّ قسما كبيرا من هذا الخشب وقد هيأته لكي أصنع منه أبوابا جميلة ، والقسم الآخر هو للإحراق والإضرام ... فالخشب الرائق الجيّد المناسب سأستعمله للقسم الأوّل ، وأمّا الخشب الرديء غير المناسب فسأدعه للقسم الثّاني .
ففي الحقيقة أنّ للنجار هدفين : هدفا «أصيلا» وهدفا (تبعيّا) .
فالهدف الأصيل هو صنع الأبواب والأطر الخشبيّة الجيّدة وما إلى ذلك ، وهو يبذل قصارى جهده وسعيه في هذا المضمار ...
إلّا أنّه حين يجد أنّ بعض الخشب لا ينفعه شيئا ، فسيكون مضطرا إلى نبذه ليكون حطبا للحرق والإشعال ، فهذا الهدف «تبعيّ» لا أصلي.
والفرق الوحيد بين هذا المثال وما نحن فيه ، أنّ الاختلاف بين أجزاء الخشب ليس اختيارا ، واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعمالهم أنفسهم ، وهم مختارون وإرادتهم حرّة بإزاء أعمالهم.
وخير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل النّار وصفات لأهل الجنّة في الآيات محل البحث ، التي تدل على أنّ الأعمال هي نفسها أساس هذا التقسيم ، إذ كان فريق منهم في الجنّة ، وفريق في السعير.
وتعبير آخر فإنّ الله سبحانه ـ ووفقا لصريح آيات القرآن المختلفة ـ خلق الناس جميعهم على نسق واحد طاهرين ، ووفّر لهم أسباب السعادة والتكامل ، إلّا أنّ قسما منهم اختاروا بأعمالهم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم خسرا ... وأن قسما منهم اختاروا بأعمالهم الجنّة وكان عاقبة أمرهم السعادة ... ثمّ يلخّص القرآن صفات أهل النّار في ثلاث جمل ، إذ تقول الآية : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ...) .
وقد قلنا مرارا : إنّ التعبير بـ «القلب» في مصطلح القرآن يعني الفكر والروح وقوّة العقل ، أي أنّهم بالرّغم ممّا لديهم من استعداد للتفكير ، وأنّهم ليسوا كالبهائم فاقدي الشعور والإدراك ، إلّا أنّهم في الوقت ذاته لا يفكرون في عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا السعادة .
والصفة الثّانية التي ذكرتها الآية لأهل النّار {وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها} والصفة الثّالثة الواردة في حقهم {وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ}.
لأنّ البهائم والأنعام لا تملك هذه الاستعدادات والإمكانات ، إلّا أنّهم بما لديهم من عقل سالم وعين باصرة وأذن سامعة ، بإمكانهم أن يبلغوا كل مراتب الرقي والتكامل ، إلّا أنّهم نتيجة لاتباعهم هواهم ورغبتهم ـ بكل هذه التوافه من الأمور تركوا هذه الاستعدادات جانبا ... وكان شقاؤهم كبيرا لهذا السبب : {أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ}.
فالمعين الذي يحييهم ويروي ظمأهم موجود إلى جانبهم وهم على مقربة منه ، إلّا أنّهم يتصارخون من الظمأ. وأبواب السعادة مفتحة أمامهم لكنّهم لا يلتفتون إليها.
ويتّضح ممّا ذكرناه أنفا أنّهم اختاروا بأنفسهم سبل شقائهم وهدروا النعم الكبرى «العقل والعين والأذن ...» لا أنّ الله أجبرهم على أن يكونوا من أهل النّار .
لماذا هم كالأنعام ؟
لقد شبّه القرآن الكريم الجاهلين الغافلين عديمي الشعور بالأنعام والبهائم مرارا ، إلّا أن تشبيه القرآن هؤلاء بالأنعام لعلّه بسبب انهماكهم باللذائذ والشهوات الجنسية والنوم فحسب ، فهم كالأمم التي تحلم في الوصول إلى حياة مادية مرفهة تحت شعارات برّاقة تخدع الإنسان بأنّ آخر هدف للعدالة الاجتماعية والقوانين البشرية هو الحصول على الخبز والماء ... وكما يشبهها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة قائلا : «كالبهيمة المربوطة همّها علفها ، أو المرسلة شغلها تقممها» (2) .
وبتعبير آخر : إنّ جماعة منهم تنعم بالرفاه كالأغنام المربوطة التي تدجن لتسمن ، وجماعة آخرين كالغنم السائمة الباحثة عن العلف والماء في الصحراء ، إلّا أن هدف كل منهما هو ما يشبع البطن ليس إلّا !.
وهذا الذي ذكرناه أنفا قد يصدق على شخص معين كما قد يصدق أمّة كاملة برمّتها ، فالأمم التي لا تفكر بنفسها وتتلهى بالأمور التافهة غير الصائبة ، ولا تعالج جذور شقائها ولا تطمح لأسباب الرقّي ، ليس لها آذان سامعة ولا أعين باصرة ، فهي من أهل النّار أيضا ، لا نار القيامة فحسب ، بل هي مبتلاة بنار الدنيا وشقائها كذلك .
وفي الآية التّالية إشارة إلى حال أهل الجنّة وبيان لصفاتهم ، فتبدأ الآية بدعوة الناس إلى التدبّر والتوجّه إلى أسماء الله الحسنى كمقدمة للخروج من صف أهل النّار ، فتقول : {وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها} .
والمرد من «أسماء الله الحسنى» هي صفات الله المختلفة التي هي حسنى جميعا ، فنحن نعرف أنّ الله عالم قادر رازق عادل جواد كريم رحيم ، كما أنّ له صفات أخرى حسنى من هذا القبيل أيضا.
فالمراد من دعاء الله بأسمائه الحسنى ، ليس هو ذكر هذه الألفاظ وجريانها على اللسان فحسب ، كأن نقول مثلا : يا عالم يا قادر يا أرحم الراحمين. بل ينبغي أن نتمثّل هذه الصفات في وجودنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، وأن يشع إشراق من علمه وشعاع من قدرته وجانب من رحمته الواسعة فينا وفي مجتمعنا .
وبتعبير آخر : ينبغي أن نتّصف بصفاته ونتخلّق بأخلاقه ، لنستطيع بهذا الشعاع ، شعاع العلم والقدرة والرحمة والعدل أن نخرج أنفسنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه من سلك أهل النّار ... ثمّ تحذر الآية من هذا الأمر ، وهو أن لا تحرّف أسماؤه فتقول : {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} .
والإلحاد ـ في الأصل ـ مأخوذ من مادة «اللّحد» على زنة «المهد» التي تعني الحفرة التي تقع في طرف واحد ، وعلى هذا الأساس فقد سمّيت الحفرة التي تكون في جانب القبر «لحدا» .
ثمّ أطلق هذا الاستعمال «الإلحاد» على كل عمل ينحرف عن الحدّ الوسط نحو الإفراط أو التفريط ، ولذلك فقد سمّي الشرك وعبادة الأوثان إلحادا أيضا.
والمقصود من الإلحاد في أسماء الله هو أن نحرف ألفاظها أو مفاهيمها.
بحيث نصفه بصفات لا تليق بساحته المقدسة ، كما يصفه المسيحيون بالتثليث «الله والابن وروح القدس» أو أن نطبّق صفاته على المخلوقين كما فعل ذلك المشركون وعبدة الأوثان إذ اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله فسمّوها ... اللات والعزّى ومناة ...(وغيرها) فهذه الأسماء مشتقّة من الله والعزيز والمنان «على التوالي» .
أو أنّهم حرفوا صفاته حتى شبّهوه بالمخلوقات ، أو عطلوا صفاته ، وما إلى ذلك .
أو أنّهم اكتفوا بذكر الاسم فحسب دون أن يتمثلوه ويعرفوا آثاره في أنفسهم وفي مجتمعاتهم .
وفي آخر آية من الآيات محل البحث إشارة إلى صفتين من أبرز صفات أهل الجنّة ، إذ تقول الآية : {وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} .
وفي الواقع ، إنّ لأهل الجنّة منهجين ممتازين فأفكارهم وأهدافهم ودعواتهم وثقافاتهم حقّة ، وهي في اتجاه الحق أيضا ، كما أنّ أعمالهم وخططهم وحكوماتهم قائمة على أساس الحق والحقيقة .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 573-579 .
2. نهج البلاغة ، من كتاب له و 24 رقم 45 .
 الاكثر قراءة في سورة الأعراف
الاكثر قراءة في سورة الأعراف
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











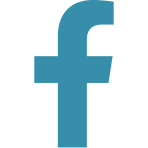

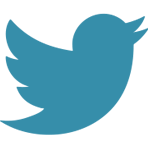

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)