شبهة حول: ((إنّ الله قد شاء أن يراهنّ سبايا)) والردّ عليها

نصّ الشبهة:
ما معنى كلمة الإمام الحسين (عليه السلام) بالنسبة إلى نسائه: شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا؟ هل فيها دلالة على الجبر وأنّ هذا الأمر كان مكتوبًا عليهنّ؟
الجواب:
في البداية نقول أنّ النصّ الوارد في اللهوف ليس فيه (على أقتاب المطايا) وإنّما بهذا المقدار (شاء الله أن يراهن سبايا) في حادثة ينقلها (1).
وهناك تعبيرات في القرآن عن المشيئة والإرادة الإلهيّة تنتهي إلى أنّ لله إرادتين ومشيئتين: تكوينيّة، وهي لا تتخلّف فإن شاء شيئًا كان من غير معالجة، وإذا أراده تحقق: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82].
ولتقريب المعنى ـ مع ملاحظة الفارق ـ نقول: إنّ الإنسان لو أراد أن يصور شيئًا في ذهنه، فلا يحتاج هذا التصوير إلّا إلى لمحة التفاتة فيحضر المعنى المصور في ذهنه فورًا، فلو أراد أن يتصور بحرًا أو شجرة أو غيرها، فإنّه لا يحتاج إلى معالجات وإعدادات وإنّما يكفي أن يتصورها ويوجّه ذهنه إليها في خلق الله للأشياء يكفي أن يريد ذلك، لكي يتحقق الموجود، ويصبح مخلوقًا خارجيًّا، وقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه المشيئة والإرادة التكوينيّة فقال: {...وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ...} [الأنعام: 112]، {...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ...} [البقرة: 20]، {...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33].
وتشريعيّة: وهي أن تتعلّق مشيئة الله بفعل العبد، فهو لا يجبر العبد عليها وإنّما يحثّه عليها تارة ويزجره عنها أخرى بأوامره ونواهيه، ولا يقسره على فعلها ولا يجبره على تركها، وإنّما يبيّن له بالرسل، ويهديه بالعقول، ويزوّده بالإرادة والاختيار لكي يختار {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 9، 10].
وهي التكاليف الشرعيّة، وقد تحدّث عنها القرآن الكريم أيضًا بلسان الإرادة الإلهيّة فقال: {...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] و{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النساء: 26] و{...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6].
وهذه الثانية تبقي للإنسان مجال الاختيار، ولا يكون مسيّرًا فيها إلى جهة برغم إرادته، وإنّما يكون في كلّ حالاته مختارًا يستطيع الاستمرار ويستطيع التراجع، ومثل هذه الإرادة قول الإمام الحسين (عليه السلام): شاء الله أن يراني قتيلاً، وشاء الله أن يراهنّ سبايا.
كيف نعرف أنّ هذه إرادة تشريعيّة لا تكوينيّة (أن يراهنّ..)؟
لمخالفة ذلك لعقيدة الاختيار التي يدين بها الإسلام ويُعرَف بها أهل البيت، هذا مع أنّها كان يمكن أن تتخلّف بتغيير الحسين (عليه السلام) رأيه، أو مسيره بينما التكوينيّة لا تتخلّف.
والشاهد عليه أنّ محمد بن الحنفيّة والذي يعرف عنه القول بالاختيار والإرادة تبعًا لما أخذه من أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) لم ينكر على الإمام مقالته.
هذا مع ملاحظة كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا سأله [أحدهم] أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ ((..وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَقَدَراً حَاتِماً وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ اَلثَّوَابُ وَاَلْعِقَابُ وَسَقَطَ اَلْوَعْدُ وَاَلْوَعِيدُ إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً وَنَهَاهُمْ تَحْذِيراً وَكَلَّفَ يَسِيراً وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً وَأَعْطَى عَلَى اَلْقَلِيلِ كَثِيراً وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَلَمْ يُرْسِلِ اَلْأَنْبِيَاءَ لَعِباً وَلَمْ يُنْزِلِ اَلْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً وَلاَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً {...ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27])).
ومعنى الكلمة: أي شاء الله أن أخرج على القوم فيحاربونني فأكون قتيلاً، وشاء أن أصحب النساء لتكميل المسيرة فيكنّ سبايا بعد قتلي، ويقومون بدورهم في تكميل الثورة. وبالفعل فقد كان لذلك السبي أكبر الأثر في بقاء الثورة الحسينيّة، وتعريف النّاس لحقيقة الحكم الأُمويّ ومخالفته لأحكام الدين، ممّا أنتج الثورات المضادّة له إلى أن سقط الحكم الجائر ذاك (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اللهوف في قتلى الطفوف، السيّد ابن طاووس، ص 39 ــ 40.
(2) من قضايا النهضة الحسينيّة (أسئلة وحوارات)، الشيخ فوزي آل سيف، ج1، ص 98 ــ 101.
1










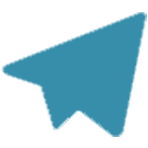
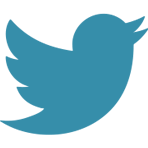



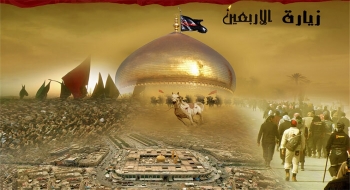




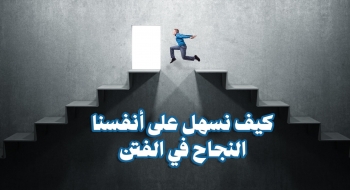







 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)


















