في رحاب الجغرافيا الجريحة: قراءة في حدود إيران
بقلم: الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
13/12/2025
في بدايات التاريخ، لم يكن مفهوم الحدود بالمعنى الحديث قائمًا أصلًا في بلاد فارس، بل كانت الجغرافيا تُصاغ تبعًا لمدى النفوذ العسكري واتساع السلطة المركزية. ولعلّ التجربة الأخمينية تمثّل النموذج الأوضح لهذا الشكل المبكر من الدولة الإمبراطورية. فقد برز الأخمينيون في منتصف القرن السادس قبل الميلاد مع صعود كورش الكبير، الرجل الذي وحد القبائل الفارسية المتناثرة تحت كيان سياسي جديد سرعان ما تمدّد ليصبح واحدة من أوسع إمبراطوريات العالم القديم. امتدت حدود ذلك الكيان من وادي السند شرقًا إلى تخوم الفرات والبحر المتوسط غربًا، ومن سهول آسيا الوسطى شمالًا إلى وادي النيل جنوبًا، واتخذت الإمبراطورية أكثر من عاصمة تبعًا لوظائفها السياسية والإدارية: برسبوليس، الواقعة أطلالها اليوم قرب شيراز جنوب إيران، كانت مركز الاحتفالات والطقوس الإمبراطورية، وسوسة، القريبة من مدينة الشوش في خوزستان، كانت مركز الحكم والإدارة، ومنها تُدار شبكة السلطة الممتدة عبر “الطريق الملكي” الذي كان شريانًا يربط الأناضول بقلب الدولة.
اعتمد الأخمينيون نظام الساترابات، وهو تقسيم إداري يمنح الأقاليم قدرًا من اللامركزية تحت إشراف ولاة محليين، فظهر جيش ضخم متعدّد الأعراق تتقدّمه نخبة “الخلوديين”، وهو الجيش المكرّس لخدمة الملك مباشرة. غير أنّ هذا التنوع، الذي منح الإمبراطورية قوةً عسكرية هائلة، كان أيضًا مصدرًا لضعفها البنيوي، إذ لم تقم على مركزية بيروقراطية صلبة بقدر ما اعتمدت على ولاءات متعددة، الأمر الذي جعل سقوطها سريعًا أمام الإسكندر المقدوني في معركتَي إسّوس وغوغميلا، لتُختتم بذلك مسيرة امتدّت قرابة قرنين، وانتهى الأمر بسقوط برسبوليس ودخول الإسكندر قلب الإمبراطورية.
ثم جاء البارثيون ليحافظوا على القدر نفسه من المرونة الحدودية، لكنهم أضافوا إلى المشهد الإيراني طبقة جديدة من التعقيد السياسي. ويقتضي فهم هذه المرحلة أولًا الإضاءة على الهيمنة السلوقية التي سبقتهم؛ تلك الهيمنة لم تكن مجرد سلطة عسكرية مفروضة على الهضبة الإيرانية، بل مشروعًا يونانيًّا لإعادة تشكيل الشرق وفق النموذج الهلنستي. فمنذ أن أسّس سلوقس الأول نيكاتور دولته بعد وفاة الإسكندر، امتد النفوذ السلوقي على إيران لأكثر من قرن، مستندًا إلى مدن محصّنة وإدارة ذات طابع يوناني واضح، ما جعل الحكم الأجنبي يبدو—لأول مرة—منظمًا وممنهجًا وليس مجرد احتلال عابر. غير أنّ السيطرة السلوقية بقيت هشّة في الأطراف، خاصة في المناطق الشرقية الواسعة، حيث حافظت القبائل—الفارسية والبلخية والبارثية—على استقلال فعلي رغم اعترافها الاسمي بالسلوقيين.
ضمن هذا السياق ظهر البارثيون، فشرعوا في انتزاع هذه المناطق بقيادة أرشاك الأول الذي وضع اللبنات الأولى لمشروع التحرر من النفوذ اليوناني، ثم أرشاك الثاني الذي ثبّت السلالة الناشئة ورسّخ استقلالها السياسي. غير أنّ التحول الحاسم جاء مع ميتريداتس الأول، المهندس الحقيقي للصعود البارثي، الذي نجح في توسيع حدود الدولة على نحو غير مسبوق، دافعًا بها نحو قمّة الاصطدام المباشر مع روما الصاعدة. ومع كل هذا الاتساع، لم تُبنَ الإمبراطورية البارثية وفق تصور مركزي صلب كالذي ميّز لاحقًا الدولة الساسانية، بل اعتمدت على شبكة واسعة من الأسر المحلية شبه المستقلة، من ملوك المدن إلى الزعامات القبلية، تمنح ولاءها للملك الأعلى مقابل الاحتفاظ بهياكلها الداخلية. وهكذا أصبحت الجغرافيا البارثية فسيفساء سياسية معقّدة: قوة عسكرية كبرى، لكنها قائمة على ولاءات متغيرة تسمح بالاتساع السريع بقدر ما تجعل الانكماش ممكنًا عند أول اضطراب.
وقد خاض البارثيون سبعة حروب كبرى مع الرومان، كانت كل واحدة منها بمثابة إعادة رسم مؤقتة للخارطة السياسية في غرب آسيا. بدأت هذه المواجهات منذ القرن الأول قبل الميلاد مع الاشتباكات التي أعقبت توسع روما شرق الأناضول، وتواصلت على مدى قرنين في سلسلة حملات متبادلة: من حملات ماركوس أنطونيوس الفاشلة، إلى تقدّم تراجان نحو طيسفون، العاصمة البارثية الواقعة اليوم في منطقة سلمان باك جنوب بغداد، ثم محاولات سيبتيموس سيفيروس لتثبيت وجود دائم في ميزوبوتاميا، أي الأرض الفاصلة بين دجلة والفرات والتي تمثل اليوم معظم العراق وامتدادات من شرق سوريا وشمال تركيا. ومع ذلك بقيت كل هذه الانتصارات مؤقتة، لأن البنية اللامركزية للدولة البارثية كانت تسمح لها بالانكفاء سريعًا ثم إعادة تجميع القوة. وتبقى معركة حرّان عام 53 قبل الميلاد العلامة الأبرز في هذا الصراع الطويل؛ ففي عهد الملك أورودس الثاني، وبقيادة القائد الأسطوري سورينا، ألحق البارثيون بروما واحدةً من أكبر هزائمها، قُتل فيها ما يقرب من 20 ألف جندي روماني، وأُسر نحو 10 آلاف، وتحولت حملة كراسوس من مشروع توسع إلى درس قاسٍ في حدود القوة الإمبراطورية. ومنذ ذلك اليوم أصبح اسم البارثيين مقرونًا بفكرة أنّ القوة العسكرية لا تنتج حدودًا ثابتة، بل معارك متجددة تُخاض على الأطراف.
ومع ذلك لم يتحول هذا النصر الهائل إلى تثبيت حدود مستقرة، لأن النظام البارثي نفسه لم يكن قائمًا على فكرة الترسيم النهائي، بل على تحالفات تتبدل مع قوة المركز وضعفه. بل إن الدولة شهدت فترات تغلب فيها ملكان في الوقت ذاته، كما في صراع فردادس الثالث وميتريداتس الثاني، في واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا. وبرغم امتداد دولتهم لأكثر من أربعة قرون، لم يطور البارثيون منظومة إدارية تضبط التخوم، بل جعلوا المناطق الحدودية طبقة عازلة ضد القوى الكبرى، ولهذا ظلّت حدودهم الشمالية الغربية عرضة لاختراق الجيوش الرومانية التي دخلت طيسفون أكثر من مرة دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة، لأنها لم تُبن أصلًا على نموذج يجعل العاصمة مركزًا عضويًا للدولة، بل مركزًا رمزيًا لسلطة تتوزع على شبكة واسعة من الولاءات. بهذا المعنى، ورث الساسانيون فضاءً جغرافيًا واسعًا لكنه غير مستقر، وتاريخًا طويلًا من صراع حدودي لا يعرف الخطوط النهائية، بل موازين قوة مؤقتة تُعاد صياغتها مع كل تغيّر في مركز الثقل العسكري.
وعندما ظهر الساسانيون بقيادة أردشير الأول في بدايات القرن الثالث الميلادي، أعادوا بناء الدولة على أسس مركزية صارمة. ثم جاء سابور الأول ليمنح السلالة مكانتها الإمبراطورية بعد انتصاراته على الرومان، وصولًا إلى كسرى الأول أنوشروان، ذروة النضج الإداري والعسكري، ووريثه هرمز الرابع وكسرى الثاني برويز اللذين دَفَعا الصراع مع البيزنطيين إلى حدوده القصوى. هؤلاء الملوك، بتدرّج قوتهم وتفاوت مشاريعهم، شكّلوا عمود البناء الساساني الذي جمع بين المركزية البيروقراطية وصلابة العقيدة الحدودية.
وبينما أسس الساسانيون دولة أكثر تنظيمًا، فإن الحروب المستمرة استنزفت قدراتهم حتى دخلوا القرن السابع وهم مثقَلون بالأزمات، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن الصمود أمام موجة الفتح الإسلامي القادمة من جنوب العراق. ففي معركة القادسية (636م) قُتل ما بين 8 آلاف و20 ألفًا من جنودهم، ثم جاءت معركة نهاوند (642م) لتسقط نحو 15 ألفًا منهم، وتتلوها سقوط المدائن، وينهار آخر شكل من أشكال “الإمبراطورية الفارسية الكبرى”. ومن تلك اللحظة بدأت أولى مراحل الانكماش الجغرافي، ودخل الإيرانيون عالمًا سياسيًا جديدًا بوصفهم جزءًا من الخلافة الإسلامية لا قطبًا إمبراطوريًا مستقلاً.
ومع ظهور الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر، دخلت إيران طورًا جديدًا أعاد اسمها السياسي إلى الواجهة، لكن هذه العودة لم تكن قوميةً بالمعنى الحديث، بل كانت مشروطة بظهور إطار مذهبي متماسك شكّل هوية الدولة وأداة صراعها مع القوى المحيطة. وقد أسس الشاه إسماعيل الصفوي هذه الدولة بعدما وحّد القبائل التركمانية القزلباش تحت راية عقائدية صلبة، وجعل من تبريز عاصمته الأولى قبل أن تنتقل العاصمة لاحقًا إلى قزوين ثم إلى أصفهان في عهد الشاه عباس الكبير، الذي يُعد أحد أبرز ملوك الدولة وأشدّهم تأثيرًا في تشكيل معالمها العسكرية والإدارية. وعلى امتداد قرنين تعاقب على الدولة الصفوية ملوك تفاوتت قوتهم بين إسماعيل المؤسس، الذي جمع بين الرمزية الدينية والحضور العسكري، وعباس الكبير الذي أعاد بناء هيكل الدولة وابتكر جيش الغِلْمان، وصولًا إلى ملوك أواخر العهد الذين أنهكتهم التمردات والغزوات الأفغانية.
كانت العلاقات مع العثمانيين المجال الأبرز الذي تجلّت فيه حدود القوة الصفوية وحدودها الجغرافية في آنٍ معًا؛ فالصراع بين الدولتين لم يكن مجرد تنافسٍ على الأراضي، بل مواجهة بين مشروعين مذهبيين وسياسيين يتنازعان إرث العالم الإسلامي. وفي معركة جالديران عام 1514 واجه الصفويون اختبارًا مفصليًا خسروا فيه نحو عشرة آلاف مقاتل في يوم واحد، وتكشّف ضعف بنيتهم القتالية القائمة على الحماسة العقائدية والولاء القبلي أمام الجيش الإنكشاري العثماني المدعوم بالمدفعية الحديثة. وكان سقوط تبريز بعد المعركة مباشرة إشارةً واضحة إلى أنّ الدولة الصفوية، رغم اتساعها وعمق خطابها الديني، لم تكن تمتلك بعدُ منظومةً عسكرية مركزية قادرة على حماية الأطراف وتثبيت الحدود.
ومع أنّ الصفويين استعادوا مناطق واسعة لاحقًا في عهد الشاه طهماسب الأول ثم في عهد الشاه عباس الكبير—الذي أعاد تنظيم الجيش ونجح في صدّ التمدد العثماني واستعادة بغداد لفترة—إلا أنّ الحروب الطويلة استنزفت طاقاتهم البشرية والاقتصادية، وتراوحت خسائر الطرفين في سلسلة الحملات الممتدة بين القرنين السادس عشر والسابع عشر بين عشرات الآلاف، بينما كانت المدن الحدودية مثل تبريز وأردبيل وديار بكر تتغير سيادتها تبعًا لموازين القوة.
أما الذروة السياسية للصراع فجاءت مع معاهدة زهاب عام 1639 في عهد الشاه صفي الأول، التي أنهت عمليًا قرنًا ونصفًا من القتال المتواصل، ورسمت للمرة الأولى حدودًا واضحة نسبيًا بين الدولتين، خصوصًا في مناطق كردستان والعراق. وقد أصبحت هذه الخطوط—التي اعترفت بسيادة العثمانيين على بغداد ومعظم العراق، وبسيادة الصفويين على ما يُعرف اليوم بغرب إيران—الأساس الأول لما سيُعرف لاحقًا بحدود الدولة الإيرانية الحديثة. ومع هذه المعاهدة بدأ المفهوم الجغرافي لإيران يكتسب صفةً سياسية أكثر استقرارًا بعد قرون من التمدد والانكماش اللذين حكمتهما القوة العسكرية لا فكرة الحدود الثابتة.
لكن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانا الأكثر قسوة على إيران؛ فقد دخلت الدولة القاجارية، التي أسسها آغا محمد خان القاجار في أواخر القرن الثامن عشر، مرحلةً حرجة اتسمت بالصراعات الخارجية والهزائم الكبرى. حاول القاجاريون استعادة وحدة الأراضي الإيرانية وإرساء مركزية السلطة بعد قرون من الانقسامات، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بين قوتين صاعدتين: روسيا القيصرية من الشمال، المتوسعة نحو القوقاز والبحر الأسود، وبريطانيا من الجنوب، التي رأت في الخليج والهند مناطق حيوية لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
بدأت المواجهة مع روسيا في الحرب الروسية–الفارسية الأولى (1804–1813)، حيث حاول القاجاريون صدّ التمدد الروسي في القوقاز، لكنها كانت مواجهة غير متكافئة؛ إذ امتلك الروس جيشًا نظاميًا أكبر ومدفعية أكثر تطورًا، بينما اعتمد الإيرانيون على جيش تقليدي متعدد الولاءات. وتشير التقديرات إلى أنّ إيران فقدت خلال الحربين أكثر من أربعين ألف مقاتل، فضلًا عن تدمير المدن والقرى ونزوح عشرات الآلاف من سكان القوقاز. وأدت الهزائم إلى سقوط كامل القوقاز تحت السيطرة الروسية، بما في ذلك أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وداغستان—وهو فقدان لم يكن مجرد تغيّر في الخريطة، بل صدمة رمزية وسياسية عميقة.
انتهت الحرب الأولى بمعاهدة كلستان عام 1813، التي ثبتت السيطرة الروسية على معظم أراضي القوقاز. ثم تكررت الهزيمة في الحرب الثانية (1826–1828)، التي انتهت بمعاهدة تركمان جاي، لتكتمل بذلك خسارة القوقاز نهائيًا. ولم تكن هاتان المعاهدتان مجرد اتفاقيات رسمية، بل كانتا إعلانًا صريحًا عن خروج إيران من المسرح القوقازي، وترسيخ عقدةٍ جغرافية وسياسية ستلازم الوعي القومي الإيراني لعقود، وتغذي خطابًا دائمًا عن "الأرض المسلوبة" والرغبة في استعادة مكانة ضائعة.
وكان لهذه الهزائم أثر بشري واجتماعي كبير؛ إذ انهارت هياكل السلطة المحلية، وتضاعفت أعباء اللاجئين، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية نتيجة تدمير البنى التحتية. كما خلفت أثرًا نفسيًا طويل المدى، شكّل نواة "عقدة الحماية الشمالية" التي ستعيد إنتاج نفسها لاحقًا مع كل مواجهة سياسية أو عسكرية مع القوى الدولية.
وفي الشرق، وجدت إيران نفسها عاجزةً عن مواجهة طموحات الإمبراطورية البريطانية في جنوب آسيا؛ فبريطانيا كانت تعتبر الهند "جوهرة التاج" وتعدّ أي نفوذ إيراني في هراة تهديدًا مباشرًا لمصالحها. وقد دفعها هذا إلى التدخل العسكري المباشر، فاندلعت الحرب الأنغلو–فارسية (1856–1857) التي تكبّد فيها الإيرانيون نحو خمسة آلاف قتيل وجريح، فضلًا عن أضرار واسعة في المدن والقرى الحدودية. وانتهت الحرب بمعاهدة باريس التي أكدت فصل هراة نهائيًا عن النفوذ الإيراني، مثبتةً بذلك حدود الشرق وفق إرادة لندن لا طهران.
ثم جاءت اتفاقية 1907 بين روسيا وبريطانيا لتقسيم إيران إلى ثلاث مناطق نفوذ—شمال روسي، جنوب بريطاني، ووسط محايد—محوِّلةً الدولة إلى كيان قائم بالاسم فقط، مع تقييد شبه كامل لقراراتها الاستراتيجية. وقد انعكس ذلك على الاقتصاد والسياسة الإيرانية، حيث أصبحت الموارد الطبيعية—بما فيها النفط المكتشف لاحقًا في الأهواز—خاضعةً لتفاهمات القوى الكبرى، فيما بقي الشعب الإيراني بعيدًا عن أي سلطة فعلية في إدارة وطنه.
ومع صعود رضا شاه بهلوي إلى السلطة عام 1925 ينبغي فهم أنّ وصوله لم يكن حدثًا معزولًا، بل نتيجة مسار طويل تشكلت ملامحه منذ اتفاقية 1907. فبعد انهيار روسيا القيصرية عام 1917 أصبحت إيران بلا قوة موازنة، ما أفسح المجال لبريطانيا كي تبحث عن رجل قوي يعيد الاستقرار ويضمن مصالحها، خصوصًا في ما يتعلق بخطوط النفط في عبادان. وظهر رضا خان—قائد لواء القوزاق—بوصفه الشخصية العسكرية القادرة على الإمساك بزمام الأمور. وكان انقلاب 1921 بدعم بريطاني غير مباشر الخطوة الأولى، ثم جاء تتويجه ملكًا عام 1925 بعد إقصاء القاجاريين ليكمل بناء مشروع دولة مركزية قوية.
لم يكن رضا شاه صنيعة كاملة لبريطانيا، لكنه لم يكن ليصل إلى العرش لولا مباركتها، ولا ضمن بيئة سياسية صاغتها اتفاقية 1907. وعندما اعتلى السلطة وجد نفسه أمام مهمة تاريخية مزدوجة: إعادة بناء الدولة الإيرانية بعد قرون من الانكماش والهزائم، وصياغة هوية وطنية حديثة. فاستعاد ألق الإمبراطوريات القديمة، وتبنى لقب "ملك الملوك"، في إشارة إلى مشروع يستعيد الماضي الإمبراطوري ويحوّله إلى هوية قومية معاصرة. ولم يكن هذا مجرد لقب، بل تعويض رمزي عن جراح الجغرافيا، ورد على قرون من الخسائر التي مزقت إيران في الشمال والشرق والغرب.
وسعى رضا شاه إلى تحديث الجيش والإدارة والتعليم والقضاء، متجاوزًا هشاشة الدولة القاجارية، لكن العقدة التاريخية المتعلقة بفقدان القوقاز وشرق إيران ظلت حاضرة، فتبنّى خطاب "إيران الكبرى" الذي لم يكن مجرد استعادة جغرافية، بل محاولة لرسم هوية قومية تستند إلى ماضٍ إمبراطوري، مستلهمة من تجربة الأخمينيين والساسانيين والصفويين، ومواجهة تاريخ طويل من ضياع الأراضي أمام القوى الخارجية.
وجاءت الثورة الإسلامية عام 1979 بمثابة انفجار للداخل على الخارج، وصراع مع الإرث البهلوي بقدر ما هو صراع مع القوى الدولية. لم تغيّر الثورة الحدود، لكنها غيّرت معناها السياسي؛ فقد ورثت الجمهورية الإسلامية حدودًا رسمتها عواصم أخرى—في سانت بطرسبورغ وباريس ولندن—وجغرافيا أقرب إلى سجلٍ من الانكسارات منها إلى سجل انتصارات، ودولة تبحث عن حضور إقليمي لأن الداخل لا يمنحها شرعية رمزية كافية.
ومن هنا يمكن قراءة السلوك السياسي–العسكري لإيران اليوم باعتباره محاولةً لإنتاج "عمق استراتيجي" يعوّض المساحات التي فقدتها عبر القرون. فالدولة التي خسرت القوقاز وخراسان وهراة وجورجيا وداغستان لا تقبل بسهولة أن تبقى رهينة حدود فرضها الآخرون. ثم جاءت الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988) لتضيف طبقة جديدة من الجرح التاريخي؛ فقد شكّلت أول مواجهة كبرى بعد الثورة، وأظهرت هشاشة الحدود الحديثة وعقدة الدفاع عن السيادة. ورغم أن العراق بدفع من أمريكا هو من بادر بالهجوم مستغلًا الفوضى الإيرانية، فإن انسحابه بعد عام معلنًا استعداده لأي حل لوقف النزاع أتاح لإيران فرصة إنهاء الحرب، لكنها رفضت، وكان هذا خطأ استراتيجي فسره المراقبون على أنه رغبة في استعادة الهيبة الإقليمية وروح الثأر التاريخي والخطاب الثوري الساعي إلى الأمن خارج الحدود.
هذا الخطأ أدى إلى أن الحرب خلفت نحو 300 ألف قتيل وأكثر من نصف مليون جريح، فضلًا عن 40 ألف أسير، وتدمير مدن وقرى ونزوح عشرات الآلاف، دون أن يحقق أي طرف مكسبًا جغرافيًا ملموسًا. وتحولت الحرب إلى رمز للدمار حين تصبح الحدود ساحة صراع، وأنتجت عقيدةً أمنية جديدة في إيران مفادها أنّ "الدفاع عن إيران يبدأ خارج حدودها"، وهي عقيدة ما زالت تفسّر سياساتها الإقليمية في العقود اللاحقة.

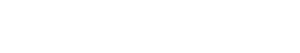




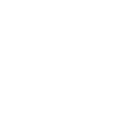














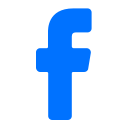

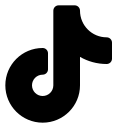








.png) وائل الوائلي
وائل الوائلي .png) منذ ساعتين
منذ ساعتين 











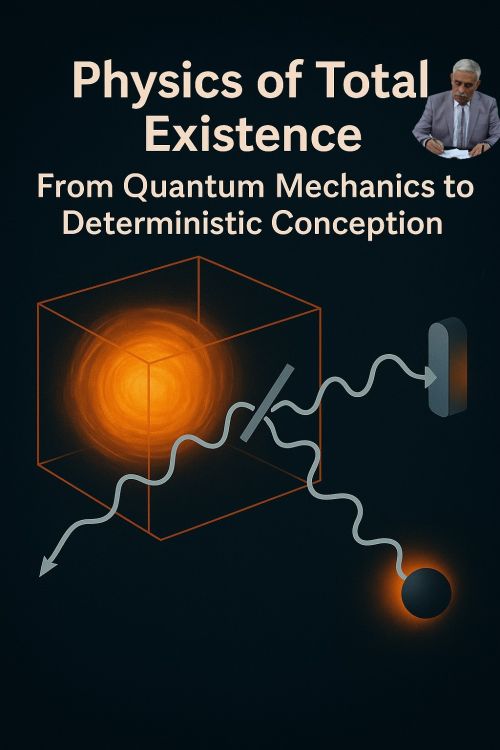



 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) EN
EN