

 الاستعارة والتمثيل الحِجاجي في خُطبِ المرجعيةِ الدينية العليا خُطبُ 2017 أنموذجا
الاستعارة والتمثيل الحِجاجي في خُطبِ المرجعيةِ الدينية العليا خُطبُ 2017 أنموذجا
الاستعارة والتمثيل الحِجاجي في خُطبِ المرجعيةِ الدينية العليا
خُطبُ 2017 أنموذجا
*أ هاله صادق عباس البدراوي ـ كلية الآداب / جامعة واسط
أ.م.د. محمد رضا عبد الستار الأوسي ـ كلية الآداب / جامعة واسط
خلاصة البحث:
الاستعارة والتمثيل من التقنيات البلاغية المهمة التي يستعملها الخطيب لغرض تحقيق الأهداف الحِجاجية، فالاستعارة لها أهمية في عملية تصوير الأشياء ولا يمكن إدراك العالم إلاّ من خلالها فكان تأثيرها من حيث أهميتها شبيهاً بدور الحواس، أمّا التمثيل فهو يربط بين صورتين من اجل ان يصل الخطيب إلى بيان حججه لإقناع المتلقي والتأثير فيه. لذا تناول البحث التقنيات البلاغية المتضمنة) الاستعارة والتمثيل الحِجاجي (في خُطب المرجعيةِ الدينية العليا 2017، واختتمت البحث بخاتمة أتيتُ فيها على أهم النتائج، وبعدها ثبت المصادر والمراجع التي اعتمدتُ عليها في هذا البحث.
المقدمة:
لقد حازت الاستعارة في العهود الأخيرة على مساحة كبيرة من اهتمام الباحثين على اختلافهم، وأصبح التصنيف فيها يشْغَلُ مكاناً واسعاً من رفوف المكتبات العالمية؛ كونها لم تَعدْ تقتصر على مجال الأدب والبلاغة، بل أصبحتْ مهمةً من قبل علماء النفس , وعلماء الاجتماع, والمناطقة ,والتشكيليّين, والسينمائيّين, ومؤرّخي الفلسفة؛ لأنّ الاستعارة تمثل الجزء المهم من البنية التصويرية للإنسان , إذ عن طريقها يدرك الفرد العالم, وينسجم معه ) ينظر: لحويدق, 2015: ص (5), بوصفها تشبيهاً حُذِفَ أحدُ طرفيه (القزويني, 2003 : ص 237) فالاستعارة تتمثل في أنّها احدى الآليات اللغوية التي يستعملها المخاطب والتي يعتمدها بشكل واسع للوصول إلى الغايات الحِجاجية , ما دمنا نؤمن بفرضية الطابع المجازي للغة الطبيعية ضمن المجال اللساني ( ينظر: العزاوي, 2006 : ص 105) والاستعارة في جوهرها هي نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره من أجل غرض, وهذا الغرض إمّا أن يكون شرحَ المعنى وفصلَ الإبانة عنه , أو التأكيد عليه والمبالغة فيه, أو الإشارة إليه بلفظ قليل ( ينظر: العسكري، 1986 : ص 268 ) وهي ((ضربٌ من التشبيه , ونمطٌ من التمثيل , والتشبيه قياس والقياس يجري فيما تعيهِ القلوب , وتُدركه العقول, وتُستفتَى فيه الأفهامُ والأذهانُ لا الأسماع والآذان)) (الجرجاني, د ت: ص 121).
أمّا التمثيل فهو أحد الآليات البلاغية التي يعتمد عليها الخطيبُ للتأثير في المتلقي , فهو متنوع ومركب ويحتاج إلى تأويل أطرافه ؛ كونه يعبّر عن تشبيه مجموعة من الأشياء التي تعتمد بعضها على بعض , وتوقف عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ ) على بلاغة التمثيل إذ قال: (فيكون عن طريق المشاهدة التي تؤثرُ في النفوسِ مع العلمِ بصدقِ الخبرِ, وتكون قريبة إلى ذهن المتلقي بحيث لا يوجد مجال للإنكار, ولأنَّ العلم المستفاد عن طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة , يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام كما قالوا: ليس الخبر كالمعاينة ,ولا الظن كاليقين ,وبلوغ الثقة فيه غاية التمام)) (الجرجاني, د ت: ص 20).
• الاستعارة : تُعدُّ الاستعارة وسيلة تواصلية في النص؛ لأنّها تنسجم مع الآخر وترتبط به وتناغيه, فهنالك خطابٌ لا يكون مؤثراً إلاّ بوجود الاستعارة, ولا سيما أنّ الاستعارة تعدُ من أهم مميزات الخطاب في اللغات بشكل عام والخطاب الحِجاجي بشكل خاص , فالاستعارة ليست مادة للتزيين والزخرفة فقط , بل أداة أو آلية من آليات الحِجاج والاقناع والاستمالة (صادق, 2015 : ص 177) ,إذ ليست الاستعارة مجرد مجاز يحيل الى فضاء تخييلي في اللغة , بل هي عملية استبدال وتغيير داخل الوعي نفسه , لارتكازها على ثلاثة مستويات : الأول استدلال شبيه يتضمن على مثال يحتذى به من أجل فهم الفكرة واستيعابها والتأثير به , والثاني سلطة قاهرة في نبوءة الفعل وعلامة نجاحه , والثالث شكلٌ أسلوبيٌّ يحتوي على فهم وإيضاح ؛ لأنّ ما يُفْهَمُ من لغز الاستعارة والتباس الألفاظ المتكونة منها يكون أوسع رسوخاً في استيعاب السلوك العادي للغة, إذ إنّ للاستعارة القدرة على تحقيق التماسك بين الحقيقة وسلوك اللغة من جهة وبين سلوك اللغة وفطرة الاستيعاب من جهة أخرى ( ينظر: ناصر, 2009 : ص 160 ), فالاستعارة الحقيقية وصِفَتْ بالاستعارة العمودية والصاعدة والمتعالية, أي إنّ الاستعارة تدمج في استعمال اللغة الفلسفية , بقليل من استعمال اللغة الطبيعية في الخطاب الفلسفي؛ لأنّ اللغة الطبيعية تُعدُّ لغة فلسفة ( ينظر: زيناتي, 2016 : ص 447) ,ولا بُدّ من بيان أنّ الاستعارة الحِجاجية غير الاستعارة البديعيّة ويعدّ النوع الأول الأسرع انتشاراً وتأثيراً؛ لكونها مرتبطة بالمتكلّمين وتدخل ضمن السياق التواصلي التي يستعملها المتكلّم عند توجيه خطابه وإحداث التأثير, فهي تكون موجودة في اللغة اليومية وفي الكتابات الأدبيّة والسياسيّة والعلميّة بهدف إقناع المتلقي, وأمّا النوع الثاني: هي الاستعارة البديعيّة فهي لا ترتبط بشيء , وإنما مرتبطة بذاتها , وهي لا تدخل ضمن السياق التواصلي والتخاطبي , فالسياق سياق لفظي (ينظر: العزاوي, 2006 : ص 108 – 109), فالاستعارة عندما تتسع يكون لها دور تأثيرٌ في الخطاب مع زيادة درجة التأثير في المتلقي ؛ لعمق الخيال الناتج عنها ,. وتساعد النص على إعادة بناء نفسه , و تمثل دور الوسيط اللغوي في نقل فكرة المؤلف إلى القارئ ( ينظر: ابو زيد, 2005 : ص 20 ) , فلها مكانة خاصة (( في تحليل الخطاب, ولاسيما الخطاب الحِجاجي ؛ كونها آلية حِجاجية تساعد في بناء القول الحِجاجي من مختلف النواحي الحِجاجية كالاستدلال والتأثير والإقناع )) (عشير, 2006 : ص 112 ) , إذ تقوم الاستعارة (( من خلال انزياحات اللغة التي تنشئها , ببناء تصورات مكملة أو جديدة تماماً , وتُعيدُ توجيه الفكر إلى طريق فيه معانٍ لا توفرها القواعد العادية لنشاط اللغة )) ( ناصر, 2009 : ص 154 ), والغاية من ذلك (( إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي عن طريق استعارة كلمة من شيء معروف إلى شيءٍ غير معرف بها)) (الزركشي 1988 : ص 433 ) , لأنّها تكون من الوسائل اللغوية التي تكون غير الكلام الاعتيادي أو لغة داخل لغة كما يرى بول فاليري ( عبد اللطيف, 1990 : ص 6 ) , وإنّ الحِجاج عن طريق الاستعارة موجود في العلوم الإنسانية وكذلك في العلوم الصرفة , والتي يستعان بها في الفرضيات , لكي تثبت دليلاً وتعمل على إقناع المتلقي بالنظرية الصحيحة أو قانون يعتمد إليه, ويكون ذلك عن طريق الاستبدال , فعن طريق الاستبدال تشتغل الاستعارة حِجاجياً لكونها حركةَ يتُمّ عن طريقها البيان , وبالنتيجة تنمحي الحالة التي يكون فيها المتكلم عاجزاً عن أداء مقصده ويحيل ذلك بمكان يوجد فيه ذلك المقصد وإلى حين تحققها يكون قد أقنع وأفهم (ينظر: صادق, 2015 : ص 181 ) ، وقد كان (عبد القاهر الجرجاني) رائداً في علوم البلاغة العربية لتوضيح مكانة الاستعارة , من خلال فكره الغزير في البلاغة والنحو الذي نضج وبلور مفهوم الاستعارة وأبرز قيمتها , إذ عدّها من ضمن المعاني , أما البقية فقد عدّوها فناً بديعياً , وتناول الجرجاني الاستعارة في ظلّ نظرية النظم، التي برهن فيها فضل المعنى على اللفظ , وجعل في المعاني لا في الألفاظ أيّ في إطار نظمها و سياقها ( ينظر: يحي, 2017 : ص 5) ,وأوضح أنّ (( الاستعارة في الجملة يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدلُ الشواهد على أنه اختصَّ به حين وضع , ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم , فيكون هناك كالعارِيَّة )) ( الجرجاني, د ت: ص 22 ) , وقد بيّن (الجرجاني) وظائف الاستعارة , ومنها الإدعاء , الذي يريد به حركةً في المعاني والدلالات لا تحريك الألفاظ, بل يبقى مستقلاً فهو ادعاء , يقوم على إبدال أحد الأطراف بطرف آخر ليقوم بعمله, وهي ليست وسيلة زخرفية للألفاظ فقط بل هي إحدى آليات الإقناع ( ينظر: أبو زيد, 1991: ص 50 ) ,فعندما نقول: (رأيت أسداً) هنا أُستعير لفظ (الأسد) لرجل شجاع في بأسه وقوته , وقصد المتكلم هنا الشجاعة , والمتلقي عندما يعقل هذا المعنى فإنّه لم يفهمه من لفظ الأسد بل من معناه الضمني , أي شدة مشابهته ومساواته بشجاعة الأسد عن طريق توظيف الاستعارة التي هي إحدى طرق الاثبات وعمادها الإدعاء ( الجرجاني, 1992 : ص 71 ), ولعل هذه الفكرة رَتب عليها (الجرجاني) بأنّ الاستعارة ((مجاز أو عمل عقلي)) ( ضيف, 1992 : ص 193) , ولا يمكن لها أنْ تقوم بعملية التأثير في المتلقي واثارة الانفعال بدون عنصر الملاءمة فاللفظ المستعار يجب أن يكون ملائماً للمستعار له ولا يكون ذلك إلاّ إذا تمَ الانسجام التام بين اللفظ والمعنى من جهة , وبين الجوِّ النفسي للمتلقي من جهة أخرى ( ينظر: ناجي, 1984 : ص 221 – 222) ,وهي تؤثر في المتلقي بإقناعه والقبول باستعمال آليات الخطاب . لذا فإنّ الاستعارة من الوسائل الحِجاجيّة المهمة التي أولتها الدراسات القديمة والحديثة اهتمامها؛ لما لها من مقدرة على عمليّة رفع درجة إقناع المتلقي والتأثير فيه وتحريك مشاعره واستمالته بشأن القضيّة المطروحة. وتأسيساً على ما تقدّم وَظّفَتْ المرجعيةُ الدينيةُ الاستعارة الحِجاجية في موضوع التحذير من تأثير التفكك الأسري في المجتمع، فالأسرةُ تعدُ البنية الأساس الأولى والمهمة في تنشئة الفرد ابتداءً من مرحلة الطفولة إلى بقيّة مراحل حياته , وهي المسؤولة الرئيسة في تربية الأولاد تربية صحيحة وسليمة مبنية على أساس الاحترام والحب والتعاون , ولها أهمية مهمة في تكوين المجتمع , إذ إنّ قوة المجتمع وضعفهِ تقاس على قوة الأسرة وضعفها , ولأهمية موضوع بناء الأسرة الصالحة القوية والحفاظ عليها من التفكك, الأمر الذي حمل المرجعية الدينية العليا إلى توظيف حجاجية الاستعارة لإقناع المخاطبين بالموضوع , إذْ شَبّه الخطيبُ الأسرة بالآلة التي تتشكل من أجزاء وعملها مشروط بترابطها, وعطلها مرهون بتفكك أجزائها, ومن أمثلة ذلك ((أصبحت المنظومة الأسرية تتفكك شيئا فشيئا )) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 58 ) , أيْ إنّ الُمشَبَّه موجود وهو (الأسرة) والمشبه به محذوف وهو (الآلة) ولكن أبقى على شيء من لوازمه وهو(التفكك) , وإذا لم تكن الأسرة متلاحمة ومتماسكة وقوية لا يمكن أنْ تكون عاملة في بناء مجتمع ناضج ومنتج . لذا يُعدّ التفكك الأسريّ من المشاكل الخطيرة التي تواجه النظام الأسري وتؤدي إلى انهيار وهدم المنظومة الأسرية وهدمها بالكامل. كما وَظَّفتْ خطبُ المرجعيةُ الدينية الاستعارة الحِجاجية لإقناع المخاطبين بالموضوع وهو وجوب الكفّ عن التمادي في الضلالة والرجوع إلى الرشاد والهداية واتباع الحق المتمثل بطريق الله المستقيم ودحض الباطل , فالحقُ طرُقهُ واضحةٌ كالنهار ,أمّا الباطل فطرقُهُ مظلمةٌ كالليل, والقرآن الكريم هو المنهاج الكامل والنور الهادي الى الحق، والله سبحانه وتعالى يحتجُّ به علينا يوم القيامة, كما موضح في الخُطبة ((القرآن يصرخُ فينا يوميّا إلى أنّ نرحلَ من الدنيا ولا يقول قائل: إنّي لم أعلم (الحقّ من ربّكم) ومعايير الحقّ واضحةٌ وطرقُ الحقّ واضحةٌ، لا يقول قائل: إنّني لم أعلمْ إنّني لا أفهم، يُقال له: لِمَ لَمْ تتعلّم؟!! كما في مضمون بعض الروايات، فلا حجّة لنا أمام الله تعالى بل الله هو الذي يحتجّ علينا)) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 162 ) , فاستعار الخطيبُ لفظة (الصراخ) بمعنى الصوتُ المرتفعُ والصياحُ الشديدُ للإنسانِ وأسنده إلى القرآن الكريم , لأنّه شبّه القرآن بإنسان يصرخ ثُمّ حذف المشبّه به وأبقى على لازم من لوازم (الصراخ) على سبيل الاستعارة المكنية , فلولا غفلة المخاطبين الشديدة وابتعادهم عن طرق الحق والهداية والرشاد لما كانت هناك حاجة لإيقاظهم بالصوت الشديد من غفلتهم التي كانوا عليها وتنبيههم على تردي أحوالهم , ولكان الصوت المنخفضُ والنداء الهادئ كافياً للفت أنظارهم وضمان استجابتهم , وبهذا أنجزتْ الاستعارة أغراضاً عدة؛ فهي مَثَّلَتْ حالة المخاطبين وأشّرَتْ مستوى غفلتهم وأوصَت ضِمناً أنّ القرآن الكريم ما فتئ يوجه النداءات تلو النداءات محذراً ايانا من سوء المنقلب والعاقبة بقرائن أحوالنا وعلاماتها ,والمفارقة أنّ الإنسان لم يلتفت إلى هذه النداءات التي ترجمت نبراتها حرص صاحبها على نجاته وخلاصه , وَظلّ لاهياً غافلاً ساهياً سادراً في غيّهِ وضلالِهِ ؛ الأمر الذي جعل مستوى النداء يتناسب طردياً مع مستوى الغفلة . وفي خُطبة أخرى بدأ الخطيب بتوجيه الشكر والعرفان للمقاتلين بجميع صنوفهم لما بذلوه من التضحيات الكبيرة في الدفاع عن أرض العراق ومقدساته في قتالهم ضِدَّ دا. عش الإر. هابي , فوظَّفَتْ المرجعيةُ الدينيةُ العليا الاستعارة الحِجاجية فيها من خلال وصف الإر. هاب الداع. شي بلفظة (رجس) بمعنى الشيء القذر كما جاء في النص (( نتوجّه بالشكر والتقدير والإجلال والتعظيم لأعزّتنا المقاتلين في قوّات مكافحة الإر. هاب ولواء الردّ السريع والجيش بمختلف صنوفه، والشرطة الاتّحادية وحشود المتطوّعين الأبطال بمختلف مسمّياتهم، على ما قدّموه من تضحياتٍ كبيرة وبذلوه من دماءٍ طاهرة وقاموا به من صولات وطنيّة عظيمة لحماية العراق وتخليصه من رجس الإر. هاب الدا. عشيّ )) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 371 ) , فالاستعارة هنا مكنية إذْ حذف منها المشبه به وهي القذارة مع ذكر المشبه وهم الدو. اعش مع الإبقاء على شيء يدل عليه وهي (رجس) , وقد ذكرت هذه اللفظة في القران الكريم في الآية المباركة : {يَأيَّها الذين امَنوا إنمَّا الخمرُ والميسرُ والانصابُ والأزلام رجسُ مِنْ عَمَلِ الشيطانِ فاجتنبوهُ لعلكُمْ تُفلحُونَ }
فالله سبحانه وتعالى يبين أنّ الذي يشربُ الخمرَ ويعبدُ الأنصاب والاستقسام بالأزلام رجسٌ أي خبيث من عمل الشيطان، ولما يأمر به الشيطان فيها من الفساد، فيأمر بشرب المسكر ليزيل العقل، ويأمر بالقمار لأجل الاخلاق الدنيئة، وعبادة الأصنام بوصفها شرك بالله, ويأمر بالأزلام لما فيها من ضعف الرأي , ويحذرُ من عمل الشيطان والابتعاد عنه من أجل الفوز بالثواب , ففي الآية دلالة على تحريم الخمر، وقد وصف الله لها أربعة أوجه وهذه الاوجه التي وصفها هي: النجس وهو محرم, ونسبها إلى عمل الشيطان فهو محرم أيضاً, وأمر باجتنابها فهو واجب, وجعل الفوز والنجاح في اجتنابها (الطبرسي, 2005 : ص 336 ).
ويستوقفنا مثال آخر وُظَّفَ ضِمنَ الاستعارة ,كما جاء في الخُطبة ((وهذا المشروع فيه أبعاد كبيرة وواسعة وهو المسؤول عن تنفيذ هذه القضيّة (يملأ الأرضَ قسطا وعدلا )، وعبارة المُصلِح ذكرتها جميعُ الأديان السماويّة، بالنتيجة الكلّ يترقّب والكلّ مفتقرٌ والكلّ ينظر إلى هذا الوجود المبارك، فلا بُدّ أن تكون هذه الأعمال التي نؤدّيها تُصبّ في رضاه، وأن يكون جزءٌ من أهمّية عملنا أنّها ملحوظةٌ بعينه (سلام الله عليه)، لا أقول الجزء يعني بعض الأمور لا، وإنّما الإنسان عادة تأخذه يمينا ويسارا لكن هذا محطّ العناية ومحطّ العمل في غاية الأهمّية، وهذا الأمر بصراحة أعتقد هو بمقدارٍ ما واضح )) (العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 327 ), تحدث الخطيبُ هنا عن مشروع الإمام المهدي (عجل الله تعالى مخرجه الشريف) المشروع الإلهي في الأرض , وقد ذُكر في جميع الاديان السماوية تأكيداً على أهميته وهو يشمل جميع مناطق العالم , وإنّ هذا المشروع يأتي بعد الانحراف عن كلّ ما جاءت به الأديان السماوية والابتعاد عن القيم والمبادئ الإنسانية والسلوك والقواعد التي حدّدتها الأديان فضلاً عن انتشار الظلم والفقر والخوف والفساد والجهل , ومِنْ ثمّ يجب أنْ تكون أعمالنا تَصُبُ في رضا الإمام وأنْ يتوافر لدينا الاستعداد الكامل لهذا المشروع حتى نكون مهيّئين للاستقبال والاندماج لهذا المشروع الالهيّ بوصفه يوصلنا إلى طريق الحق والكمال في السلوكيات والأعمال وجوانب الحياة المختلفة كلّها. ويضمن القضاء على الظلم والجور والاستبداد والاستكبار وارجاع الحق إلى أهله فتملأ الأرض نوراً وعدلاً كل ذلك ببركة إمامنا المهدي (عجل الله تعالى مخرجه الشريف) , فهو يمثّل نظام نظمه ورسمه الله (عزّ وجلّ) الخبير الذي أحاط بكل شيء علمه , لذا لجأ الخطيب هنا إلى الاستعارة؛ كونها تمثل وسيلة مهمة في درجة الإقناع و التأثير في استعماله لفظ (ملء)؛ لأنّها أكثر إيحاءً ومعنى ,وقطعاً إنّ الحاجة إلى الأمل والإيمان بوجود مُنقذٍ مُخَلّصٍ من شأنه أنْ يحصّن الإنسان من الوقوع في مستنقع اليأس أو شركه , وإنّ التبشير بما سيقوم به هذا المنقذ من شأنه أن يزيد المؤمنين به ثقة بالمستقبل ويعزز ثباتهم على إيمانهم وما دام الأمر كذلك كانت الاستعارة في هذا المقام مقام التبشير بما سيقوم به المنقذ أبلغ من الحقيقة ,الأمر الذي حمل المرجعية الدينية على الحِجاج بها , فبدلاً من قولها إنّ المنقذ سيقيم العدل في الأرض ومخاطبة المؤمنين بهذه العبارة التي لا مجاز فيها , عمدت إلى العدل عنها إلى العبارة المجازية فشبّهت الأرض بالكأس أو الوعاء ثم حذفته وأبلغت على لازمة من لوازمه (الملء) للإيحاء بإقامة العدل ونشره في بقاع الأرض كلّها كامتلاء الوعاء في دلالته على بلوغ الماء أعلى حد فيه بخلاف التعبير الحقيقي الذي لا يوحي بهذه الدلالة.
كما وَظَّفتْ خُطب المرجعية الدينية العليا الاستعارة الحِجاجية لإقناع المتلقي بالتنظيم المتناسق بين المقاتلين وكان له تأثير على سير المعركة واستمرارها ضد دا. عش الار. هابي والقضاء عليهم وتطهير جميع الأراضي العراقية منهم , الامر الذي حمل الخطيب من توظيف الاستعارة المتمثلة بلفظة (التطهير) , كما موضح في الخُطبة ((إنّ التنسيق الرائع الذي كان بين صفوف الم. قاتلين جميعا كان له الأثر الواضح على سير المعركة، إذ إنّ الأعزّة قد تعاملوا مع المعركة على أساس القضاء على الإرهاب. يّين ومقات. لتهم، وتطهير جميع الأراضي من دنسهم)) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 130 ) , فقد استعار الخطيب هنا لفظة التطهير للأرض والطهر إنّما للشيء الخالي من الدنس فجعل الأرض كالثوب الذي وقع عليه القذارة ثم أزال عنه بالتحرير والقتال , فشبّه الأرض بالثوب ثم حذف الثوب أو ما يشابهه وحذف الطرف الثاني واستعار لازمة من لوازمه وأجراه من خلال الاستعارة المكنية التي أوحت الأرض بشيء مقدّس وطاهر, ولهذا اشبهها بالأمكنة المقدسة التي تستحق أنْ يضحي الإنسان من أجلها, فضلاً عن حرف (الراء) وهو حرف امتداد انفجاري, ولم يكتفِ الخطيب بذلك فقد استعار لفظة (دنس) شبّهها بأفكار الأعداء لوجود اعداء أشبه وجودهم بالقذارة وحذف هذا الشيء واستعار لازمة من لوازمه وهو الدنس للتقبيح , فهنا يشاكل التطهير مع الدنس ومن الاستعارات الأخرى التي جاءت في خُطب المرجعية الدينية العليا وهي لفظة (أثلجت) , كما موضّح في الخطبة ((يحقّق المقاتلون الأبطال الذين يخوضون معركة تلعفر يحقّقون انتصارات ميدانيّة رائعة في مهنيّتها وكفاءتها أثلجت قلوب العراقيّين)) (العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 117), إذْ شَكلّتْ الاستعارة الحِجاجية حضوراً فعالاً في تشكيل قوة مؤثرة , فاستعار الخطيب لفظة (أثلجت) وهي للشيء الذي يعمل للتبريد وحذف هذا الشيء واستعار لازم لوازمه وأسندها إلى الانتصارات فكأنّما شبّه الانتصارات بالشيء القادر على الطمأنينة, أي الشي الذي يثلج النفس فاستعار المادي (الثلج) للراحة النفسية,أي المعنوي بالحسي , وهذا كله من باب التجسيد , فوظيفة (أثلجت) أعطت أهمية للاستعارة الحِجاجية فهنا استعارة مكنية , فالهدف هو التأثير والإقناع في المتلقي بأنّ الانتصارات التي حققها المقات. لون في تلعفر طمأنت العراقيّين بالنصر. ولإقناع المخاطبين بأنّ الحرب مع الإر. هاب كانت حرباً طاحنة وَظّفَ الخطيبُ الاستعارة الحِجاجية, فاستعار الخطيب لفظة (ضروس) للحرب الذي شبّهها بالكائن الحي المتوحّش الفتّاك وحذفه واستعار لازمة من لوازمه التي هي الأضراس التي يخرجها الكائن المتوحش عند الافتراس , كما مبين في الخُطبة ((أسأل الله سبحانه وتعالى من هذا المكان المعظّم وبمن نحن بجواره الإمام الحسين(عليه السلام) أنْ يشدّ على أيادي إخوتنا المقاتلين وهم يخوضون حربا ضروسا ضدّ هذه الطغمة الداعشيّة المنحرفة)) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019: ص 17 ) , فالاستعارة هنا مكنية أسبغت القدرة على تجسيد شدة هول المعركة وحراجتها ولهذا فهي فيها نمط حِجاجي بالإعلاء من شأن المقات.لين بدلالة الفعل يخوضون؛ لأنّ الخوض هو عندما يخوض الإنسان بالأمواج وهي استعارة أخرى تبيّن النمط الحِجاجي لشدة القتال فضلاً عن مجيء الفعل يخوضون يدلّ على التجسيد، اضافة إلى حرفي (الياء والواو) وهما حرفا امتداد ويدلان على الإطالة , وحرف (النون) للحزن كأنّما مآسي الحروب , فهدف الاستعارة هنا هو الإقناع وجذب عقلية المخاطبين بأنّ الحرب التي خاضها المقات.لين كانت حرباً شرسة. لذا تعدُّ الاستعارة الحِجاجية في خطب المرجعية الدينية العليا وسيلة من الوسائل المهمة التي استعملها الخطيب للزيادة في درجة الإقناع واستمالة المتلقي فضلاً عن الصور البلاغية الأخرى التي تَمّ ذكرها, حتى يصل إلى درجة الإقناع المطلوبة للمواضيع التي طرحت في الخطب وإثارة ذهن المتلقي .
• التمثيل : وهو أحد الطرق الحِجاجية الذي يختلف عن مفهوم المشابهة , إذ لا يرتبطُ التمثيلُ بعلاقة المشابهة غالباً , وإنّما يركّزُ على ترابط تشابه العلاقة بين أشياء ما كان لها أنْ تكون مترابطة (ينظر: عشير , 2006 : ص 97 ), وهو ربط الصلةِ بين شيئين , حتى يتمكّن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه بالطرق الحِجاجية , ليقنع المتلقي بقضية ما (ينظر: الشهري , 2004 : ص 497 ), وتظهر قوة التمثيل من خلال قدرته على التقريب بين طريقتين مختلفتين , ومحاولة لإخفاء ما يحصل بينهما من الاختلاف خلافاً للمقارنة كطريقة في الاستدلال, عن طريق إيجاد حقيقة تشابه في العلاقات , فهو احتجاج لأمر محدد بوساطة علاقة الشبه التي تربطه بأمر آخر (ينظر: الدريدي , 2011 : ص 253 ) , والتمثيل يتمكن من إسقاط علاقات متضادة على مجال لا وجود له , أو يبتكرَ علاقات حديثة من منطلق تشابُه ما, فالذهنُ ينظرُ إلى ما يحدث أمامه عن طريق الاحكام التي تكونت فيه على الخبرة السابقة , ويلعب دوراً مهماً في الابتكار والإبداع والنجاح بوساطة عمليات التجديد والتمديد التي يسمح بها (ينظر: صادق , 2015 : ص 167), لذا فإنّ آليات التمثيل من أكثر الطرق الاستدلالية استعمالاً, وهو ما نجده في الخطابات الإنسانية (ينظر: عبد الرحمن, 2005 : ص 174 ) , كونه ((يزيد في الكلام معنًى يدل على صحته ذكر مثالٍ له)) (الخفاجي, 1969 : ص 275 ) ,و يكون رؤاه قابلة للمراجعة عندما تواجه الوقائع , وإنّ المعارف التي نستطيع الحصول عليها في العملية التمثيلية ظنية ولا يمكن أنْ تُضاهي المعارف الناتجة عن إعمال البرهان ، فالتمثيل أداة للتدليل, ومن غير الممكن الاستغناء عنه (ينظر: البعزاتي , 2006 : ص 29), وهو ((أسلوب يتوخاه المتكلم في الاحتجاج فَيُتمُّ تقديمه كونه من أقوى الأدلة التي تكون بجانب النتيجة المتوخاة وهذه الميزة للقول التشبيهي أو الاستعاري يخدم النتيجة المعاكسة )) ( ينظر: قدا , 2016 : ص 174), وليس هنالك أي اختلاف في أنّ آليات التمثيل تمثّل أوسع الطرق الاستدلاليّة استعمالاً ومِن أكثرها تأثيراً في الخطابات الإنسانية والفلسفية (ينظر: الدريدي , 2011 : ص 264) , وإنّ حِجاج الاستدلال بالتمثيل هو الأقرب إلى روح الأدب, ؛ لما يحمله من تخييل لا يتحقق في حقل آخر فيدخل بذلك في مجالي التشبيه والاستعارة (المشهوري , 2019 : ص 530) فالتمثيل يكون أقرب وسيلة للإيضاح والفهم, وَيعدُّ من الوسائل التي تقرّب البعيد من المعاني, ويتمثّل الاستبدال بالتمثيل عن طريق استثمار الصور والحكايات لنقل بعض الأفكار عندما يعمل على نقل الحقيقة المتضمنة حالة خاصة إلى حالة خاصة أخرى وذلك بالاعتماد على مقاييس التشابه والتماثل, التي تسيطر على المشترك وتجعله مصدراً للحقيقة ضمن مجموعة تضعُ التمثيل موضع الهوية التي عن طريقها تتكون النتائج , وإن العلاقة بين الطرفين (المثل والمثيل) هذه موجودة في الأصل والتمثيل يعمل على توحيدها ,وإعادة تمثيلها عن طريق المقارنة ,أي أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد والحجة على صحته (ينظر: عبد الرحمن , 2005 : ص 147) وتأسيساً على ما تقدمَ وَظّفتْ خطبُ المرجعية الدينية فَنّ التمثيل في جذب انتباه المخاطبين والتأثير بهم ومن أبرز الموضوعات التي عملت المرجعية الدينية العليا على طرحها للنقاش مستعينة بهذا الفن في بيان أهمية العشائر في العراق , كونها تتميز بأنّ لها ادواراً إيجابية وسلبية في الوقت نفسه, وللتنبيه على خطورة الدور المنوط بالعشيرة وَلفْتِ الأنظارِ إلى حساسيته لجأ الخطيبُ إلى تشبيهها بالمدرسة ليكشف بهذا دلالات كثيرة ويوجز مقاصد عدّة ويمثّلها ؛ كون المخاطبين يدركون جيداً أنّ المدرسة من حيث الأصل هي التي تنهض بغرس القيم النبيلة ومكارم الأخلاق في نفوس طلبتها وتعمل على إخراجهم من ظلمات الجهل والضلال والضياع وتهديهم إلى سبيل الرشاد والفلاح والصلاح , كما يدرك المخاطبون بهذا التشبيه أنّ المدرسة يمكن أنْ تكون سبباً لحدوث خلاف ذلك ايضاً أي يمكن أنْ تكون سبباً للخراب والفساد والتحلل والانحراف حين تعجز ادارتها عن أداء مهامها وتخفق في النهوض بواجباتها , ولهذا لجأ الخطيب إلى استعمال الرابط (لكن) ليؤكد أنّ تأثير العشيرة يمكن أنْ يكون سلبياً وخطيراً حين تسمح ظهور سلوكيات تتنافى في جوهرها مع ثوابت العقيدة الإسلامية وتتأخّر في معالجتها فتتغلغل جذورها ويصبح من الصعب التخلّص منها , الأمر الذي يحمل المخاطبين على الاقتناع بضرورة قيام العشيرة بالإسراع في التصدي لتلك الظواهر السلبية والعمل على مواجهتها قبل فوات الأوان وخروجها من تحت السيطرة , كما في الخُطبة ((سبق أنْ بَيّنا أيّها الإخوة والأخوا ت في خطبةٍ سابقة نظام العشائر - - ودور هذه العشائر في العراق، وذكرنا أنّ العشائر في العراق تمثّل مدرسة في مجموعةٍ كبيرة من القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق الرفيعة، لكن في الوقت نفسه برزت في المرحلة الأخيرة مجموعة من الممارسات والأعراف والتقاليد التي تتنافى مع الشريعة الإسلاميّة والقوانين النافذة، وهذه الأعراف والتقاليد السلبيّة لو استمرّت وتجذّرت في المجتمع ستكون لها مخاطر وتداعيات خطيرة على المجتمع في تعايشه السلميّ )) (العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 282 ). تكلّم الخطيبُ عن موضوع آخر وهو قلة الثقافة والوعي والمعرفة والجهل لدى بعض الأفراد إذ يُعدُّ الجهل من أكثر الآفات التي تصيب الإنسان ومن بينهم الطالب الجامعي الذي يفترض أن يكون مُلّمّاً بالمعرفة والعلوم فشبّه الخطيب الطالب الجامعي بإنسان الأحراش الذي يعيش في الظلمة والضلالة وبعيداً عن الحقائق ولا يفقه شيئاً من حوله باستعمال أداة من أدوات التشبيه وهي (كأنّ) والقاسم المشترك بينهما يتمثل بالانقطاع والانعزال وضيق الأفق وقلة الثقافة وضحالة الوعي ومحدودية الاطلاع على المعارف والثقافات ليؤكد أنّ ضعف الإيمان سببه الجهل وعدم الاطلاع وأنّ قوة الإيمان تأتي من كثرة الاطلاع والتواصل والتسلّح والتزوّد بمختلف العلوم ومتابعة الجديد فيها, معزّزاً بشواهد أكّدت أنّ جهل العبد أو الإنسان يجعله أسيراً للضلالة والخداع والبدع والخرافات التي تسلخ الإنسان من دينه إن لم تقلل من إنسانيته قبل كل شيء وتحوله إلى مسخ وكأنّ الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليه بالعقل وميّزه وفضَّلَه عن سائر مخلوقاته , وقد جاء ديننا الإسلامي الحنيف ليؤكد على ضرورة التعلم والتنور لترسيخ الايمان كما في قوله تعالى : {وإِنَمَا يَخشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ العُلَماءُ} [سورة فاطر :آية 28]لأنّ (العالم أحذر لعقاب الله من الجاهل إذْ يختص بمعرفة التوحيد والعدل ويصدق بالبعث والحساب والجنة والنار (الطبرسي , 2005: ص 123 )
وأكّدت الأحاديث النبوية الشريفة على فضل العلم كقول الرسول محمد (ص): ((و مُنْ سَلكَ طَريقا يلتمسُ فيه علماً, سهلَ اللهُ له طريقاً إلى الجنةِ )) ( النووي , 1992 : ص 478 ) , فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضَّله عن بقيّة المخلوقات وجعله خليفةً في الأرض وميّزه بالعقل ومنحه القدرات العقليّة, ويمثّل العقل مصدر الفكر والتركيز وله القدرة الكبيرة على الإدراك والتدبّر والفهم والتمييز بين الحق والباطل ( الابارة , 2015 : مقال), كما جاء في الخطبة (وهناك ثقافات عندما تأتي بشخصٍ إلى الآن نحن في القرن الواحد والعشرين وتجده طالبا جامعيّا لا يعرف الإمام أصلا، كأنّه عائش في أحراش بعض الدول التي لمْ يصلْها أيّ شيء من العلم، وهذا يكون واسطة أن يُظهر عقيدة الإمام المهديّ (عليه السلام)) (العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 329).
تمثلُ مهنة التعليم من اعظم المهن وأنبلها؛ كونها تركز على العقل والروح والتفكير بصنوفه كلّها,ولاُبدّ من توافر البيئة التعليمة المناسبة التي تُعدّ الأصل في نجاح أيّة عملية تعليمية , ورسالة المعلم هي إيصال المعلومات للطلبة لتساعدهم في البحث عن الحقيقة والوصول إليها وتنشيط المتعلمين وتحريك جميع حواسهم وإشراكها في كسب المهارات المطلوبة وبناء شخصيتهم وتوظيف المعرفة المكتسبة في صقل شخصيتهم , ومن ثمّ إعداد مواطن متعلم ومثقف ( الحمداني , 2013 : مقال) هنا أكّد الخطيب على احترام قدسيّة عمليّة التعليم واحترام القائم بها ووجوب صونها وحمايتها وعدم انتهاك حرمتها بالتدخل في معاييرها وثوابتها أو موضوعيتها, ولإقناع المخاطبين بذلك لجأ الخطيب إلى تشبيه تدخل الأهل أو أيّة جهة اخرى أو تجاوزهم على حدودها وثوابتها بمن يساهم في تجهيز المريض ويمهّد أو يعجّل في دفعه نحو حتفه المحتوم بدلاً منْ أنْ يحاول أو يساعد في انقاذه وإحيائه وإطالة عمره , الأمر الذي يستدعي من الجميع صون مهنة التعليم من التدخلات وتأمين متطلّبات أو مقوّمات نجاحها ولا سيما وعي رسالة المعلّم والتعليم في تنوير الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة وهذا يضمنُ نجاح العمليّة التربويّة والتعليميّة , كما جاء في النص: ((فإذا أعطينا المعلّم حقّ المحاسبة يُفترض أنْ لا نتدخّل في عمله، مثلا أن لا نضغط على المعلّم نجّح الطالب الفلاني؛ لأنّه ابن فلان هذا كأنّه مسمار في نعش العمليّة التربويّة)) (العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 395) يتعرّض الإنسان لاختبارات خلال مسيرة حياتهِ ومن أصعب تلك الاختبارات هو الوقوف بجانب الحق ونصرته , وهذا الاختبار يكون مفصلياً, أي إمّا أنْ يكون مع طريق الحق الذي يمثل الصدق والخير أو طريق الباطل الذي يمثّل الشر والحقد والبغض وعلى الرغم من كون قضية الإمام الحسين (ع) تمثّل الحق بعينه وهذا كان واضحاً لكلّ من إلتقى وسمع به, إلاّ أنّ بعض الأشخاص لم يكن لديهم القرار للوقوف مع الحق المتمثّل بالإمام , فوقفوا موقف المتفرّج أو المحايد وهم بهذا قد خَذلوا الحقَّ لتعرّضهم لضغوطات عدة فهي أسباب رئيسة في عدم اتخاذ القرار الصائب والوقوف مع الحق والثبات عليه , وقد أضاف الإمام الحسين (ع) اختباراً صعباً لأصحابه من خلال تخييرهم بالبقاء معه أو الرحيل عنه, وهنا جاء ثبات أصحاب الإمام وعزيمتهم بأنّهم أبوا أنْ يموتوا وأرادوا البقاء مع الإمام وأثبتوا قولاً وفعلاً أنّهم من أنصار الحق المتمثّلة بشخصيّة الإمام الحسين (ع) وكانوا يدافعون عن الدين الإسلامي بكل إخلاص وصدق وتفانٍ , للحصول على الشهادة فكتبت لهم جميعاً, وقد قال عنهم الإمام الحسين (ع): ((فأنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي)) (البغدادي , 2008 : ص 97 ), الأمرُ الذي حمل المرجعيّة الدينيّة العليا إلى استعمال آليّات التمثيل لإثارة المتلقي حينما شبّه المقاتلين الذين يقاتلون الإر. هاب الدا. عشي بأصحاب الإمام الحسين (ع) ووصفهم بأنّهم الأبطال الذين يتسارعون إلى ساحات القتال لنيل الشهادة في الدفاع عن العرض والأرض والمقدسات وهذه إحدى النعم العظيمة التي أنعم الله بها على العراق وجود مثل هكذا رجال فيهم صفات من أصحاب الإمام الحسين (ع) , كما موضح في الخُطبة : ((إنّ لنا رجال في الوقت الحاضر يشبهون أصحاب الحسين (ع) حقيقة , اقرؤوا قصص هؤلاء الابطال في المعارك يتسابقون نحو المنيّة , يتسابقون نحو الموت في سبيل الدفاع عن العراق فهذا توفيق ونعمة من الله تعالى أنْ نَجِدَ رجالا أمثال هؤلاء ونحن بحاجة إلى رجال كثر أمثال هؤلاء)) ( العتبة العباسية المقدسة , 2019 : ص 208 ) .
فإنّ قضية الإمام الحسين (ع) تمثّل رسالة إنسانيّة وموعظة ونصيحة لكلّ البشر دون استثناء، وكان هدفُ الإمام هو إعلاءُ كلمة الحقِ والإصلاح ودحض الباطل، وهذا الموقف يتكرّر في كلِّ زمانٍ ومكان، وهناك من يمثّل خط الإمام الحسين (ع) والمتجسّد في الوقت الحالي بالأبطال الذين لبّوا نداء المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي ليسجلَّ ذلك شاهداً تاريخياً عظيماً.
الخاتمة:
نحاول أن نبيّن أهم النتائج التي توصلت إليها في بحث التمثيل والاستعارة الحِجاجية في خُطب المرجعية الدينية العليا، ومن تلك النتائج:
1- اتضحَ من خلال البحث الدور الأبوي والمعرفي والفكري للمرجعية الدينية العليا إذْ مَثَّلَتْ خطاباتُها مختلف شرائحِ المجتمعِ العراقي، الأمر الذي ساعد بصورة فاعلة في تحقيق الإقناع.
2 - تكمن قوة تأثير خطابات المرجعية على مواقف الناس وسلوكهم إذ إنّ قوّتها تنبعُ من حقيقتها المعرفيّة التي تعمل على إقناع المتلقي فضلا عن تأكيد افتراضات وأحكام توجيهية محددة.
3 ـ تُعدّ الاستعارة الحِجاجية من الأساليب البلاغية التي - وظّفتها المرجعية الدينية العليا لزيادة إقناع المتلقي بالغايات الحِجاجية.
4 ـ كان للاستعارة في خُطب المرجعية الدينية العليا دور في نقل المتلقي من المجرّد إلى المحسوس وتكسب فيها الحُجج قوة من أجل تحقيق الإقناع.
5 ـ وَظّفْ التمثيل في خُطب المرجعية الدينية العليا لما له أثر - في إثارة المتلقي، فضلا عن قدرته على التقريب بين طريقتين مختلفتين، ومحاولة لإخفاء ما يحصل بينهما من خلال ايجاد حقيقة تشابه في العلاقات.
6 ـ اهتمّت المرجعية الدينية العليا بالتمثيل الحِجاجي لدوره - الفاعل في تنسيق وترابط النصوص فقد منح الخطاب قدرة أكبر في التأثير وفي ترتيب الأقوال.
7 ـ آليّات التمثيل تمثل أكثر الطرق الاستدلالية استعمالا ومن - أكثرها تأثيرا في الخطابات الانسانية والفلسفية.
المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.
خطب الجمعة لسنة 2017 , توثيق وتحقيق العتبة العباسية المقدسة مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، قسم الموسوعات والمعجمات ,, مج: 13 ,ج: 1 ,ج 2 .
[1]ابن سنان الخفاجي, سر الفصاحة, شرح وتعليق عبد المتعال الصعيدي, مكتبة ومطبعة محمد صبيح واولاده, ميدان الازهر, 1969 .
[2]ابو بكر العزاوي, اللغة والحجاج, العمدة للطبع, الدار البيضاء, المغرب, ط 1 . 2006.
[3]ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العُكبري البغدادي , الارشاد في معرفة حُجج الله على العباد , تح: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لأحياء التراث , سلسلة مصادر بحار الانوار (12 ) , بيروت , لبنان ,ج 2 , ط 2 , 2008 .
[4] ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن , دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع , ط 1 , ج 2 , 2005 .
[5] ابو هلال العسكري، الصناعتين، تح: علي محمد بجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط, 1986.
[6] الامام النووي، رياض الصالحين، تح: جماعة من العلماء، تح: محمد ناصر الدين الألباني، اشراف: زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، بيروت، ط 1 , 1992.
[7] بدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القران، تح: محمد ابو الفضل ابراهيم، دار الجبل، بيروت، ج 3, د. ط, 1988.
[8] بناصر البعزاتي، الصلة بين التمثيل والاستنباط ضمن كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1 , 2006.
[9] جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 3 , 1992.
[10] جورج زيناتي، الاستعارة الحية، تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 1 , 2016.
[11] الخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة والمعاني والبديع، وضع حواشيه (ابراهيم شمس الدين)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1 , 2003.
[12] سامية الدريدي، الحِجاج في الشّعر العربي بنيته واساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد الاردن، ط - 2 , 2011.
[13] شوقي ضيف, البلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف, ط 8 , 1992 .
[14] طه عبد الرحمن, تجديد المنهج في تقويم التراث, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء ,ط 2 , 2005 .
[15] عبد السلام عشير, عندما نتواصل نغير, مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج ,افريقيا الشرق, 2006
[16] عبد العالي قدا, بلاغة الإقناع (دراسة نظرية تطبيقية),عمان, دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع, ط 1 , 2016 .
[17[عبد العزيز الحويدق, نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية)من ارسطو الى لايكوف ومارك جونسون (,دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع, عمان, ط 1 , 2015 .
[18] عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني ,دلائل الاعجاز, قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر, الناشر مطبعة المدني, القاهرة, ط 3 , 1992 .
[19] عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني, اسرار البلاغة, قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر, الناشر مطبعة المدني, القاهرة, د ت .
[20] عبد الهادي بن ظافر الشهري, استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوية تداولية) , دار الكتاب الجديدة المتحدة , بيروت, ط 1 , 2004
[21] عمارة ناصر, الفلسفة والبلاغة (مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي )ناشرون, الدار العربية للعلوم ناشرون, منشورات الاختلاف, الجزائر, ط 1 , 2009
[22] مجيد عبد الحميد ناجي , الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت ,لبنان , ط 1 , 1984 .
[23] مثنى كاظم صادق , اسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي, تنظير وتطبيق على السور المكية, ,منشورات ضفاف ,لبنان, ط 1 , 2015
[24]محمد بن عبد الله المشهوري, التداولية السردية في خطاب الأقصوصة النسائية ,عمان ,ط 1 , 2019 .
[25] محمد حماسة عبد اللطيف , الحملة في الشعر العربي , كلية دار العلوم, جامعة القاهرة , مطبعة المدني , المؤسسة السعودية ,مصر , ط 1 , 1990 .
[26] نصر حامد ابو زيد, إشكالية القراءة وآليات التاويل, المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء , المغرب , 2005 .
• المجلات والدوريات:
[1] احمد ابو زيد, الاستعارة عند المتكلمين , مجلة المناظرة, ع: 4 , 1991 , م: 46 - 47 .
[2] صلاح الدين يحي, حجاجية الاستعارة في الخطابات اللغوية ,جامعة مولود معمري, تيزي وزو, 2017 .
• مواقع الانترنت:
[1] سمير مثنى علي الإبارة، تكريم الله للإنسان بالعقل، مقال, 2015 , https:www.alukah.net/culture/o/89723
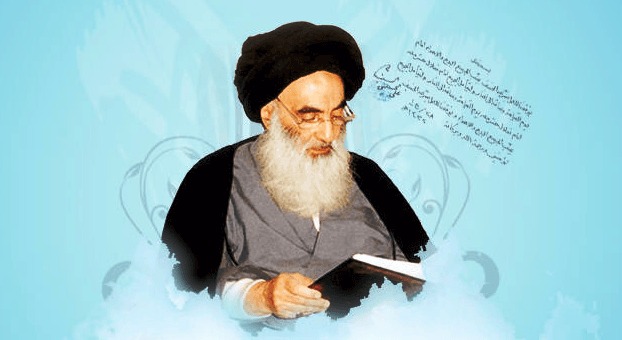
 فتوى الدفاع الكفائي
فتوى الدفاع الكفائي 
ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م )
قال الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الثانية من الصحن الحسيني الشريف ما يأتي :
إن العراق وشعبه يواجه تحدياً كبيراً وخطراً عظيماً وإن الارهابيين لا يهدفون إلى السيطرة على بعض المحافظات كنينوى وصلاح الدين فقط بل صرحوا بأنهم يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف ، فهم يستهدفون كل العراقيين وفي جميع مناطقهم ، ومن هنا فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع ولا يختص بطائفةٍ دون أخرى أو بطرفٍ دون آخر.
وأكد الكربلائي : إن التحدي وإن كان كبيراً إلاّ أن الشعب العراقي الذي عرف عنه الشجاعة والإقدام وتحمّل المسؤولية الوطنية والشرعية في الظروف الصعبة أكبر من هذه التحديات والمخاطر .
المزيد