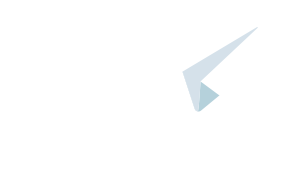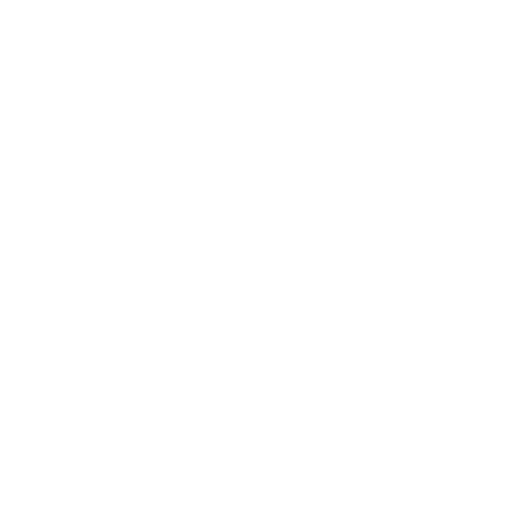تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
نقد الإمام الخميني للاتجاهات الآحادية في التفسير
المؤلف:
جواد علي كسار
المصدر:
فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية
الجزء والصفحة:
ص 163- 179 .
27-09-2015
3216
على ضوء هذه الخلفية النقدية العريضة يسهل الانتقال إلى الفكر القرآني
للإمام الخميني فيما حمله من نقد مكثف للنزعات الاسقاطية ، ورفض للاتجاهات
الآحادية حتّى تلك التي تنتهي إلى المنهج العرفاني الذي لا يخفي الإمام انحيازه
إليه مقارنة ببقية المناهج التفسيرية.
أ- الوصف
في نص طويل نسبيا يقدم الإمام وصفا لنزعات التفسير واختلاف ألوانه واتجاهاته
، جاء فيه : «ليس تفسير القرآن بالمسألة التي يستطيع أمثالنا النهوض بها وأداء
حقّها. ومع أنّ علماء الطراز الأوّل سواء من العامة أو الخاصة بادروا على مدار
التأريخ الإسلامي إلى تصنيف كتب كثيرة في هذا المضمار ومساعيهم مشكورة- بلا ريب-
إلّا أنّ كلّ واحد منهم لم يزد على تفسير وجه من وجوه القرآن الكريم ولم يكشف إلّا
عن صفحة من صفحاته ، وفاقا لتخصّصه واستنادا إلى الفنّ الذي كان بارزا فيه. على أن
ليس من المعلوم أنّ هذا الوجه كان قد تمّ بشكل كامل.
على سبيل المثال عمد العرفاء على مدى قرون إلى كتابة التفسير وفاقا
لطريقتهم التي هي طريقة أهل المعارف ، كما هو الحال مع محيي الدين في بعض كتبه ، وعبد
الرزاق الكاشاني في «التأويلات» ، والملّا سلطان علي في تفسيره ، وقد أجاد بعضهم
في نطاق الفنّ الذي يتوفر عليه ، بيد أنّ القرآن لا ينحصر بما كتبوه. ما قدّموه
يمثّل بعض أوراق القرآن ووجوهه.
كما قام أيضا طنطاوي وأمثاله ، وكذلك قطب بتفسير القرآن بطريقة اخرى هي
أيضا ليست تفسيرا للقرآن بمعانيه كافّة ، بل كانت تعبيرا عن وجه من الوجوه وإماطة
اللثام عن بعد واحد.
لقد كان لكثير من المفسّرين - من غير هاتين الطائفتين- تفاسير اخرى ، مثل
«مجمع بياننا» [يعني به : مجمع البيان] الذي يعدّ تفسيرا حسنا جامعا لأقوال
العامة والخاصة.
إنّ حال هذه التفاسير التي صنّفت كحال سابقاتها ، فالقرآن ليس بالكتاب الذي
نستطيع نحن أو غيرنا تدوين تفسير جامع له يليق بشأنه. إنّ علوم القرآن هي علوم
اخرى وراء ما نفهمه. نحن نفهم صورة من صور كتاب اللّه وصفحة من صفحاته ، أمّا
الباقي فيحتاج إلى تفسير أهل العصمة المعلّمين بتعليم رسول اللّه» (1).
من الواضح أنّ الإمام يعيد بروز التنويعات في التفسير إلى اختلاف الاختصاص
الذي ينطلق منه المفسّر ، فالتفسير يكتسب لون صاحبه المعرفي ويتلوّن باختصاصه ، ويسقط
عليه اهتماماته. فابن عربي وأضرابه أسقطوا عليه ثقافة أهل المعرفة وتناولوه عبر
طريقتهم ، وطنطاوي جوهري تناوله انطلاقا من البعد العلمي الحديث ، وسيد قطب
انطلاقا من البعد الاجتماعي الحركي وهكذا.
المهم إنّ هذا النص للإمام لا يسجّل إدانة لهذه الألوان من التفسير التي
تكتسب صبغة صاحبها واختصاصه ، بل يرى فيها جهودا محمودة استطاعت أن تميط اللثام عن
بعد من أبعاد القرآن. وهذا هو تقييمه لها ، إذ هي لا تدخل في نطاق التفسير الشامل
، بل هي تفاسير آحادية الجانب. وهذا هو عيبها. على أنّ في النص إشارة لحدّين في
التفسير أحدهما يستوعب الجهد الإنساني بمختلف ألوانه ومراتبه ، ثمّ يأتي الحدّ
الثاني الذي يحتاج فيه الإنسان إلى مرجعية أهل البيت عليهم السّلام.
في نص آخر جاء بعد حوالي خمس سنوات من النص السابق ، عرض الإمام للظاهرة
ذاتها ، حاملا تنوّع الاتجاهات على تنوّع الاختصاصات من جهة ، وعلى طبيعة القرآن
من جهة اخرى ، حيث يعدّ كتاب اللّه مائدة مفتوحة للجميع تحوي جميع المعارف والمعاني
يأخذ كلّ واحد نصيبه منها على قدر استعداده الفكري وسعته الوجودية ، ليدلل على أنّ
ذلك من مظاهر الرحمة للإنسان.
يقول الإمام : «القرآن كتاب لا يصحّ الحديث عنه من خلال هذه الألسن اللكنة
البكماء. القرآن مائدة ممتدّة من الأزل إلى الأبد يستفيد منها جميع فئات البشر وطبقاتهم
، وبمقدورهم ذلك. لكن غاية ما هناك أنّ كلّ فئة لها مسلك خاص تستند إليه في
الاستفادة . فالفلاسفة يرتكزون إلى مسائل الإسلام الفلسفية ، والعرفاء إلى مسائل
الإسلام العرفانية ، والفقهاء إلى مسائل الإسلام الفقهية ، والسياسيون يرتكزون إلى
مسائل الإسلام السياسية والاجتماعية ، إلّا أنّ الإسلام يبقى هو كلّ شيء ، والقرآن
هو كلّ شيء [وليس بعدا من هذه الأبعاد] ، فالقرآن رحمة للبشرية كافة» (2).
النص يفسّر التنوّع تفسيرا إيجابيا على أسس موضوعية لا يمكن إنكارها ، تعود
إلى اختلاف الاستعدادات الإدراكية وإلى تفاوت مناهج العلم والمعرفة وتباين الشواغل
والاهتمامات عند كلّ فئة. والقرآن بطبيعته يستجيب لهذا التنوّع ، مع ملاحظة في
التقويم تفيد أنّ القرآن لا يقتصر على أي بعد من الأبعاد المذكورة ، ولا ينحصر
تفسيره في تلك الاتجاهات الآحادية.
ثمّ في النص أيضا لمحة مهمة لا أستطيع التمادي في تحليلها أو تضخيم
مدلولها. فقول الإمام في مفتتح النص : «القرآن كتاب لا يمكن الحديث عنه من خلال
هذه الألسن اللكنة البكماء» ربما فيه إشارة لنظرية في القراءة والتفسير شاعت في
الثقافة الحديثة تفيد أنّ الإنسان لا يقدم على قراءة النص وهو خال الوفاض من أي
شيء ، حتّى من مسبقاته الذهنية ومسلّماته الثابتة ، فضلا عن معارفه الاخرى. فالنص
يستجيب للقارئ على ضوء خلفيته ومسلّماته وسوابقه الذهنية ، ومن ثمّ فإنّ إدراك
الفيلسوف للنص القرآني يختلف مع إدراك العارف وإدراك المتكلّم واللغوي المشحون
بمدلولات اللغة ، وإدراك هؤلاء يختلف عن إدراك الإنسان غير المتعلّم ، وذلك تبعا
للتفاوت القائم في خلفية كلّ واحد من هؤلاء وطبيعة ما يتبنّاه وينطلق منه من
مسلّمات (3).
النص الخميني يومئ إلى هذا المعنى ببيان واضح وهو يؤكّد أنّه لا يمكن
الحديث عن القرآن بلسان أبكم ، ومن دون حصيلة ومبان محدّدة. يؤكّد هذه الدلالة ويرسّخها
أكثر النصوص الخمينية الاخرى التي تنعطف على هذا النص.
من ذلك ما صرّح به الإمام مرّات من أنّ : «حظ كلّ إنسان من حقائق القرآن هو
على قدر فهمه» (4) ، وأنّ كلّ إنسان يستفيد
من مائدة القرآن «بقدر استعداده» (5) ، وعلى نحو أوضح ، قوله : «إنّ الباعث
إلى نزول هذا الكتاب المقدّس والهدف من بعثة النبي الأكرم ، هو أن يكون هذا الكتاب
بمتناول الجميع ، بحيث يستفيد منه كلّ واحد بحسب سعته الوجودية والفكرية» (6).
فهذه النصوص تدلّ على أنّ كلّ إنسان يستفيد على قدر خلفيته ، ممّا يعني أنّ
الإنسان لا يتحرّك صوب القرآن خاليا من أي شيء ، بل لديه حصيلة مسبقة من خلالها وعلى
قدرها يستفيد ، كما أنّ عملية الفهم تخضع إلى مبان متعدّدة وتستمد من مصادر معرفية
وسيعة.
أجل ، يمكن أن تكون هذه الحصيلة خاطئة- أو جزء- منها مبنى ومحتوى ، فيبرز
الخطأ في المعرفة المستفادة. كما قد يندفع الإنسان لتلوين القرآن كله بخلفيته
العلمية والمنهجية ، وحصره عبر قناته المعرفية ، من خلال عملية التحميل والاختزال.
وهما منحيان يعرض لهما الإمام بالنقد.
ب- النقد والتقويم
تتخطّى نصوص الإمام دائرة الوصف إلى النقد والتقويم. ففي الإطار النقدي
يرفض الإمام أن يتحوّل القرآن الكريم عند المفسّرين إلى كتاب علوم محضة كالفقه والتاريخ
واللغة والفلسفة والعرفان وما إلى ذلك. فإنّ القرآن وإن احتوى هذه الأبعاد جميعا
إلّا أنّه من جهة لم يجمد على واحد منها ، كما أنّه لم يقصدها في نفسها كما هو شأن
الكتب المختصّة بهذه العلوم ، إنّما باعثه إلى ذلك مقصد أعلى يأتي من ورائها
جميعا.
عن قصص القرآن مثلا يقول الإمام : «إنّ جميع القصص المذكورة في القرآن وقد
كرّرت أحيانا ، إنّما جاءت لمسألة مهمة؛ إذ أنّ هدفها توجيه الناس ، والقصد منها
هو التهذيب» (7) لا الجانب القصصي أو
التاريخي أو الأدبي الفني حتّى يستغرق التفسير نفسه في هذه الامور ، لاهيا عن
المقصد المطلوب.
في امتداد النص ذاته يعرض الإمام إلى الجانب الفقهي ، فيضيف : «ليس القرآن
كتاب أحكام ، بل هو يتوفّر على ذكر كليات الأحكام واصولها. القرآن كتاب دعوة وكتاب
إصلاح مجتمع» (8). ممّا يعني أنّه لا يليق
بحركة التفسير أن تقف عند حدود الفقه أو تضخّم جانب الأحكام غافلة عن المقصد
الأعلى الذي جاء من أجله القرآن قاطبة ، بما في ذلك ما يتضمّنه من أحكام وتشريعات.
على ضوء هذا الاتجاه يقدّم الإمام تفسيرا آخر للقصص القرآني وتكرار القرآن
لهذه القصص ، يخرج به عن شواغل الكتابة التاريخية ، بحكم أنّ القرآن ليس كتاب
تاريخ ، كما يقول الإمام : «ليس القرآن كتاب تاريخ ، ولو كان كذلك لأمكن كتابة
القصة فيه ، وأكثر ما يتوفّر عليه كتاب التاريخ هو كتابه القصة مرّة واحدة لا
أكثر. أمّا كتاب الأخلاق فينبغي أن يتضمّن التكرار. فمن يكون مقصده أن يذكر الأخلاق
إلى الناس ، ينبغي له أن يقول ويقول ويقول حتّى تنفذ إلى عقولهم ، وإلّا فإنّ
الحالة الأخلاقية ، لا تكتسب وضعا سليما بمحض ذكر الأمر مرّة واحدة» (9).
نتيجة هذه النظرة التي ترفع القرآن عن الشأن التاريخي إلى الشأن الأخلاقي ،
يقدّم الإمام تفسيرا جديدا لتكرّر القصص القرآني منظورا إليه من زاوية بناء
الإنسان.
فمنهج بناء الإنسان وإعداده يملي التكرار ، وعندئذ لا يكون الأمر تكرارا بل
هو حاجة تفرضها الذات الإنسانية ومتطلّباتها في مستويات متعدّدة من البناء : «إنّ
واحدة من النقاط البارزة في القرآن الكريم ما نراه من احتوائه على المكرّرات. هذه
ليست مكرّرات ، بل هي طبيعة بناء الإنسان ، فأيّما صفحة تفتحها فيها دعوة إلى
التقوى وإلى الخصال الحسنة وما إلى ذلك. ثمّ تفتح صفحة اخرى فتجد قصة موسى وقصة
إبراهيم وقد ذكرتا مرّات عديدة. القرآن لا يهدف من ذلك أن يسرد قصة ، بحيث يكفي أن
يذكرها مرّة واحدة.
إنّ الأجانب لا يعرفون القرآن ولا يفهمونه ، لذلك يقولون كان من الأفضل أن
يكون موزّعا على أبواب ، وتحت كلّ باب كلمة محدّدة. لقد جاء القرآن لبناء الإنسان
، وهذه المهمة لا يكفي في تحقّقها أن يقال الكلام مرة واحدة وحسب» (10).
ما نفهمه من نفي الإمام للاتجاهات الآحادية في التفسير هو ليس نفي وجود هذه
الأبعاد في القرآن أو الدعوة إلى عدم تسليط الضوء عليها ، إنّما يعترض سماحته على
استغراق التفسير بها ، وغفلته عن المقصد الكائن وراءها. في نص ذات دلالة يقول
الإمام أواخر عام 1979 م : «ليس القرآن كتاب طبّ ، ولا كتاب فلسفة ولا كتاب فقه ،
ولا كتابا لسائر العلوم الاخرى» (11) ليوضّح
ما يريده من وراء هذا النفي ، بقوله : «القرآن كتاب لبناء الإنسان ... وإذا ما
طالع إنسان القرآن على نحو صحيح يجد أنّ كلّ ما موجود في القرآن موجود من خلال
بعده الإلهي ، وكلّ ما عرض له القرآن عرضه من الزاوية الالوهية. إنّ في القرآن
كلّ شيء لكن من خلال بعده الألوهي» (12).
فليس الإلغاء هو الهدف ، بل التنبيه إلى الصيغة الالوهية وإلى المقصد
الأعلى الماثل ببناء الإنسان ، وتعريفه بخالقه ، ثمّ «سوق جميع الموجودات هنا ، والإنسانية
جمعاء صوب اللّه تبارك وتعالى» (13).
انطلاقا من هذا المنظور الذي تشطّ فيه حركة التفسير عن المقصد الأساسي وتندفع
إلى اهتمامات فرعية وجزئية تملأ المساحة وتغيّب المقصد ، بادر الإمام في وقت مبكر
يعود إلى ما قبل ستين عاما من الآن ، إلى نقد الاتجاهات الآحادية من لغوية وتاريخية
وإعجازية ، وهو يطلق صيحة مدوّية تهدف إلى إعادة حركة التفسير إلى مسارها الصحيح ،
حين كتب : «ليس صاحب هذا الكتاب هو السكاكي والشيخ ليكون مقصده هو جهات البلاغة والفصاحة
، كما أنّه ليس سيبويه والخليل حتّى يكون منظوره جهات النحو والصرف ، ولا المسعودي
وابن خلّكان حتّى يبحث حول تاريخ العالم ، كما أنّ هذا الكتاب ليس كعصى موسى ويده
البيضاء أو روح عيسى الذي يحيي الموتى ليكون كتابا للإعجاز فقط والدلالة على صدق
النبي الأكرم ، بل إنّ هذه الصحيفة الإلهية هي كتاب إحياء القلوب بحياة العلم والمعارف
الإلهية الأبدية ، هو كتاب اللّه يدعو إلى شئونه الإلهية جلّ وعلا. لذا ينبغي
للمفسّر أن يعلّم الناس الشئون الإلهية ، كما ينبغي للناس أن يرجعوا إليه لتعلّم
الشئون الإلهية ، لكي تتحقّق الاستفادة منه {وَنُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء : 82].
ثمّ يربط سماحته بين تنكّب حركة التفسير عن مسارها ، وبين آخر الآية بكلام
موجع ، يقول فيه : «أيّ خسارة أعظم من أن نقرأ الكتاب الإلهي ثلاثين أو أربعين سنة
، ونراجع التفاسير ، ثمّ نبقى مع ذلك محرومين من مقاصده!» (14).
إشكالية مزدوجة
من الوجهة المنهجية التي ترتبط بمباني الفهم ومرتكزاته ، ليس من الصعب أن
نتبيّن انحياز الإمام إلى العرفان كمنهج في المعرفة وطريقة في التفكير وأسلوب في
إدراك الإسلام وفهمه بشكل عام ووسيلة للتعاطي مع القرآن خاصّة. فمن يرى أنّ
العرفان (15) هو أعظم معجزات القرآن :
«إنّ أعظم معجزة لهذا الكتاب العزيز وأكبرها هي المسائل العرفانية التي لم يكن لها
سابق وجود عند فلاسفة اليونان ... وإنّ المسائل العرفانية على النحو الموجودة به
في القرآن لا وجود لها في كتاب آخر ، وهذه من معجزة الرسول الأكرم» (16). ومن يرى أنّ البعثة النبوية أحدثت بنزول القرآن
«تحوّلا علميا عرفانيا في العالم استبدل الفلسفات اليونانية الجامدة ... إلى عرفان
عيني وشهود واقعي بالنسبة إلى أرباب الشهود» (17).
ومن يرى أنّ القرآن «عرض لكلّ ما عرض له انطلاقا من البعد الألوهي» (18). ومن يرى أنّ «اتصال المعنى بالماديات وانعكاس
المعنوية في جميع جهات المادية ، هو من خصوصيات القرآن»(19)؛
من يرى ذلك كله ويتبنّاه من الطبيعي أن يشترط أن تكتسب التفاسير جميعا الطابع
المعنوي ، وإن يكون تفسير القرآن لديه تفسيرا معنويا أخلاقيا. كما من الطبيعي أن
يتبنّى المنهج العرفاني وينحاز إليه بإزاء المناهج الأخر ، وأن ينصب الذوق
العرفاني شرطا لإدراك القرآن ، فمع «فقدان الذوق العرفاني لا يحصل الإدراك
المطلوب» (20) خاصّة في مثل قوله سبحانه : {ثُمَّ
دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ
قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم : 8 ، 9]. أجل ، بمقدور البحث
التفسيري الفلسفي بل حتّى العرفان النظري أن يسهم بإضاءة بعض جوانب المعنى ، لكن
الإدراك الأعمق يتوقّف على الذوق العرفاني والشهود العيني التحقّقي المباشر.
يضعنا تبنّي الإمام للمنهج العرفاني والفلسفي أو العرفاني الفلسفي كما
ركّبته مدرسة الحكمة المتعالية لحكيم شيراز ، أمام إشكالية مزدوجة ، شقّاها :
أولا : هل يعني تبنّي الإمام إبطال مشروعية بقية المناهج
المعرفية والتفسيرية ؟
ثانيا : أ لا يعني هذا التبنّي الهبوط إلى هوة
الاتجاهات الآحادية ، والإمام بصدد نقدها؟ فالمنهج العرفاني هو اتجاه في مقابل
الاتجاهات الاخرى ، ومن ثمّ سيجرّ التفسير إلى الآحادية التي يتم نقدها على هذا
الصعيد.
لم أعثر خلال البحث في تراث الإمام المكتوب والشفهي على ما يفيد إلغاء
مشروعية المناهج الاخرى سواء على مستوى المعرفة بمعناها العام الذي ينصبّ على فهم
الإسلام بأكمله ، أو على مستوى فهم القرآن خاصّة. فمع أنّ بعض كتب الإمام تعود إلى
مرحلة الشباب المبكّر وإلى ما قبل سبعة عقود من الآن ، كما في «شرح دعاء
السحر» (21) و«مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (22)
و«الأربعون حديثا» (23) و«سرّ الصلاة» (24) و«آداب الصلاة» (25)
، إلّا أنّه لم يخدش بمشروعية المناهج الاخرى فضلا عن أصحابها.
أجل ، في بعضها دعوة إلى عدم إنكار مقامات أهل اللّه ودفاع عن طريقة أهل
المعرفة وتوجيه متبنّياتهم من خلال القرآن والحديث ، من دون أن يكون هدف ذلك
«ترويج دراسة الفلسفة التقليدية أو العرفان التقليدي ، بل المقصود دفع إخواني
المؤمنين خاصّة أهل العلم نحو معارف أهل البيت عليهم السّلام ، وحثّهم على قراءة
القرآن وعدم نسيانه والابتعاد عنه» (26). وفي
أغلبها شكوى وعتاب وأحيانا نقد لمن ينكر المنهج المعرفي ويصمه بهذه التهمة وتلك (27) ، ليرسوا نهاية المطاف على نتيجة تؤمن بمشروعية
أصل طريقة الفلاسفة والعرفاء والفقهاء كمناهج ثلاثة يتحرك كلّ واحد منها في اطار
دائرته الخاصة . يقول : «لا يحق لأحد من العلماء في هذه العلوم الثلاثة أن يطعن في
الآخر ، ولا ينبغي للإنسان إذا جهل علما أن يكذّبه ويتطاول على صاحبه» (28) ، من دون أن يعني ذلك «تنزيها لجميع الفلاسفة أو
كلّ العرفاء أو الفقهاء كافة» (29).
مع وعي الإمام لطبيعة الصراع الذي نشب ولا يزال في أروقة الفكر القرآني حيث
انقسمت الساحة إلى تيارات ، أبرزها تياران أحدهما يقف على رأسه طائفة من الفلاسفة
والعرفاء ويرمي الآخر بالقشرية ، والثاني يقف على رأسه طائفة من المتكلمين والمحدّثين
والفقهاء ويرمي الأوّل بالكفر والزندقة أو بالزيغ والتبديع ، إلّا أنّ الإمام يسعى
للتخفيف من وطأة هذا الاستقطاب ، عبر وسائل متعدّدة أبرزها عدم ضرب شرعية أي واحد
منهما ، وتصحيح مسار عمل كلّ تيار لكن في إطار مبانيه ومنطقة عمله وفي نطاق مرتبة
الفهم التي تتّسق ومرتكزاته. في واحد من أقدم النصوص نقرأ للإمام قوله على هذا
الصعيد : «ينبغي أن يعلم بأنّ هذه المعارف ، بدءا من معرفة الذات حتّى معرفة
الأفعال ، قد ذكرت في هذا الكتاب الإلهي الجامع بصيغة بحيث تدركها كلّ طبقة على
قدر استعدادها. فآيات التوحيد الشريفة خاصة توحيد الأفعال ، قد فسّرها علماء
الظاهر والمحدّثون والفقهاء- رضوان اللّه عليهم- وبيّنوها بشكل يختلف كليا ويتباين
مع تفسير أهل المعرفة وعلماء الباطن لها.
والكاتب [يعني نفسه] يعدّ كلا التفسيرين صحيح في محلّه» (30).
ثمّ نصوص اخر سيأتي عرضها لاحقا ، تلتقي في الدلالة ذاتها ، لتفيد أنّ
الإمام بتبنّيه الفلسفة والعرفان لا يصادر مشروعية المناهج الاخرى ، بل الأهم أنّه
تحرّك أوائل العقد الأخير من عمره باتجاه مشروع مصالحة بين أبرز ثلاث منهجيات
تتقاسم المعرفة الإسلامية متمثّلة بطرق الفلاسفة والعرفاء والفقهاء انطلاقا من
التفسير ذاته ، في محاولة تعيد إلى الأذهان طموحات المشروع الصدرائي على هذا
الصعيد.
أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني من الإشكالية فقد مرّ أنّ العرفان يطلق عند
الإمام مرّة ويراد منه صفة تصبغ التفسير بجميع اتجاهاته بالطابع المعنوي والأخلاقي.
وعندئذ فهو ليس قسما في مقابل بقية الأقسام ولا اتجاها بإزاء الاتجاهات
الاخرى ، بل هو قسيما لها بأجمعها. وهنا لا مشكلة ، ولا موضع للإشكالية المطروحة.
وعند ما يطالب الإمام حركة التفسير أن تكون ذات طابع معنوي أخلاقي أو عرفاني فهو
يعني العرفان بمعناه العام.
أمّا المعنى الثاني فهو الذي يكون فيه العرفان منهجا بإزاء بقية المناهج
التفسيرية ، وعندئذ تنبثق الإشكالية ويكون لها موقعها المعقول. الحقيقة الناصعة
التي نتبيّنها من النصوص أنّ الإمام نفسه لا يألو جهدا في نقد المنهج العرفاني إذا
تحوّل إلى اتجاه آحادي ونزعة متضخمة على حساب الأبعاد والمكونات الاخرى ، تماما
كما يفعل مع البقية. يقول في نص له دلالة على الإشكالية بشقّيها : «لقد مرّت علينا
أزمنة كانت فيها طائفة من الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين وأمثال ذلك تسعى وراء
الجهات المعنوية. فقد أخذ هؤلاء بعد المعنويات كلّ واحد بقدر إدراكه ، وخطّئوا
القشريين. عدّت هذه الطوائف كلّ ما عداها قشريا وقامت بتخطئته ، حتّى أنّها عند ما
بادرت إلى تفسير القرآن عطفت أكثر الآيات- إن لم يكن كلها- صوب تلك الجهات
العرفانية والفلسفية والمعنوية ، وغفلت بشكل تام عن الحياة الدنيوية وعن الجهات
التي تمسّ إليها الحاجة هنا ، وأهملت ضروب التربية التي ينبغي لها أن تتم في هذه
الحياة.
لقد توجّه اولئك بحسب اختلاف مسالكهم ، نحو المعاني تلك التي تأتي أرفع من
إدراك عامة الناس- مثلا- ثمّ عمدوا إلى تخطئة كلّ من سواهم.
في هذا العصر وفي الأوان ذاته بادرت مجموعة اخرى من المشتغلين بالأمور
الفقهية والتعبدية إلى تخطئة اولئك ، مع أنّ هذين الأسلوبين كليهما كانا خلاف
الواقع.
فهؤلاء حصروا الإسلام بالأحكام الفرعية ، واولئك حصروه بالأمور المعنوية وبما
فوق الطبيعة. اولئك يظنّون أنّ ما فوق الطبيعة هو كلّ شيء ، وهؤلاء يظنّون أنّ
أحكام الطبيعة والفقه الإسلامي هو كلّ ما موجود ، وما عداه لا شيء» (31).
نص كثيف الدلالات ، مركّز في معناه ، واضح في منطوقه لا إبهام فيه. يعالج
الإشكالية المثارة بشقّيها على نحو واف. فالإمام لا يؤمن بلغة النفي والإلغاء بين
مناهج المعرفة الإسلامية ، كما لا يوفّر المنهج العرفاني والفلسفي في التفسير من
النقد إذا ما أسرف وتطرف.
على المنوال ذاته وبعد عامين من تأريخ النص السابق عاد الإمام إلى عرض
المسألة نفسها لكن من دون طرح الاستقطاب بين المناهج المختلفة ، إنّما ركّز هذه
المرّة على اختزال منهج العرفاء للقرآن بالمعاني العرفانية وحدها وإهمال بقية
الأبعاد. قال سماحته في نص نقدي يعود إلى أواخر عام 1979 م : «كنّا في مدّة مبتلين
بطبقة من الناس ، وبطبقة من أهل العلم ينظرون إلى الإسلام من ذلك الطرف.
يؤمن العرفاء بالإسلام ويرتضونه ، بيد أنّهم يرجعون المسائل بتمامها إلى
تلك المعاني العرفانية ، ولا يذعنون إلى المسائل اليومية المعاصرة ، فحتى لو جاءت
آية أو رواية في الجهاد يحملونها على جهاد النفس ، يصيّرون للإسلام صورة اخرى غير
صورته الواقعية الشاملة ، التي تحوي جميع الأبعاد. قلت : إننا لمدّة من الوقت كنا
مبتلين بأولئك. طبيعي هم اناس صالحون ، لكنّهم ينظرون إلى الإسلام من زاوية واحدة
، ومن خلال بعد واحد» (32).
إنّ الإمعان ببعد واحد وتضخيم اتجاه بعينه على حساب تعطيل بقية الأبعاد ، يفضي
إلى استقطاب سلبي وإثارة ردود متطرفة بالاتجاه المعاكس. وحين يتم التركيز على
الجانب العرفاني على نحو مضخّم ، فمن المتوقّع أن تبرز ردود فعل متطرّفة تستهين
بالجانب المعنوي وتهمّشه وربما تلغيه لحساب تضخيم الجانب المادي.
هذا الاستقطاب السلبي الناشئ عن تضخّم بعد من الأبعاد والتركيز المفرط على
اتجاه معيّن من اتجاهات التفسير هو الاتجاه العرفاني بالتحديد هو الذي دفع الإمام
إلى تحليل الحالة ونقدها في نص مطوّل ، قال فيه : «مع الأسف ابتلينا في فترتين
زمنيتين بطائفتين ، ففي وقت كنا مبتلين بجماعة عند ما تنظر إلى القرآن وتفسّره
تعمد إلى تأويله ، إذ هي لا تعتني أساسا بجهته المادية وببعده الدنيوي ، بل هي
ترجعه بأجمعه إلى ضرب من المعنويات حتّى القتال. فعند ما يذكر القرآن القتال؛
القتال مع المشركين ، يبادر اولئك لتأويله إلى قتال النفس. هم يؤولون الأشياء التي
لها علاقة بالحياة الدنيوية إلى المعنويات. لقد أدرك اولئك بعدا من القرآن هو بعده
المعنوي ، لكن بشكل ناقص. فهم تعاطوا مع بعد القرآن المعنوي وأرجعوا إليه جميع
الجهات.
ثمّ ابتلينا بعد ذلك بردّ فعل على الاتجاه الأوّل ، هو الموجود الآن ، حيث
تجسّد هذا المعنى منذ مدة. فبإزاء تلك الطائفة التي تؤول القرآن والحديث إلى ما
وراء الطبيعة ، وتهمل الحياة الدنيا تماما ، وما له صلة بالحكومة الإسلامية وبالأبعاد
التي تمسّ الحياة ، نرى أنّ الطائفة الثانية تفعل العكس ، إذ هي ضحّت بالمعنويات
أمام الماديات.
اولئك ضحّوا بالماديات فداء للمعنويات ، وهؤلاء ضحّوا بالمعنويات فداء
للماديات ، إذ تراهم يعمدون إلى كلّ آية تصل أيديهم إليها فيوجهونها بأمر دنيوي ما
استطاعوا ، وكأنّ لا شيء وراء الدنيا.
أمّا اولئك فكأنّ في نظرهم لا شيء ما وراء عالم الغيب. إنّ كلام اولئك
صحيح في حدودهم وبحسب ما عندهم. أمّا هؤلاء فعقيدتهم فيما يطرحونه من مسائل أنّه
لا شيء- ولا خبر- ما وراء هذا العالم [الطبيعي] فيضحّون بجميع المسائل في سبيل
هذا العالم» (33).
بالإضافة إلى ما يحظى به هذا النص من أهمّية في نقد الاتجاه العرفاني حين
يراد له أن يكون اتجاها لاغيا لبقية الأبعاد والمكوّنات ، فهو يتوجّه بالنقد أيضا
إلى نقد اتجاه آخر من الاتجاهات الآحادية- بل لنقل الإسقاطية أو التحميلية على نحو
أدقّ- هو الاتجاه الطبيعي الذي يعطي الأصالة في الوجود للمادة وخواصّها المحسوسة ويألف
العلوم الناتجة عنها ، ثمّ يعمد إلى تأويل كبريات حقائق القرآن الغيبية والمعنوية
بما لا يخرج عن مألوف القوانين المادية ولا يصطدم معها .
خلاصة القول أنّ الإمام لا يتوانى عن نقد الاتجاهات الآحادية في التفسير
مهما كانت منطلقاتها ، مركّزا في النقد على زوايا متعدّدة ، منها :
1- عدم العناية بمقصد أو مقاصد القرآن ، والانهماك ببحوث فرعية وتفصيلات
ثانوية بعيدة عن مقصد صاحب الكتاب أو خارجة عنه أساسا.
2- اعتماد التفسير العرفاني كاتجاه آحادي ، وعدم الاعتناء بالأمور الدنيوية
والمادية أو بالعكس.
3- الاستناد إلى اتجاه أو منهج واحد في التفسير ، وتكفير البقية أو تفسيقهم
.
4- الجمود على الظواهر اللغوية وأوائل المفهومات ، وعدم الغوص في المراتب
التالية لمعاني القرآن (34).
هناك أيضا زوايا نقدية اخرى عرض لها الإمام نستوفي الحديث عنها في الفصل
القادم ، الذي يتناول التفسير بالرأي بإذن اللّه.
_________________________
(1)- تفسير سورة حمد : 93- 95 ، راجع : منهجية الثورة الإسلامية : 93- 95.
(2)- صحيفه امام 19 : 112.
(3)- يركّز الاتجاه الموضوعي في التفسير على أهمّية انفتاح المفسر على
المعرفة البشرية ، بل أهمّية استقصاء موقفها واستيعابه بالنسبة إلى الموضوع
المدروس ، ثمّ ينتقل إلى القرآن يستنطقه . بيد أنّه يحذّر من اسقاط هذه المعرفة
على القرآن وصبغ مدلولاته بلونها. ينظر : المدرسة القرآنية : 19 ومواضع اخرى .
أيضا تفسير موضوعي قرآن مجيد 1 : 74.
(4)- شرح حديث جنود عقل وجهل : 38.
(5)- صحيفه امام 14 : 387.
(6)- نفس المصدر.
(7)- نفس المصدر 15 : 504.
(8)- نفس المصدر.
(9)- نفس المصدر 17 : 381.
(10)- نفس المصدر : 381- 382.
(11)- نفس المصدر 8 : 437- 438.
(12)- نفس المصدر : 438.
(13)- نفس المصدر.
(14)- آداب الصلاة : 194- 195 ، منهجية الثورة الإسلامية : 101.
(15)- بالمعنى الأعم الذي يشمل معرفة المبدأ والمعاد والسير فيما بينهما ، مع
التركيز خاصة على معرفة اللّه ذاتا وأسماء وصفاتا وأفعالا ، وتقديم شأن المعرفة
الأنفسية على المعرفة الآفاقية.
(16)- جلوههاى رحماني : 24.
(17)- صحيفه امام 17 : 430- 431.
(18)- نفس المصدر 8 : 438.
(19)- نفس المصدر 17 : 434.
(20)- نفس المصدر : 457.
(21)- انتهى من تأليفه عام 1347 هـ.
(22)- انتهى من تأليفه 25 شوال 1349 هـ.
(23)- انتهى من تأليفه 4 محرم 1358 هـ.
(24)- انتهى من تأليفه 21 ربيع الثاني 1358 هـ.
(25)- انتهى من تأليفه 2 ربيع الثاني 1361 هـ.
(26)- شرح چهل حديث : 660.
(27)- راجع مثلا : شرح چهل حديث : 190. كذلك قوله : «يزعم بعض علماء
الظاهر- الفقهاء- إنّ العلوم العقلية والباطنية والمعارف الإلهية من الكفر والزندقة».
الأربعون حديثا : 412. كما راجع أيضا : آداب الصلاة ، مواضع متعدّدة ، منها الصفحة
166 ، 168.
ربما كان الأوضح من ذلك كله ، قوله : «و أوصيك أيها الأخ الأعز ، أن لا
تسوء الظنّ بهؤلاء العرفاء والحكماء الذين كثير منهم من خلّص شيعة علي بن أبي طالب
وأولاده المعصومين عليهم السّلام ... وإياك أن تقول عليهم قولا منكرا». مصباح
الهداية إلى الخلافة والولاية : 36 ، وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في بحوث
الفصل السابع إن شاء اللّه.
(28)- الأربعون حديثا : 413.
(29)- تفسير سورة حمد : 176.
(30)- آداب الصلاة : 185.
(31)- صحيفه امام 3 : 221.
(32)- نفس المصدر 10 : 459.
(33)- نفس المصدر 11 : 216- 217.
(34)- راجع : مجلة پژوهشهاى قرآنى ، المزدوج 19- 20 : 124- 163 ، إمام خميني ، قرآن وتفسير.
 الاكثر قراءة في مفهوم التفسير
الاكثر قراءة في مفهوم التفسير
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











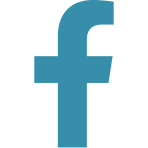

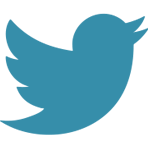

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)