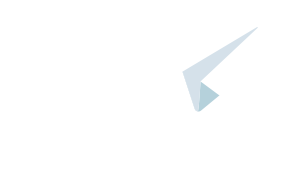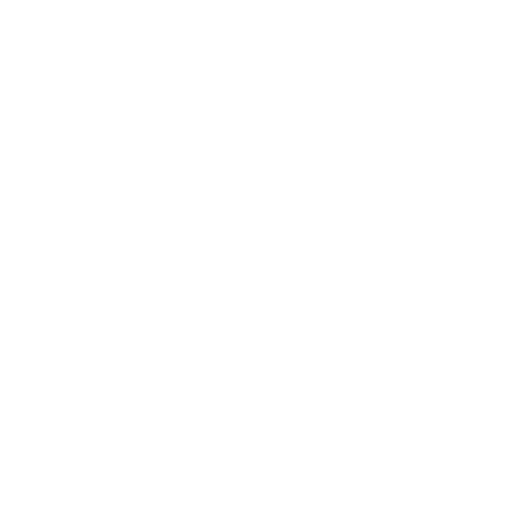المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
هل ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصحيحة او للاعم ؟
المؤلف:
الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر:
أصول الفقه
الجزء والصفحة:
ج1، ص: 46
9-7-2020
3447
[فى كون الفاظ العبادات موضوعة للصحيحة او للاعم]
قد اختلف في كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة أو للأعمّ منها ومن الفاسدة؟ وتصوير هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة واضح؛ فإنّه يقع النزاع حينئذ في أنّ المعنى المنقول إليه هل هو خصوص الصحيح أو الأعمّ، وأمّا على عدم الثبوت فأصل الاستعمال في خصوص الصحيح وفي الأعمّ مسلّم، فيمكن النزاع حينئذ في أنّه هل يكون في البين قرينة منضبطة عامّة غير محتاجة إلى التصريح بها في كلّ مورد مورد على تعيين أحد من المعنيين بحيث يحمل اللفظ بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي على هذا الأحد إلى أن يعلم بإرادة الآخر.
ويمكن تصوير النزاع أيضا على قول الباقلاني في أنّ القرينة المنضبطة العامّة المفهمة للخصوصيات الزائدة على المعنى اللغوي كالانصراف الإطلاقي المفهم للخصوصيّة الزائدة على الطبيعة هل تحقّقت ولو بعد مدّة يحصل الشهرة المولدة للانصراف فيها على تمام الأجزاء والشرائط أو على الأعمّ.
و العمدة في هذا المبحث تصوير الجامع بين أفراد كلّ من عنواني الصحيح والأعمّ قبل الشروع في النزاع؛ فإنّ المقصود إثبات الاشتراك المعنوي بين أفراد الصحيح أو الأعمّ لا اللفظي.
فنقول: لا يكاد يمكن تصوير الجامع المركب بين الأفراد الصحيحة؛ فإنّ أفراد الصلاة مثلا ذات قيود متقابله، فبعضها ثنائيّة ليس إلّا بحيث لو زيد ركعة لبطل، وبعضها ثلاثيّة كذلك، وبعضها رباعيّة كذلك، وشأن الجامع أن يكون مجرّدا عن جميع الخصوصيّات، فإذا قطع النظر عنها في المقام بقي ركعتان لا بشرط مثلا، وهذا قد ينطبق على الصلاة الصحيحة كصلاة الصبح والمسافر، وقد ينطبق على الفاسدة كصلاة الظهر للحاضر إذا سلّم على الثانية عالما، أو الصبح إذا سلّم على الثالثة أو الرابعة كذلك.
وأمّا الجامع البسيط فيمكن تصويره؛ لإمكان أن يكون بين أفعال مختلفة مقيّدة بقيود متضادّة بالإضافة إلى فاعلين مختلفين- كالصلوات المختلفة المقيّدة بعضها بالقيام وبعضها بالقعود وبعضها بالزيارة على الركعتين وبعضها بعدمها في حقّ المختار والمضطرّ والحاضر والمسافر- جامع واحد، ولا ضير في الالتزام به في المقام بعد وجدانه في نظيره؛ فإنّ التعظيم يختلف الحال فيه بالاضافة إلى الفاعلين، فبالإضافة إلى فاعل لا يحصل إلّا بالقيام وبالإضافة إلى آخر لا يحصل إلّا بالقعود، وبالإضافة إلى ثالث لا يحصل إلّا بالاضطجاع؛ فإنّ المريض الذي يشقّ عليه القيام أو القعود يعدّان في حقّه تكلّفا زائدا لا تعظيما، وبالإضافة إلى رابع لا يحصل إلّا بحطّ الظهر وهكذا، بل الالتزام بذلك في المقام متعيّن؛ إذ اشتراك تلك المتشتّتات في الأثر الواحد يقتضي أن يكون منتهية إلى جامع واحد يستند هذا الأثر إليه بناء على ما قرّر في المعقول من أنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، ولا ضير في عدم معرفتها بحقيقة هذا الجامع بعد إمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره كوصف كونه ناهيا عن الفحشاء ونحوه.
لكن يرد عليه إشكالان:
الأوّل: أنّه مخالف لظواهر الأخبار المشتملة على أنّ الصلاة أوّلها التكبير وآخرها التسليم، وللمركوز في أذهان المتشرّعة من أنّ الصلاة اسم للمجموع المركّب من الأفعال الخاصّة لا لعنوان بسيط منتزع عنها.
الثاني: إنّه يستلزم أن يكون الصحيحي عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته قائلا بالاحتياط مع أنّ المشهور القائلين بالوضع للصحيح قائلون بالبراءة، بيان الملازمة أنّه على هذا ليس مورد الأمر هو المركّب حتّى يعتذر العبد عند مولاه عن عدم الإتيان بالجزء أو الشرط المشكوكين بأنّي وقفت على وجوب هذا المقدار وقد اتيت به، وشككت في وجوب الباقي، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بل مورده شيء وحدانيّ بسيط، غاية الأمر أنّ محصّله هو المركّب، فالمأمور به دائر بين الوجود والعدم، فالمكلّف ما لم يأت بجميع المحتملات لم يعلم بأنّه أتى بالمأمور به أو لا، وليس له مقدار حتّى يقول: بأنّى قد أتيت بالقدر الذي علمت وجوبه، والباقي لم أعرف وجوبه.
وردّ هذا الإشكال في الكفاية بالفرق بين ما إذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسبّبا عن المركّب، وبين ما إذا كان أمرا بسيطا منتزعا عنه وتكون المركبات أفرادا له، ففي الأوّل يكون الحال كما ذكر، كما في الطهارة المسبّبة عن الغسلتين والمسحتين، فلو شكّ في أنّ الغسل من الأعلى إلى الأسفل له دخل في السبب المحصّل للطهارة يجب الإتيان به لما ذكر، وفي الثاني ينحّل الأمر بالعنوان البسيط إلى الأمر بأفراده، ففي الحقيقة يتعلّق الأمر بالمركّبات، فيكون حاله كما إذا تعلّق الأمر بالمركّب ابتداء.
ويمكن أن يقال: إنّه فرق بين ما إذا كان مركب الأمر هو المركّب ابتداء، وبين ما إذا كان هو العنوان المنطبق عليه، ففي الأوّل لعلّه يمكن أن يقول العبد: إنّ المقدار المعلوم وجوبه قد أتيته والزائد كان مشكوك الوجوب، ولم يكن أمر آخر وراء المركّب مطلوبا بالفرض، وأمّا في الثاني فالحجّة بين العبد ومولاه وما هو مؤاخذ ومسئول عن فعله وتركه هو العنوان لا المركّب، فيجب بحكم العقل أن لا يكتفي بالمقدار المعلوم بل يأتي بمقدار علم أنّه فرد للعنوان، فالأمر الانحلالي يتعلّق بالمركّب بعنوان أنّه فرد لهذا العنوان.
فهنا أمر آخر وراء المركّب يجب إحرازه وهو كونه فردا للعنوان، أ لا ترى أنّه لو قال المولى اشرب السكنجبين لم يكن له السؤال إلّا عن شرب السكنجبين، فلو شرب جرعة وشكّ في وجوب الجرعة الثانية فتركها فتبيّن دخلها في الغرض كان له الاعتذار بأنّي لم أعرف وجوبها، وأمّا لو قال: اشرب مزيل الصفراء فحينئذ لا يسأل عن شرب السكنجبين، بل عن شرب المزيل للصفراء فهل يرتبط بهذا السؤال قوله: إنّى لم أعرف وجوب الجرعة الثانية إذا تبيّن دخلها في الإزالة.
وأمّا تصوير الجامع على قول الأعمّي فقد عدّه في الكفاية في غاية الإشكال، وحاصل ما يرد عليه من الإشكال أنّه لا شكّ أنّ أجزاء الصلاة مثلا أشياء متباينة فلا بدّ أن يضمّ الواضع بعضها إلى بعض في اللحاظ ويلاحظ المجموع شيئا واحدا ويضع اللفظ بإزائه، فهذا المجموع الملحوظ بلحاظ واحد إمّا أن يكون تمام الأجزاء أو البعض، ويكون الباقي أجزاء للمأمور به دون المسمّى، فإن كان الأوّل لزم أن لا يكون الصلاة بلا ركوع صلاة عند الأعمّي وهو مقطوع العدم، وإن كان الثاني فالبعض إمّا أن يكون بعضا معيّنا كأن يعيّن من بين أجزاء الصلاة الأركان المخصوصة مثلا فيرد عليه إشكالان:
الأوّل: يلزم أن تكون الصلاة التامّة الأجزاء مركّبة من الصلاة وغيرها لا أن يكون تمامها الصلاة ولا يلتزم به الأعمّي، ودعوى أنّ اعتبار الأركان لا بشرط يدفع هذا، مدفوعة بأنّ معنى كونها لا بشرط أن لا ينافي وصف موضوعيّتها وجود بقيّة الأجزاء، لا أن يكون الموضوع له على تقدير وجود البقيّة هو المجموع، أ لا ترى أنّ المعجون المركّب من الترياق وغيره المحصّل لغرض واحد لا يطلق اسم الترياق إلّا على جزئه المخصوص دون المجموع.
الثاني: يلزم أن لا تكون الصلاة الفاقدة لبعض الأركان الواجدة لسائر الأجزاء أو أكثرها صلاة، والأعمّي غير ملتزم به أيضا.
وإمّا أن يكون بعضا مردّدا كأن يضع لفظ الصلاة بإزاء خمسة أجزاء مردّدة بين خمسة عشر جزء، وهذا مضافا إلى أنّه يستلزم أن يكون جزءا داخلا في المسمّى تارة وخارجا عنه اخرى، بل مردّدا بين أن يكون داخلا وأن يكون خارجا فيما إذا كانت الصلاة واجدة لتمام الأجزاء، وهو من الركاكة بمكان يرد عليه الإشكال الأوّل من الإشكالين.
وأمّا الشرائط فليس حالها حال الأجزاء؛ إذ لو فرض الفراغ من جهتها وكون عشرة أجزاء صلاة، فلا يفرق الحال فيها بين أن تكون مستقبلة أولا، فلا يصير العشرة بالاستقبال أحد عشر، فلا يستلزم إخراج الشرط عن المسمّى أن تكون الصلاة معه صلاة مع الزيادة.
ويمكن أن يقال: إنّه لا شكّ أنّ أفعالا متعدّدة إذا اتي بها لغرض واحد كتصحيح المزاج- كعمل الزورخانه- يطرأ عليها وحدة اعتباريّة، ولهذا إذا أتى بعدّة منها ولم يأت بالباقي يقول: قد أوصلت شغلي إلى النصف، كما أنّه إذا أتى بتمامها يقول: قد أتممت شغلي، مع أنّ ما أتى به ليس شيء منه منصّفا، والباقي لم يأت به أصلا، فلو لم يكن وحدة لم يصحّ ذلك، وكما أنّ الوحدة الحقيقيّة الشخصيّة الموضوع لها الأعلام الشخصيّة ويعبّر عنها بالمادّة لا تنثلم بكثرة اختلاف الحالات من الطول والقصر وزيادة جزء ونقيصة وتغيير شكل ونحوها، بل هي باقية في جميعها، وتلك الحالات كيفيّات وصور يطرأ عليها على التبادل، فكذا هذه الوحدة الاعتباريّة أيضا محفوظة في جميع الحالات من حالة الإتيان بفعل واحد من تلك الأفعال إلى أن يكمل تمامها، لكن مع إحراز الغرض في الجميع بأن يكون داعي الفاعل في الجميع هو الغرض الواحد، فهذه الوحدة بمنزلة المادّة في الأشخاص، وهذه الاختلافات بمنزلة الصور الطارئة عليها.
فنقول: لا شكّ أنّ الأعمّي يتسلم أنّه إذا أتى بكلّ فعل من أفعال الصلاة لغرض لم يكن ذلك بصلاة، فيبقى الصور المختلفة غاية الاختلاف في الكيفيّة المتّحدة في الغرض، فيكون فيها وحدة اعتباريّة ناشئة من جهة وحدة الغرض، وهي محفوظة في جميع تلك الصور، فهذه الوحدة معروضة للصحّة والفساد والتمام والنقص، لكن ليس الغرض الواحد مطلقا كافيا؛ فإنّ الإتيان بأفعال الصلاة بغرض واحد مثل تحليل الغذاء أو بغرض السخريّة والاستهزاء، كما لو اجتمع جماعة من الكفّار فأقاموا الصلاة جماعة استهزاء بأهل الإسلام، فلا يصدق اسم الصلاة في العربيّة و(نماز) في الفارسيّة على هاتين، فليس في البين سوى المركّب، غاية الأمر أنّه لم يلحظ على نحو التفصيل، بل على نحو الإجمال والبساطة، بخلاف الجامع البسيط على قول الصحيحي فإنّه أمر منتزع عن المركّب.
بل يمكن إدّعاء أنّ وجود الجامع بين الصحيح والفاسد بديهيّ، أ لا ترى صحّة التقسيم إليها، فيقال: الصلاة إمّا صحيحة وإمّا فاسدة؛ فإنّه وإن سلّمنا كونه من باب التقسيم إلى الحقيقة والمجاز، لكنّه لا يتصوّر بدون وجود مقسم جامع بين القسمين، وأيضا فالصحيحي يتسلّم أنّ استعمال هذه الألفاظ في الفاسد صحيح مجازا، ولا شكّ أنّه لا بدّ أن يكون بين الحقيقة والمجاز جهة جامعة يعبّر عنها بالعلاقة، كالشجاعة الجامعة بين الأسد والرجل الشجاع، والأعمّي يقول بأنّ هذه الجهة الجامعة هي مسمّى اللفظ.
وكيف كان فهل الأمارات المميّزة للحقيقة عن المجاز من التبادر وعدم صحّة السلب مؤدّية إلى الوضع للصحيح أو الأعمّ؟ الكلام في ذلك أنّه من المعلوم أنّ المنسبق إلى أذهان المتشرّعة من لفظ الصلاة مثلا هو المركّب من الأفعال المخصوصة، لا العنوان البسيط المنتزع عنها، وقد عرفت أنّ الجامع المركّب لا وجود له بين الأفراد الصحيحة، فيكون هذا التبادر شاهدا للأعمّي، وأيضا من المعلوم بالرجوع إلى الوجدان أنّ سلب الصلاة عن الفاسدة يحتاج إلى العناية وليس كسلب الحجر عن الإنسان بل كسلب الإنسان عن البليد، فظهر أنّ التبادر وعدم صحة السلب كلاهما مع الأعمّي وإن استدلّ بهما للصحيحي، وهما العمدة في أدلّة الطرفين، وسائر ما ذكروه غير خال عن الخدشة.
[الاستدلال للصحيحي]
منها ما ذكر في الكفاية دليلا على قول الصحيحي من مثل «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و«الصوم جنّة من النار» ممّا ظاهره تعليق الآثار على المسمّيات، فإنّ ظاهره بحكم عكس النقيض أنّ كلّ ما ليس بعمود وجنّة فليس بصلاة وصوم، ومن المعلوم أنّ الفاسدة ليس كذلك؛ فإنّ من المعلوم ابتناء هذا الاستدلال على كون وجود الإطلاق في هذه القضايا وابتناء ذلك على كونها واردة في مقام البيان وهو ممنوع؛ إذ من الواضح أنّها واردة في مقام الإهمال، نظير قول الطبيب: الدواء الفلاني نافع للداء الفلاني، فالمقصود بها بيان حكم الطبيعة في قبال الطبائع الأخر، فيكون المعنى أنّ الصلاة لا غيرها من العبادات عمود الدين، وليست في مقام بيان أزيد من ذلك حتّى يكون لها إطلاق.
[الاستدلال للأعمّي]
ومنها: الاستدلال للأعمّي بقوله عليه السلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أنّ أحدا صام نهاره، وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة.
حيث استعمل لفظ الأربع في قوله: فأخذ الناس بأربع، وكذا لفظ صام في قوله: فلو أنّ أحدا صام في الفاسدة، لفساد عبادات منكري الولاية، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وفيه أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، والمتيقّن من مورد أصالة الحقيقة هو الشبهة المراديّة.
ومنها الاستدلال له أيضا بقوله عليه السلام: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فإنّ لفظ الصلاة مستعملة في الفاسدة لعدم قدرة الحائض على الصحيحة، وفيه مع ما عرفت أنّ المجاز هنا لازم على كلا القولين، أمّا على القول الصحيحي فواضح، وأمّا على قول الأعمّي فلأنّ لفظ الصلاة مستعملة في خصوص الفاسد من جهة اختلال شرط الطهارة من الحيض؛ لظهور أنّ الصلاة الفاسدة من غير هذه الجهة أيضا غير منهي عنها في حقّ الحائض، فيكون من باب استعمال لفظ العام في الخاص.
ودعوى أنّ الفساد من هذه الجهة إنّما جاء من قبل هذا النهي فهو متأخّر عنه فكيف يؤخذ فى موضوعه، مدفوعة بأنّ النهي كاشف عن الفساد الواقعي الغير المعلوم لنا قبل وروده لا محدث له حتّى يرد ما ذكر.
ومنها الاستدلال له أيضا بأنّه لو نذر أن لا يصلّي في الحمّام لزم على قول الصحيحي أن لا يحنث بالصلاة فيه؛ لأنّ متعلّق النذر هو الصلاة الصحيحة، والصلاة فيه بعد هذا النذر فاسدة لتعلّق النهي بها، فلم يحصل منه مخالفة النذر، وأيضا يلزم من فسادها صحّتها وبالعكس؛ لأنّ فسادها إنّما جاء من قبل حصول الحنث بها، فإذا لم يحنث بها تكون صحيحة؛ لأنّها صلاة تامّة الأجزاء والشرائط ولم يحصل بها حنث النذر، فيلزم من صحتها حصول الحنث بها فتكون فاسدة وهكذا، والأعمّي سالم من المحذورين كما هو واضح.
أقول: الفروع الوارد عليها إشكال لزوم الوجود من العدم وبالعكس كثيرة.
منها: ما لو أذن مالك الماء لغيره في التصرّف فيه كيفما شاء واستثنى رفع الجنابة به ونهى عنه، فحينئذ لو اغتسل المأذون في هذا الماء عن جنابة بطل غسله لتعلّق نهي الشارع به تبعا لنهي المالك فلا يحصل به الرفع، فإذا لم يحصل به الرفع والمفروض أنّ الفساد إنّما جاء من قبل حصول الرفع يكون صحيحا فيحصل به الرفع فيكون فاسدا، وهكذا يلزم من عدم حصول الرفع حصوله ومن عدم صحّة الغسل صحّته وبالعكس.
ومنها: ما لو كان عليه قضاء خمسة أيّام مثلا من رمضان وقلنا بعدم جواز تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان الآتي فبقي ما بينه وبين رمضان خمسة أيّام فسافر وقلنا بعدم صحّة الصوم في السفر، فإنّ السفر حينئذ مفوّت للواجب المضيّق فيكون سفر المعصية فيجوز فيه الصوم فلا يلزم تفويت، فإذا لم يلزم تفويت والمفروض أنّ حرمة السفر إنّما جاء من قبله كان السفر مباحا فلا يصحّ فيه الصوم فيلزم التفويت فيكون السفر حراما، وهكذا يلزم من عدم صحّة الصوم صحّته، ومن لزوم التفويت عدم لزومه، ومن حرمة السفر عدم حرمته وبالعكس.
والجواب أمّا عن الأوّل فبأنّ لفظ الصلاة عند الصحيحي موضوع للصحيح بمعنى المشتمل على تمام الأجزاء والشرائط، والصّحة بهذا المعنى لا ينافيها الفساد العارضي من جهة النذر أو نهي الوالد مثلا، والدليل على أنّ مرادهم بالصحّة هذا المعنى أنّ الفساد الطاري إنّما نشأ من قبل الحكم، فهو متأخّر عنه فكيف يؤخذ عدمه في موضوعه، وحينئذ فإن أراد الناذر المذكور الصحّة بهذا المعنى لم يلزم شيء من المحذورين كما هو واضح، وإن قصد الصحّة من جميع الجهات حتّى من جهة الطواري فنلتزم بعدم انعقاد نذره؛ إذ الصلاة الصحيحة من جميع الجهات مأمور بها فلا يمكن أن تصير منهيّا عنها.
وأمّا عن الثاني فبأنّه إن كان نهي المالك عن إحداث أسباب حصول الرفع ومقدّماته بمائه من غسل الأعضاء على النهج المخصوص بقصد الرفع مع نيّة القربة فلا شكّ في تأثيره في تحريم الغسل وعدم حصول الرفع به، ولا يلزم محذور كما هو واضح، وإن كان نهيه عن رفع الجنابة الذي هو أثر للغسل بجعل الشارع فلا يؤثّر شيئا؛ إذ الغسل الرافع للجنابة مأمور به فلا يعقل أن يصير منهيّا عنه وغير رافع.
وأمّا عن الثالث، فاعلم أنّ هنا أدلة ثلاثة لا بدّ من رفع اليد عن أحدها حتّى يرتفع الإشكال، ومع الأخذ بجميعها لا يمكن التفصّي عنه.
الأوّل: دليل عدم جواز تأخير قضاء رمضان عن رمضان المقبل، وهذا موجب لحصول التضييق في الصوم في المثال
الثاني: دليل عدم صحّة الصوم في السفر، وهذا بضميمة الأوّل يوجب مفوّتيّة السفر للصوم فيه
والثالث: دليل كون سفر المعصية مبيحا للصوم
فرفع اليد عن أحد الأوّلين يوجب رفع موضوع التفويت عن البين، وعن الأخير يوجب حصوله بلا لزوم إشكال كما هو واضح.
فنقول: لا معارضة بين الأوّلين وبين الثالث؛ لكونهما محقّقين لموضوعه وهو سفر المعصية، وكلّ عام تحقّق موضوعه بالأخذ بظهور أو عموم دليل آخر فهو غير معارض لهذا الدليل الآخر؛ لكونه في طوله لا في عرضه، فإذا بقي الأوّلان بلا معارض تعيّن تخصيص دليل إباحة سفر المعصية للصوم بما إذا نشأ حرمة السفر من جهة سببيّته لترك الصوم بحكم العقل؛ فإنّ إباحة هذا السفر للصوم غير معقول للإشكال الذي ذكر.
ومن جملة ما استدلّ به للصحيحي أنّ ما هو محلّ للحاجة ومورد للفرض غالبا إنّما هو الصحيح التام الأجزاء؛ لأنّه هو الذي يترتّب عليه الأثر، فينبغي وضع اللفظ بإزاء خصوصه، وهو الذي استقرّ عليه عادة الواضعين وديدنهم في وضع أسماء المعاجين، والغرض وإن كان يتعلّق بالفاسد أحيانا، لكنّه ليس بمثابة يقتضي وضع اللفظ للأعمّ فيكتفى بوضعه لخصوص الصحيح المصحّح للاستعمال في الفاسد مجازا، وهذا الاستدلال كما ترى إمّا راجع إلى الاستحسان أو إلى غلبة حال الواضعين، وعلى أيّ تقدير لا يفيد إلّا الظنّ باعتراف المستدلّ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئا.
[فى كون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة او للاعم]
بقي أمران:
الأوّل: هل النزاع المذكور في ألفاظ العبادات يجري في ألفاظ المعاملات كلفظ البيع والصلح والاجارة والنكاح والطلاق ونحوها أولا؟
توضيح ذلك يحتاج إلى تفصيل بأن يقال: إن كانت هذه الألفاظ موضوعة للآثار والمسبّبات كلفظ البيع للمبادلة فلا مجرى للنزاع فيها؛ إذا الأثر أمره دائر بين الوجود والعدم وليس في البين أمر يكون تارة جامعا للأجزاء والشرائط وتارة فاقدا ليطرأ عليه باعتبار ذلك وصف الصّحة والفساد.
وإن كانت موضوعة للأسباب كلفظ البيع للإيجاب والقبول فيصح النزاع في أنّها موضوعة للسبب التام الأجزاء والشرائط الغير المنفكّ عن الأثر أو للأعمّ منه ومن الناقص، فيكون القيود الزائدة معتبرة في التأثير لا في مسمّى اللفظ ولها دوالّ أخر.
لكن هنا إشكال وهو أنّ ثمرة هذه الأقوال إنّما تظهر في صحّة التّمسك بالإطلاق وعدمها، فعلى القولين الأوّلين لا يصح؛ إذ مفهوم اللفظ عليهما يصير مجملا، ففي كلّ مورد شكّ في دخل شيء في التأثير يكون الشكّ في أصل تحقّق الموضوع على الأوّل وفي تحققه بتمامه على الثاني، فلا مجال للتمسّك في نفيه بإطلاق الحكم؛ لأنّه فرع إحراز الموضوع.
وعلى القول الأخير يصحّ؛ إذ عليه لا إجمال في مفهوم اللفظ، ففي كلّ مورد شكّ في دخل شيء في التأثير زائد على عنوان المعاملة نتمسّك في نفيه بأصالة الإطلاق، مع أنّا نراهم قاطبة يتمسّكون في أبواب المعاملات في نفي ما يحتمل مدخليّته في التأثير بالإطلاقات، وفيهم من هو قائل بالوضع للسبب الصحيح قطعا.
ويمكن أن يقال بأنّه لا منافاة بين القول بالوضع للسبب الصحيح أو المسبّب وبين التمسّك بالإطلاق في موارد الشكّ في هذا الباب وإن كان بين قول الصحيحي، وبين التمسّك بالإطلاق منافاة في باب العبادات، ولا شكّ أنّ تصوير عدم المنافاة على القول بالوضع للمسبّب أشكل منه على القول الآخر، فنحن إذا بيّناه على هذا القول حصل المقصود على القول الآخر بالطريق الأولى، وقبل بيان ذلك لا بدّ من تحقيق أنّ هذه الألفاظ موضوعة بإزاء المسبّبات أو الأسباب؟
فنقول: الظاهر هو الأوّل وهو المستفاد في خصوص لفظ البيع من تعريف المصباح له بأنّه مبادلة مال بمال، ويدّل على ذلك أنّ من المعلوم أنّ معنى «بعت» مثلا إنشاء البيع، فلو كان معنى البيع هو الإيجاب والقبول لزم أن يكون البائع بهذا القول قد أنشأهما مع أنّ القبول قول أو فعل خارجي صادر من المشتري فليس قابلا لإنشاء البائع، وبعبارة اخرى ليس السبب في أبواب المعاملات إلّا الإنشاء، فإذا كان مفاد مادّة «بعت» هو السبب فيكون مفاد مجموع الهيئة والمادّة إنشاء الإنشاء وهو غير معقول.
فإن قلت: يلزم الإشكال على تقدير الوضع للمسبّب أيضا؛ إذا لمبادلة أثر لفعل الموجب والقابل معا، فكيف يقصد الموجب إنشائه بالإيجاب؟.
قلت: إنّما يقصد الموجب إنشاء المبادلة مع قطع النظر عن سببه وأنّه بم يتحقّق، غاية الأمر أنّ السبب صار اتّفاقا هو المركّب من الإيجاب والقبول، فلا ينشأ المبادلة المقيّدة بحصولها من هذا السبب حتّى يشكل بأنّه مع العلم بذلك كيف يمكن إنشائه بمجرّد الإيجاب، فهو قاصد لإنشاء نفس المبادلة، ويكون حاصله في نظره الإنشائي بمجرّد إنشائه، فيرى العمل البيعي حاصلا بتمامه من ناحيته فقط وإن كان ليس فردا للمبادلة بنظر العرف والشرع، فهو نظير الإيجاب الصادر من السائل؛ فإنّه ينشئه ويكون متحقّقا بنظره وإن كان تحقّقه بنظر العرف موقوفا على أمر غير حاصل في حقّه، وبالجملة فهذا يرجع إلى الاختلاف المصداقي في مفهوم المبادلة، فكما أنّ الغاصب يرى بيعه بنظره التنزيلي مبادلة وإن كان بنظره العرفي ليس كذلك، فكذا البائع أيضا يرى مصداق المبادلة موجودا بمجرّد الإيجاب بنظره الإنشائي وإن كان ليس بموجود بنظره العرفي.
امّا بيان عدم المنافاة فيحتاج إلى تقديم مقدمتين:
الاولى: لا شكّ أنّ بعض المفاهيم العرفيّة لا إجمال فيها أصلا ومع ذلك قد يقع الخلاف بينهم في تعيين مصاديقه كمفهوم البيع، فإنّه عند الجميع هو المبادلة المذكورة، لكن يمكن أن يكون هذا المفهوم حاصلا عند قوم بمجرّد المصافقة ويكون ذلك عند آخرين غير كاف في تحقّقه، فهذا ليس من باب الاختلاف في مفهوم البيع بل في أنّ مصداقه عقيب هذا الفعل موجود أم لا، فكما يمكن ذلك في حقّ العرف بعضهم مع بعض، فكذلك يمكن بين العرف والشرع بأن يكون مفهوم مبيّنا عند كليهما ووقع الخلاف بينهما في مصداقه، فحكم العرف بكون شيء مصداقا لهذا المفهوم، ولا يكون مصداقا بنظر الشرع كما في مفهوم الباطل؛ فإنّه مفهوم واحد بين العرف والشرع، لكن أكل المارّة يكون من أفراده بنظر العرف وليس كذلك عند الشرع، ويمكن العكس بأن يكون الشيء عند الشرع مصداقا دون العرف كما في الأكل المذكور، فإنّه مصداق لعنوان الحقّ عند الشرع دون العرف.
الثانية: أنّه لا بدّ أن يتعلّق الحكم في الخطابات الشرعيّة بتوسّط العنوان بالأفراد العرفيّة لا على وجه التقييد بل بأن ينزّل الشارع نفسه بمنزلة العرف وفرض نفسه كأنّه واحد من أهل العرف، فكما أنّ العرف لو علّقوا حكما على العنوان لا يكون في نظرهم إلّا الأفراد التي هي أفراد عندهم، فكذا الشارع أيضا يقع نظره بعد التنزيل المذكور على ما هو فرد بنظر العرف، فلو قال: الدم نجس، يحمل كلامه على الأفراد العرفيّة للدم، فلو كان شيء فردا للدم بنظر الحكيم كاللون بناء على امتناع انتقال العرض، ولم يكن عند العرف فردا يحكم بطهارته ولو كان فردا واقعا، والدليل على لزوم هذا التنزيل في حقّ الشارع أنّه لو لاه لزم نقض الغرض؛ إذ من المعلوم أنّ أخذ الغرض من كلّ قوم لا يحصل إلّا بتعليق الحكم على الأفراد التي هي أفراد بمذاقهم.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ مفهوم البيع مثلا مفهوم واحد عند الشرع والعرف وهو المبادلة على ما عرفت، فالاختلاف في بعض الموارد إنّما هو في مصداقه، ومقتضى المقدّمة الثانية أن يكون الحلّية الإمضائيّة في آية «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» متعلّقا بالأفراد العرفيّة، فيكون جميع ما هو فرد عند العرف مشمولا لهذا الحكم، فيكون المعنى أنّ كلّ ما هو فرد للمبادلة عندكم فترتّبون الآثار عليه فهو عندي أيضا ممضى، ويكون فردا ومنشئا لآثار المبادلة، فلو تحقّق المبادلة بنظر العرف في مورد وشكّ في أنّه هل يشترط في تحقّقه عند الشرع أمر آخر يتمسّك في نفيه بإطلاق أحلّ.
هذا كلّه على القول بالوضع للمسبّب، ويعلم منه الحال على القول بالوضع للسبب الصحيح المؤثّر؛ فإنّ إطلاق البيع في أحلّ اللّه البيع حينئذ محمول على الأسباب المؤثّرة عند العرف، فعند الشكّ في اعتبار أمر في التأثير مع إحراز الصدق العرفي يتمسّك بإطلاق «أحلّ» أيضا.
وأمّا في العبادات فحيث إنّها ماهيّات مخترعة للشرع، فليس لها عند العرف أفراد على القول بالوضع للصحيح حتّى يحمل الخطابات عليها، فلا يبقى على هذا القول عند الشكّ في دخل شيء في صحّة العبادة إلّا التوقّف وعدم التّمسك بالإطلاق، وأمّا على قول الأعمّى فحيث إنّ الحكم قد تعلّق بالجامع بين العبادة الصحيحة والفاسدة فكلّما علم بتحقّق الجامع وشكّ في دخل شيء في وصف الصحّة يتمسّك في نفيه بالإطلاق.
الأمر الثاني: قد يكون المطلوب عدّة أشياء على نحو يكون كلّ واحد في عرض الآخر، فيكون الطلب منبسطا على الجميع، وحينئذ يكون كلّ واحد جزءا، وقد يكون شيئا بشرط أن يكون منضمّا إلى شيء آخر ومصاحبا معه بحيث يكون المطلوب الأوّلي هو الأوّل لا كليهما، والثاني إنّما يكون مطلوبا ثانيا وبالعرض ولأجل أن يتحقّق بسببه خصوصيّة كون الأوّل منضما إليه ومصاحبا معه، وحينئذ يكون الشيء الثاني شرطا، فظهر معنى كون الشرط خارجا والتقيّد به داخلا، وكذا الوضع أيضا قد يتعلّق في طرف المعنى بامور متعدّدة كلّ في عرض الآخر فيكون كلّ واحد جزءا للموضوع له، وقد يكون متعلّقه أمر بشرط مصاحبته لأمر آخر فيكون الأمر الآخر خارجا والمصاحبة والتقيّد داخلا.
 الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











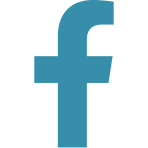

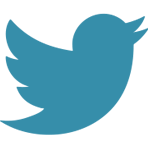

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)