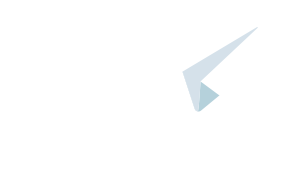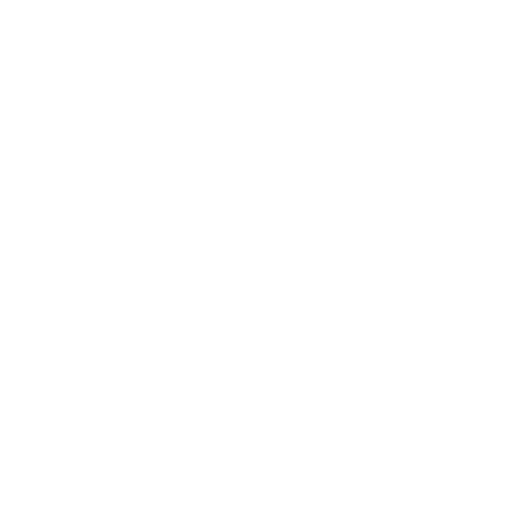تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (1-4) من سورة النحل
المؤلف:
المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
5-8-2020
6494
قال تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ} [النحل: 1 - 4]
{ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} فيه أقوال أحدها : إن معناه قرب أمر الله تعالى بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب عن الحسن وابن جريج قال الحسن: إن المشركين قالوا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ائتنا بعذاب الله فقال سبحانه إن أمر الله آت وكل ما هو آت قريب دان وثانيها : إن أمر الله أحكامه وفرائضه عن الضحاك ( وثالثها ) إن أمر الله هو يوم القيامة عن الجبائي وروي نحوه عن ابن عباس وعلى هذا الوجه فيكون أتى بمعنى يأتي وجاء وقوع الماضي هاهنا لصدق المخبر بما أخبر به فصار بمنزلة ما قد مضى ولأن سبحانه قرب أمر الساعة فجعله أقرب من لمح البصر وقال: { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ }.
{ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ} خطاب للمشركين المكذبين بيوم القيامة لعذاب الله المستهزءين به وكانوا يستعجلونه كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وتقديره قل لهؤلاء الكفار لا تستعجلوا القيامة والعذاب فإن الله سيأتي بكل واحد منهما في وقته وحينه كما تقتضيه حكمته { سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} هذه كلمة تنزيه لله تعالى عما لا يليق به وبصفاته وتنزيه له من أن يكون له شريك في عبادته أي جل وتقدس وتنزه من أن يكون له شريك تعالى وتعظم وارتفع من جميع صفات النقص { يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ } أي: ينزل الله الملائكة أوتنزل الملائكة.
{ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ } أي: بالوحي عن ابن عباس وقيل: بالقرآن عن ابن زيد وهما واحد وسمي روحا لأنه حياة القلوب والنفوس بالإرشاد إلى الدين وقيل بالنبوة عن الحسن وقوله { من أمره } أي: بأمره ونظيره قوله { يحفظونه من أمر الله } أي: بأمر الله لأن أحدا لا يحفظه عن أمره { عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } ممن يصلح للنبوة والسفارة بينه وبين خلقه { أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} هذا تفسير للروح المنزل وبدل منه فإن المعنى تنزل الملائكة بأن أنذروا أهل الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا أنا أي مروهم بتوحيدي وبأن لا يشركوا بي شيئا ومعنى { فاتقون } فاتقوا مخالفتي وفي هذا دلالة على أن الغرض من بعثة الأنبياء الإنذار والدعاء إلى الدين .
لما تقدم ذكر بعث الملائكة للإنذار وبيان التوحيد وشرائع الإسلام أتبعه سبحانه بالاحتجاج على الخلق بالخلق وتعداد صنوف الأنعام فقال { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ} ومعناه أنه خلقهما ليستدل بهما على معرفته ويتوصل بالنظر فيهما إلى العلم بكمال قدرته وحكمته وقيل: خلقهما لينتفع بهما في الدين والدنيا وليعمل بالحق { تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} أي: تقدس عن أن يكون له شريك ثم بين سبحانه دلالة أخرى فقال { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ } والنطفة الماء القليل غير أنه بالتعارف صار اسما لماء الفحل { فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ } اختصر هاهنا ذكر تقلب أحوال الإنسان لذكره ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن فالمعنى أنه خلق الإنسان من نطفة سيالة ضعيفة مهينة دبرها وصورها بعد أن قلبها حالا بعد حال حتى صارت إنسانا يخاصم عن نفسه ويبين عما في ضميره فبين سبحانه أنقص أحوال الإنسان وأكملها منبها على كمال قدرته وعلمه وقيل: خصيم مجادل بالباطل مبين ظاهر الخصومة عن ابن عباس والحسن فعلى هذا يكون المعنى أنه خلقه ومكنه فأخذ يخاصم في نفسه وفيه تعريض لفاحش ما ارتكبه الإنسان من تضييع حق نعمة الله عليه.
______________
1- تفسير مجمع البيان،الطبرسي،ج6،ص137-139.
{ أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ } . كان النبي ينذر المشركين ويخوّفهم من عذاب أليم ، وكانوا يجيبونه بالسخرية ويستعجلونه العذاب ، ويقولون له : « فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ - 32 الأنفال » .
فأجابهم سبحانه بأن عذاب اللَّه آت ، وكل آت قريب . وعبّر سبحانه عما يأتي في المستقبل بصيغة أتى الدالة على وقوع الفعل لأن العذاب واقع لا محالة ، وكل ما كان واجب الوقوع فالحال والماضي والاستقبال فيه سواء . وسيقال لهم غدا :
هذا الذي كنتم به تستعجلون . . ولا جواب الا ان قالوا : يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين .
{ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهً إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ }. المراد بالروح هنا الوحي لأنه للنفوس تماما كالأرواح للأبدان ، ومحصل المعنى ان اللَّه يصطفي لرسالته من هو أهل لها ، وتتلخص هذه الرسالة بالتوحيد عقيدة ، والاستقامة عملا ، لأن كل من اتقى اللَّه فهو على صراط الأمان والاستقامة ، وكل من عصاه فهو على صراط الهلاك والضلالة .
{ خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ } بعد ان ذكر سبحانه في الآية السابقة انه لا إله إلا هو أشار في هذه الآية إلى الدليل على ذلك ، وهو ان اللَّه خلق السماوات والأرض ، وأحكم خلقهما ، ولم يعنه على ذلك معين ، والخلق من لا شيء بهذا الأحكام والإبداع دليل الألوهية ، كما أن التفرد بالخلق دليل الوحدانية . انظر ج 2 ص 344 فقرة : « دليل التوحيد والأقانيم الثلاثة » .
{ خَلَقَ الإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ } . بعد أن أشار سبحانه إلى دليل الوحدانية قال : ولكن هذا الإنسان الضعيف الذي خلقناه من نطفة يكفر بنعمة من أنعم عليه ، ويجحد وجود من أوجده ، ويعبد ما لا يضره ولا ينفعه .
وسبق أكثر من مناسبة ان الإنسان لا ينحرف عن الطريق القويم إلا جهلا وتقليدا ، أولمنفعة شخصية . انظر تفسير الآية 34 من سورة إبراهيم ، فقرة : « هل الإنسان مجرم بطبعه ؟ .
______________
1- التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية،ج4، صفحه 496-497.
الغالب على الظن - إذا تدبرنا السورة - أن صدر السورة مما نزلت في أواخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة قبيل الهجرة، وهي أربعون آية يذكر الله سبحانه في شطر منها أنواع نعمه السماوية والأرضية مما تقوم به حياة الإنسان وينتفع به في معاشه نظاما متقنا وتدبيرا متصلا يدل على وحدانيته تعالى في ربوبيته.
ويحتج في شطر آخر على بطلان مزاعم المشركين وخيبة مساعيهم وأنه سيجازيهم كما جازى أمثالهم من الأمم الماضية وسيفصل القضاء بينهم يوم القيامة.
وقد افتتح سبحانه هذه الآيات بقوله:{ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } مفرعا آيات الاحتجاج على ما فيه من التنزيه والتسبيح ومن ذلك يعلم أن عمدة الغرض في صدر السورة الإنباء بإشراف الأمر الإلهي ودنوه منهم وقرب نزوله عليهم، وفيه إبعاد للمشركين فقد كانوا يستعجلون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - استهزاء به - لما كانوا يسمعون كلام الله سبحانه يذكر كثيرا نزول أمره تعالى وينذرهم به وفيه مثل قوله للمؤمنين:{ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ } وليس إلا أمره تعالى بظهور الحق على الباطل والتوحيد على الشرك والإيمان على الكفر، هذا ما يعطيه التدبر في صدر السورة.
وأما ذيلها وهي ثمان وثمانون آية من قوله:{ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا } إلى آخر السورة على ما بينها من الاتصال والارتباط فسياق الآيات فيه يشبه أن تكون مما نزلت في أوائل عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة بعيد الهجرة - فصدر السورة وذيلها متقاربا النزول - وذلك لما فيها من آيات لا تنطبق مضامينها إلا على بعض الحوادث الواقعة بعيد الهجرة كقوله تعالى:{ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ } الآية، وقوله:{ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ } الآية النازلة على قول في سلمان الفارسي وقد آمن بالمدينة، وقوله:{من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره} الآية النازلة في عمار - كما سيأتي - وكذا الآيات النازلة في اليهود والآيات النازلة في الأحكام كل ذلك يفيد الظن بكون الآيات مدنية.
ومع ذلك فاختلاف النزول لائح من بعضها كقوله:{والذين هاجروا} إلخ: الآية - 41، وقوله:{ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ }: الآية: 101 إلى تمام آيتين أوخمس آيات، وقوله:{من كفر بالله من بعد إيمانه}: الآية: 106 وعدة آيات تتلوها.
والإنصاف - بعد ذلك كله - أن قوله تعالى:{والذين هاجروا}: الآية: 41 إلى تمام آيتين، وقوله:{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ}: الآية: 106 وبضع آيات بعدها، وقوله:{وإن عاقبتم فعاقبوا}: الآية: 126 وآيتان بعدها مدنية لشهادة سياقها بذلك، والباقي أشبه بالمكية منها بالمدنية.
وهذا وإن لم يوافق شيئا من المأثور لكن السياق يشهد به وهو أولى بالإتباع.
وقد مر في تفسير آية 118 من سورة الأنعام احتمال أن تكون نازلة بعد سورة النحل وهي مكية.
والغرض الذي هو كالجامع لآيات ذيل السورة أن فيها أمرا بالصبر ووعدا حسنا على الصبر في ذات الله.
وغرض السورة الإخبار بإشراف أمر الله وهو ظهور الدين الحق عليهم ويوضح تعالى ذلك ببيان أن الله هوالإله المعبود لا غير لقيام تدبير العالم به، كما أن الخلقة قائمة به ولانتهاء جميع النعم إليه، وانتفاء ذلك عن غيره، فالواجب أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وبيان أن الدين الحق لله فيجب أن يؤخذ به ولا يشرع دونه دين ورد ما أبداه المشركون من الشبهة على النبوة والتشريع وبيان أمور من الدين الإلهي.
هذا هو الذي يرومه معظم آيات السورة وتنعطف إلى بيانه مرة بعد مرة وفي ضمنها آيات تتعرض لأمر الهجرة وما يناسب ذلك مما يحوم حولها.
قوله تعالى:{ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } ظاهر السياق أن الخطاب للمشركين لأن الآيات التالية مسوقة احتجاجا عليهم، إلى قوله في الآية الثانية والعشرين:{إلهكم إله واحد} ووجه الكلام فيها إلى المشركين، وهي جميعا كالمتفرعة على قوله في ذيل هذه الآية:{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ومقتضاه أن يكون الأمر الذي أخبر بإتيانه أمرا يطهر ساحة الربوبية من شركهم بحسم مادته، ولم تقع في كلامه حكاية استعجال من المؤمنين في أمر، بل المذكور استعجال المشركين بما كان يذكر في كلامه تعالى من أمر الساعة وأمر، الفتح وأمر نزول العذاب، كما يشير إليه قوله:{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ - إلى قوله - وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ }: يونس: 53 إلى غير ذلك من الآيات.
وعلى هذا فالمراد بالأمر ما وعد الله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والذين آمنوا وأوعد المشركين مرة بعد مرة في كلامه أنه سينصر المؤمنين ويخزي الكافرين ويعذبهم ويظهر دينه بأمر من عنده كما قال:{ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ }: البقرة: 109.
وإليه يعود أيضا ضمير{فلا تستعجلوه} على ما يفيده السياق أويكون المراد بإتيان الأمر إشرافه على التحقق وقربه من الظهور، وهذا شائع في الكلام يقال لمن ينتظر ورود الأمير: هذا الأمير جاء وقد دنا مجيئه ولم يجىء بعد.
وعلى هذا أيضا يكون قوله:{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } من قبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إشارة إلى أنهم ينبغي أن يعرض عن مخاطبتهم ومشافهتهم لانحطاط أفهامهم لشركهم ولم يستعجلوا نزول الأمر إلا لشركهم استهزاء وسخرية.
وبما مر يندفع ما ذكره بعضهم أن الخطاب في الآية للمؤمنين أوللمؤمنين والمشركين جميعا فإن السياق لا يلائمه.
على أنه تعالى يخص في كلامه الاستعجال بغير المؤمنين وينفيه عنهم قال:{ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ}: الشورى: 18.
وكذا ما ذكروه أن المراد بالأمر هو يوم القيامة وذلك أن المشركين وإن كانوا يستعجلونه أيضا كما يدل عليه قولهم على ما حكاه الله تعالى:{ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }: يس: 48 لكن سياق الآيات لا يساعد عليه كما عرفت.
ومن العجيب ما استدل به جمع منهم على أن المراد بالأمر يوم القيامة أنه تعالى لما قال في آخر سورة الحجر:{ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } وكان فيه تنبيه على حشر هؤلاء وسؤالهم قال في مفتتح هذه السورة:{أتى أمر الله} فأخبر بقرب يوم القيامة وكذا قوله في آخر الحجر:{ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } وهو مفسر بالموت شديد المناسبة بأن يكون المراد بالأمر في هذه السورة يوم القيامة ومما يؤكد المناسبة قوله هناك:{يأتيك} وهاهنا:{أتى}.
وأمثال هذه الأقاويل الملفقة مما ينبغي أن يلتفت إليه.
ونظيره قول بعضهم: إن المراد بالأمر واحدة الأوامر ومعناه الحكم كأنه يشير به إلى ما في السورة من أحكام العهد واليمين ومحرمات الأكل وغيرها والخطاب على هذا للمؤمنين خاصة وهو كما ترى.
قوله تعالى:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } إلى آخر الآية.
الناس على اختلافهم الشديد قديما وحديثا في حقيقة الروح لا يختلفون في أنهم يفهمون منه معنى واحدا وهو ما به الحياة التي هي ملاك الشعور والإرادة فهذا المعنى هو المراد في الآية الكريمة.
وأما حقيقته إجمالا فالذي يفيده مثل قوله تعالى:{ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا }: النبأ: 38، وقوله:{ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ }: المعارج: 4 وغيرهما أنه موجود مستقل ذوحياة وعلم وقدرة وليس من قبيل الصفات والأحوال القائمة بالأشياء كما ربما يتوهم، وقد أفاد بقوله:{قل الروح من أمر ربي} أنه من سنخ أمره، وعرف أيضا أمره بمثل قوله:{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}: يس: 83، فدل على أنه كلمة الإيجاد التي يوجد سبحانه بها الأشياء أي الوجود الذي يفيضه عليها لكن لا من كل جهة بل من جهة استناده إليه تعالى بلا مادة ولا زمان ولا مكان كما يفيده قوله:{ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}: القمر: 50 فإن هذا التعبير إنما يورد فيما لا تدريج فيه أي لا مادة ولا حركة له، وليكن هذا الإجمال عندك حتى يرد عليك تفصيله فيما سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة الإسراء.
فتحصل أن الروح كلمة الحياة التي يلقيها الله سبحانه إلى الأشياء فيحييها بمشيئته، ولذلك سماه وحيا وعد إلقاءه وإنزاله على نبيه إيحاء في قوله:{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا }: الشورى: 52، فإن الوحي هو الكلام الخفي والتفهيم بطريق الإشارة والإيماء فيكون إلقاء كلمته تعالى - كلمة الحياة - إلى قلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيا للروح إليه، فافهم ذلك.
فقوله تعالى:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ } الباء للمصاحبة أوللسببية ولا كثير تفاوت بينهما في المآل كما هو ظاهر عند المتأمل فإن تنزيل الملائكة بمصاحبة الروح إنما هو لإلقائه في روح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليفيض عليه المعارف الإلهية وكذا تنزيلهم بسبب الروح لأن كلمته تعالى أعني كلمة الحياة تحكم في الملائكة وتحييهم كما تحكم في الإنسان وتحييه، وضمير{ينزل} له تعالى والجملة استئناف تفيد تعليل قوله في الآية السابقة:{ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }.
والمعنى: أن الله منزه ومتعال عن شركهم أوعن الشريك الذي يدعونه له ولتنزهه وتعاليه عن الشريك ينزل سبحانه الملائكة بمصاحبة الروح الذي هو من سنخ أمره وكلمته في الإيجاد - أوبسببه - على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
وذكر بعضهم أن المراد بالروح الوحي أو القرآن وسمي روحا لأن به حياة القلوب، كما أن الروح الحقيقي به حياة الأبدان.
قال: وقوله:{من أمره} أي بأمره، ونظيره قوله:{يحفظونه من أمر الله} أي بأمر الله لأن أحدا لا يحفظه عن أمره، انتهى.
أما قوله: إن{من} في قوله{من أمره} بمعنى الباء استنادا إلى قوله:{يحفظونه من أمر الله} أي بأمر الله إلخ فقد مر في تفسير سورة الرعد أن{من} على ظاهر معناه وأن بعض أمره تعالى يحفظ الأشياء من بعض أمره فلا وجه لأخذ{من أمره} بمعنى{بأمره} بل قوله{بالروح من أمره} معناه بالروح الكائن من أمره - على أن الظرف مستقر لا لغو- كما في قوله:{قل الروح من أمر ربي} ومعناه ما تقدم.
وأما قوله: إن الروح بمعنى الوحي أوالقرآن وكذا قول بعضهم: إنه بمعنى النبوة فلا يخلوعن وجه بحسب النتيجة بمعنى أن نتيجة نزول الملائكة بالروح من أمره هو الوحي أوالنبوة، وأما في نفسه وهو أن يسمى الوحي أوالنبوة روحا باشتراك لفظي أومجازا من حيث إنه يحيي القلوب ويعمرها، كما أن الروح به حياة الأبدان وعمارتها فهو فاسد لما بيناه مرارا أن الطريق إلى تشخيص مصاديق الكلمات في كلامه تعالى هو الرجوع إلى سائر ما يصلح من كلامه لتفسيره دون الرجوع إلى العرف وما يراه في مصاديق الألفاظ.
والمتحصل من كلامه سبحانه أن الروح خلق من خلق الله وهو حقيقة واحدة ذات مراتب ودرجات مختلفة منها ما في الحيوان وغير المؤمنين من الإنسان ومنها ما في المؤمنين من الإنسان، قال تعالى:{وأيدهم بروح منه}: المجادلة: 22، ومنها ما يتأيد به الأنبياء والرسل كما قال{وأيدناه بروح القدس}: البقرة: 87، وقال:{ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا }: الشورى: 52 على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
هذا ما تفيده الآيات الكريمة وأما أن إطلاق اللفظ على هذا المعنى هل هي حقيقة أومجاز وما أمعنوا في البحث أنه من الاستعارة المصرحة أواستعارة بالكناية أوأن قوله:{بالروح من أمره} من قبيل التشبيه لذكر المشبه صريحا بناء على كون{من} في قوله:{من أمره} بيانية كما صرحوا في قوله:{ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}: البقرة: 187 أنه من التشبيه للتصريح بالمشبه في متن الكلام فكل ذلك من الأبحاث الأدبية الفنية التي ليس لها كثير تأثير في الحصول على الحقائق.
وذكر بعضهم أن{من أمره} بيان للروح، و{من} للتبيين، والمراد بالروح الوحي، كما تقدم.
وفيه أنه مدفوع بقوله تعالى:{قل الروح، من أمر ربي} فإن من الواضح أن الآيتين تسلكان مسلكا واحدا، وظاهر آية الإسراء أن{من} فيها للابتداء أوللنشوء، والمراد بيان أن الروح من سنخ الأمر وشأن من شئونه ويقرب منها قوله تعالى:{ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ }: القدر: 4.
وذكر بعضهم أن المراد بالروح هو جبريل وأيده بقوله:{ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ }: الشعراء: 194، فإن من المسلم أن المراد به في الآية، هو جبريل والباء للمصاحبة والمراد بالملائكة ملائكة الوحي وهم أعوان جبريل، والمراد بالأمر واحد الأوامر، والمعنى ينزل تعالى ملائكة الوحي بمصاحبة جبريل بأمره وإرادته.
وفيه أن هذه الآية نظيرة قوله تعالى:{ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ}: المؤمن: 15، وظاهره لا يلائم كون المراد بالروح هو جبريل.
وأردأ الوجوه ما ذكره بعضهم أن المراد بالروح أرواح الناس لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الأرواح، وهو منقول عن مجاهد، وفساده ظاهر.
وقوله:{ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } أي إن بعث الرسل وتنزيل الملائكة بالروح من أمره عليهم متوقف على مجرد المشية الإلهية من غير أن يقهره تعالى في ذلك قاهر غيره فيجبره على الفعل أويمنعه من الفعل كما في سائر أفعاله تعالى فإنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
فلا ينافي ذلك كون فعله ملازما لحكم ومصالح ومختلفا باختلاف الاستعدادات لا يقع إلا عن استعداد في المحل وصلاحية للقبول فإن استعداد المستعد ليس إلا كسؤال السائل، فكما أن سؤال السائل إنما يقربه من جود المسئول وعطائه من غير أن يجبره على الإعطاء ويقهره كذلك الاستعداد في تقريبه المستعد لإفاضته تعالى وحرمان غير المستعد من ذلك فه وتعالى يفعل ما يشاء من غير أن يوجبه عليه شيء أويمنعه عنه شيء لكنه لا يفعل شيئا ولا يفيض رحمة إلا عن استعداد فيما يفيض عليه وصلاحية منه.
وقد أفاد ذلك في خصوص الرسالة حيث قال:{ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ}: الأنعام: 124، فإن الآية ظاهرة في أن الموارد مختلفة في قبول كرامة الرسالة وأن الله سبحانه أعلم بالمورد الذي يصلح لها ويستأهل لتلك الكرامة وهو غير هؤلاء المجرمين الماكرين وأما هم فليس لهم عند الله إلا الصغار والعذاب لإجرامهم ومكرهم. هذا.
ومن هنا يظهر فساد استدلال بعضهم بالآية على نفي المرجح في مورد الرسالة ومحصل ما ذكره أن الآية تعلق الرسالة على مجرد المشية الإلهية من غير أن تقيدها بشيء، فالرسول إنما ينال الرسالة بمشية من الله لا لاختصاصه بصفات تؤهله لذلك ويرجحه على غيره ووجه الفساد ظاهر مما تقدم.
ونظيره في الفساد الاستدلال بالآية على كون الرسالة عطائية غير كسبية، وذلك أنه تعالى غير محكوم عليه في ما ينسب إليه من الفعل لا يفعل إلا ما يشاء، والأمور العطائية والكسبية في ذلك سواء، ولا شيء يقع في الوجود إلا بإذنه.
وقوله:{ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ} بيان لقوله:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ } لكونه في معنى الوحي أوبيان للروح بناء على كونه بمعنى الوحي، والإنذار هو إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير هو إخبار فيه سرور على ما ذكره الراغب أوإعلام بالمحذور كما ذكره غيره، والتقدير على الأول أخبروهم مخوفين بوحدانيتي في الألوهية ووجوب تقواي، وعلى الثاني أعلموهم ذلك، على أن يكون{أنه} مفعولا ثانيا لا منصوبا بنزع الخافض.
وقد علم بذلك أن قوله:{فاتقون} متفرع على قوله:{لا إله إلا أنا} والجملتان جميعا مفعول ثان أو في موضعه لقوله:{أنذروا} ويوضح ذلك أن لا إله وهو الذي يبتدىء منه وينتهي إليه كل شيء أوالمعبود بالحق من لوازم صفة ألوهيته أن يتقيه الإنسان لتوقف كل خير وسعادة إليه، فلو فرض أنه واحد لا شريك له في ألوهيته كان لازمه أن يتقى وحده لأن التقوى وهو إصلاح مقام العمل فرع لما في مقام الاعتقاد والنظر، فعبادة الآلهة الكثيرين والخضوع لهم لا يجامع الاعتقاد بإله واحد لا شريك له الذي هو القيوم على كل شيء وبيده زمام كل أمر ولذا لم يؤمر نبي أن يدعوإلى توحيد من غير عمل أوإلى عمل من غير توحيد، قال تعالى:{وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}: الأنبياء: 25.
فالذي أمر الرسل بالإنذار به في الآية هو مجموع قوله:{أنه لا إله إلا أنا فاتقون} وهوتمام الدين لاندراج الاعتقادات الحقة في التوحيد والأحكام العملية جميعا في التقوى، ولا يعبأ بما ذكره بعضهم أن قوله:{فاتقون} للمستعجلين من الكفار المذكورين في الآية الأولى أولخصوص كفار قريش من غير أن يكون داخلا فيما أمر به الرسل من الإنذار.
قوله تعالى:{ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } تقدم معنى خلق السماوات والأرض بالحق، ولازم خلقها بالحق أن لا يكون للباطل فيها أثر، ولذلك عقبه بتنزيهه عن الشركاء الذين يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله ويهدوهم إلى الخير ويقوهم الشر فإنهم من الباطل الذي لا أثر له.
وفي الآية والآيات التالية لها احتجاج على وحدانيته تعالى في الألوهية والربوبية من جهتي الخلق والتدبير جميعا فإن الخلق والإيجاد آية الألوهية وكون الخلق بعضها نعمة بالنسبة إلى بعض آية الربوبية لأن الشيء لا يكون نعمة بالنسبة إلى آخر إلا عن ارتباط بينهما واتصال من أحدهما بالآخر يؤدي إلى نظام جامع بينهما وتدبير واحد يجمعهما، ووحدة التدبير آية وحدة المدبر فكون ما في السماوات والأرض من مخلوق نعما للإنسان يدل على أن الله سبحانه وحده ربه ورب كل شيء.
قوله تعالى:{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ } المراد به الخلق الجاري في النوع الإنساني وهو جعل نسله من النطفة فلا يشمل آدم وعيسى (عليه السلام).
والخصيم صفة مشبهة من الخصومة وهي الجدال، والآية وإن أمكن أن تحمل على الامتنان حيث إن من عظيم المن أن يبدل الله سبحانه بقدرته التامة قطرة من ماء مهين إنسانا كامل الخلقة منطيقا متكلما ينبىء عن كل ما جل ودق ببيانه البليغ لكن كثرة الآيات التي توبخ الإنسان وتقرعه على وقاحته في خصامه في ربه كقوله تعالى:{ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ }: يس: 78 ترجح أن يكون المراد بذيل الآية بيان وقاحة الإنسان.
ويؤيد ذلك أيضا بعض التأييد ما في ذيل الآية السابقة من تنزيهه تعالى من شركهم.
_____________
1- تفسير الميزان ،الطباطبائي،ج12،ص164-172.
أتى أمْرُ اللَّهِ:
ذكرنا سابقاً أن قسماً مهمّاً من الآيات التي جاءت في أوّل السورة هي آيات مكّية نزلت حينما كان النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يخوض صراعاً مشتداً مع المشركين وعبدة الأصنام، وما يمر يوم حتى يطلع أعداء الرسالة بمواجهة جديدة ضد الدعوة الإِسلامية المباركة، لأنّها تريد بناء صرح الحرية، بل كل الحياة من جديد.
ومن جملة مواجهاتهم اليائسة قولهم للنّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حينما يهددهم وينذرهم بعذاب اللّه: إِنْ كان ذلك حقاً فَلِمَ لا يحل العذاب والعقاب بنا إِذن؟!
ولعلهم يضيفون: وحتى لو نزل العذاب فسنلتجيء إِلى الأصنام لتشفع لنا عند اللّه في رفع العذاب.. وَلِمَ لا يكون ذلك، أَوَ لسن شفيعات؟!..
وأوّل آية من السورة تُبطل أوهام أُولئك بقوله تعالى: { أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ }، وإِنْ اعتقدتم أنّ الأصنام شافعة لكم عند اللّه فقد أخطأتم الظن { سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }.
فـ «أمر اللّه» هنا: أمر العذاب للمشركين، أمّا الفعل «أتى» فالمراد منه المستقبل الحتمي الوقوع على الرّغم من وقوعه بصيغة الماضي، ومثل هذا كثير في الأسلوب البلاغي للقرآن.
واحتمل بعض المفسّرين أنَّ «أمر اللّه» إِشارة إِلى نفس العذاب وليس الأمر به.
واحتمل بعض آخر أنّ المراد به يوم القيامة.
ويبدو لنا أنّ التّفسير الذي ذكرناه أقرب من غيره، واللّه العالم.
وبما أنَّ مستلزمات العدل الإِلهي اقتضت عدم العقاب إِلاّ بعد البيان الكافي والحجّة التامة، فقد أضاف سبحانه: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ (2) عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا } بناء على هذا الإِنذار والتذكير {فاتقون}.
أمّا المقصود من «الروح» في الآية فهناك كلام كثير بين المفسّرين في ذلك إِلاّ أنّ الظاهر منها هو: الوحي و القرآن والنّبوة.. والتي هي مصدر الحياة المعنوية للبشرية.
وقد فصل بعض المفسّرين الوحي عن القرآن وعن النّبوة، معتبراً ذلك ثلاثة تفاسير مستقلة للكلمة ولكنّ الظاهر رجوع الجميع إِلى حقيقة واحدة.
وعلى أية حال فكلمة «الروح» في هذا الموضوع ذات جانب معنوي وإِشارة إِلى كل ما هو سبب لإِحياء القلوب وتهذيب النفوس وهداية العقول، كما نقرأ في الآية الرّابعة والعشرين من سورة الأنفال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.. وفي الآية الخامسة عشر من سورة غافر: (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده).. وفي الآية و الثانية الخمسين من سورة الشورى: { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ }.
وجليٌّ أنّ «الرّوح» في الآيات المتقدمة ترمز إِلى «القرآن» و «الوحي» و «أمر النّبوة».
وقد وردت «الرّوح» بمعاني أخر في مواضع من القرآن الكريم، ولكنْ مع الأخذ بنظر الإِعتبار ما ذكر من قرائن نخلص إِلى أنّ المراد من مفهوم «الروح» في الآية مورد البحث هو القرآن وما تضمنه الوحي.
وجدير بالملاحظة أنّ عبارة {على مَنْ يشاء من عباده} لا تعني أن هداية الوحي والنّبوة لا حساب فيها، لأنّه لا انفصام ولا ضدية بين مشيئة اللّه وحكمته، كما تحدثنا في ذلك الآية (124) من سورة الأنعام: {اللّه أعلم حيث يجعل سالته}.
ولا ينبغي غض الطرف من كون الإِنذار من أوائل الأوامر الربانية الموجهة إِلى الأنبياء(عليهم السلام) بدليل عبارة {أن أنذروا}، لأنّ من طبيعة الإِنذار أن يعقبه انتباه فنهوض وحركة.
صحيح أنّ الإِنسان طالب للمنفعة ودافع للضرر، ولكنّ التجربة أظهرت أنّ للترغيب أثر بالغ لمن يمتلك أسس وشرائط قبول الهداية، أما مَنْ أعمت بصيرتهم ملهيات الحياة الدنيا فلا ينفع معهم إِلاّ التهديد والوعيد، وفي بداية دعوة النّبي كان من الضروري استخدام اُسلوب الانذار الشديد.
الحيوان ذلك المخلوق المعطاء:
بعد أنْ تحدثت الآيات السابقة عن نفي الشرك، جاءت هذه الآيات لتقلع جذوره بالكامل، وتوجه الإِنسان نحو خالقة بطريقين:
الأوّل: عن طريق الأدلة العقلية من خلال فهم ومحاولة استيعاب ما في الخلائق من نظام عجيب.
الثّاني: عن طريق العاطفة ببيان نعم اللّه الواسعة على الإِنسان، عسى أن يتحرك فيه حس الشكر على النعم فيتقرب من خلاله إِلى المنعم سبحانه.
فيقول: { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ }.
وتتّضح حقّانيّة السماوات والأرض من نظامها المحكم وخلقها المنظم وكذلك من هدف خلقها وما فيها من منافع.
ثمّ يضيف: { تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }.
فهل تستطيع الأصنام إِيجاد ما أوجده اللّه؟!
بل هل تستطيع أن تخلق بعوضة صغيرة أو ذرة تراب؟!
فكيف إِذن جعلوها شريكة اللّه سبحانه!!..
والمضحك المبكي في حال المشركين أنّهم يعتبرون اللّه هو الخالق عن علم وقدرة لهذا النظام العجيب والخلق البديع.. ومع ذلك فهم يسجدون للأصنام!
وبعد الإِشارة إِلى خلق السماوات والأرض وما فيها من أسرار لا متناهية يعرّج القرآن الكريم إِلى بعض تفاصيل خلق الإِنسان من الناحية التكوينية فيقول: { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ}.
«النطفة» (في الأصل) بمعنى: الماء القليل، أو الماء الصافي، ثمّ أطلقت على قطرات الماء التي تكون سبباً لوجود الإِنسان بعد تلقيحها.
وحقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة وقدرة اللّه عزَّ وجلّ، حيث يخلق هذا المخلوق العجيب من قطرة ماء حقيرة مع ما له من قيمة وتكريم وشرف بين باقي المخلوقات وعند اللّه أيضاً.
هذا إِذا ما اعتبرنا «الخصيم» بمعنى المدافع والمعبر عمّا في نفسه، كما تخبرنا الآية (105) من سورة النساء بذلك: {ولا تكن للخائنين خصيماً} كما ذهب إِليه جمع من المفسّرين.
وهناك من يذهب إِلى تفسير آخر، خلاصته: بقدرة اللّه التامة خُلق الإِنسان من نطفة حقيرة، ولكنّ هذا المخلوق غير الشكور يقف في كثير من المواضع مجادلا خصيماً أمام خالقه، واعتبروا الآية السابعة والسبعين من سورة يس شاهداً على ما ذهبوا إِليه.
إِلاّ أنّ التّفسير الأوّل كما يبدو ـ أقرب من الثّاني، لأنّ الآيات أعلاه في مقام بيان عظمة اللّه وقدرته، وتتبيّن عظمته بشكل جلي حين يخلق كائناً شريفاً جداً من مادة ليست بذي شأن في ظاهرها.
وجاء في تفسير علي بن إِبراهيم: (خلقه من قطرة من ماء منتن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً)(3).
____________
1- تفسير الامثل ،مكارم الشيرازي،ج7،ص7-13.
2 ـ «مِنْ» في عبارة «من أمره» جاءت بمعنى «بـ» السببية.
3 ـ تفسير نور الثقلين، ج3، ص39.
 الاكثر قراءة في سورة النحل
الاكثر قراءة في سورة النحل
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











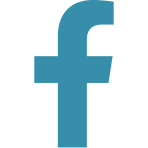

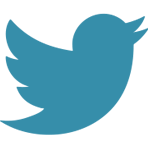

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)