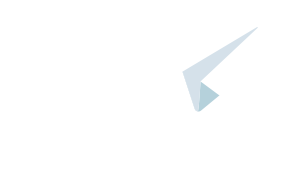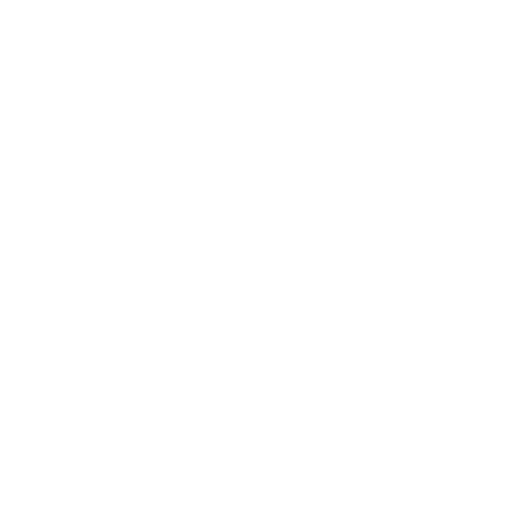تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير آية (108-110) من سورة الانعام
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
5-11-2017
4822
قال تعالى : {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام : 108 - 110] .
قال تعالى : {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام : 108] .
نهى الله المؤمنين أن يسبوا الأصنام ، لما في ذلك من المفسدة ، فقال : {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} أي : لا تخرجوا من دعوة الكفار ومحاجتهم ، إلى أن تسبوا ما يعبدونه من دون الله ، فإن ذلك ليس من الحجاج في شيء {فيسبوا الله عدوا} أي : ظلما {بغير علم} وأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقون ، لأن الدار دارهم ، ولم يؤذن لكم في القتال ، وإنما قال : {من دون الله} لأن المعنى يدعونه إلها . وفي هذا دلالة على أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل ، أو يقول ما يؤدي إلى معصية غيره .
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء ، في ليلة ظلماء ، فقال : كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله ، فكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون ، فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم ، لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين ، فكان المؤمنون قد أشركوا من حيث لا يعلمون} .
{كذلك زينا لكل أمة عملهم} قيل في معناه أقوال أحدها : إن المراد كما زينا لكم أعمالكم ، زينا لكل أمة ممن قبلكم أعمالهم من حسن الدعاء إلى الله تعالى ، وترك السب للأصنام ، ونهيناهم أن يأتوا من الأفعال ما ينفر الكفار عن قبول الحق ، عن الحسن ، والجبائي . ويسمي ما يجب على الانسان أن يعمله بأنه عمله ، كما تقول لولدك أو غلامك : إعمل عملك ، أي : ما ينبغي لك أن تفعله . وثانيها : إن معناه . وكذلك زينا لكل أمة عملهم ، بميل الطباع إليه ، ولكن قد عرفناهم الحق مع ذلك ، ليأتوا الحق ، ويجتنبوا الباطل . وثالثها : إن المراد زينا عملهم بذكر ثوابه فهو كقوله : {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} يريد : حبب إليكم الإيمان بذكر ثوابه ، ومدح فاعليه . على فعله ، وكره الكفر بذكر عقابه ، وذم فاعليه على فعله ، ولم يرد سبحانه بذلك أنه زين عمل الكافرين ، لأن ذلك يقتضي الدعاء إليه ، والله تعالى ما دعا أحدا إلى معصيته ، لكنه نهى عنها وذم فاعليها ، وقد قال سبحانه {وزين لهم الشيطان أعمالهم} ولا خلاف أن المراد بذلك الكفر والمعاصي ، وفي ذلك دلالة على أن المراد به في الآية تزيين أعمال الطاعة .
{ثم إلى ربهم مرجعهم} أي : مصيرهم {فينبئهم بما كانوا يعملون} أي : بأعمالهم من الخير والشر .
نهى الله سبحانه في هذه الآية عن سب الأصنام لئلا يؤدي ذلك إلى سبه ، فإذا كان سبحانه لا يريد ما ربما يكون سببا إلى سبه ، فلأن لا يريد سب نفسه أولى وأجدر ، وأيضا إذا لم يرد سب الأصنام إذا كان زيادة في كفر الكافرين ، فلأن لا يريد كفرهم أحرى ، فبطل قول المجبرة .
- {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام : 108 - 110] .
ثم بين سبحانه حال الكفار الذين سألوه الآيات ، فقال : {وأقسموا} أي : حلفوا {بالله جهد أيمانهم} أي : مجدين مجتهدين ، مظهرين الوفاء به {لئن جاءتهم آية} مما سألوه {ليؤمنن بها قل} يا محمد {إنما الآيات} أي : الأعلام والمعجزات {عند الله} والله تعالى مالكها ، والقادر عليها ، فلو علم صلاحكم في إنزالها ، لأنزلها {وما يشعركم} الخطاب متوجه إلى المشركين ، عن مجاهد ، وابن زيد . وقيل : هو متوجه إلى المؤمنين ، عن الفراء ، وغيره ، لأنهم ظنوا أنهم لو أجيبوا إلى الآيات لآمنوا {أنها إذا جاءت لا يؤمنون} قد مر معناه .
{ونقلب أفئدتهم وأبصارهم} أخبر سبحانه أنه يقلب أفئدة هؤلاء الكفار ، وأبصارهم ، عقوبة لهم ، وفي كيفية تقليبهما قولان أحدهما : إنه يقلبهما في جهنم على لهب النار ، وحر الجمر ، {كما لم يؤمنوا به أول مرة} في الدنيا ، عن الجبائي ، قال : وجمع بين صفتهم في الدنيا ، وصفتهم في الآخرة ، كما قال : {وجوه يومئذ خاشعة} يعني في الآخرة {عاملة ناصبة} يعني في الدنيا ، والآخر : إن المعنى نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيرة التي تغم وتزعج النفس . وقوله {كما لم يؤمنوا به أول مرة} قيل : إنه متصل بما قبله ، وتقديره وأقسموا بالله ليؤمنن بالآيات ، والله تعالى قد قلب قلوبهم وأبصارهم ، وعلم أن فيها خلاف ما يقولون . يقال : فلان قد قلب هذه المسألة ، وقلب هذا الأمر إذا عرف حقيقته ، ووقف عليه {وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون} كما لم يؤمنوا بما أنزل الله من الآيات أول مرة ، عن ابن عباس ، ومجاهد . وقيل : معناه لو أعيدوا إلى الدنيا ثانية ، لم يؤمنوا به ، كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنيا ، كما قال : {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} عن ابن عباس في رواية أخرى . وقيل : معناه يجازيهم في الآخرة كما لم يؤمنوا به في الدنيا ، عن الجبائي . والهاء في {به} يحتمل أن يكون عائدة على القرآن ، وما أنزل من الآيات . ويحتمل أن تكون عائدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
{ونذرهم في طغيانهم} أي : نخليهم وما اختاروه من الطغيان ، فلا نحول بينه وبينهم {يعمهون} يترددون في الحيرة . قال الحسين بن علي المغربي : قوله : {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم} حشو بين الجملتين ، ومعناه : إنا نحيط علما بذات الصدور وخائنة الأعين أي : نختبر قلوبهم فنجد باطنها بخلاف ظاهرها .
______________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 132-136 .
{ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهً عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} . قالوا : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار ، فيجيبهم الكفار بسب اللَّه جل ثناؤه ، وهذا القول ليس ببعيد ، فكثيرا ما يقع ذلك بين المختلفين في الدين ، ولفظ الآية لا يأباه ، بل روي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : انه سئل عن قول النبي (صلى الله عليه وآله) :
ان الشرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء ؟ . قال : كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون اللَّه ، فكان المشركون يسبون من يعبد المؤمنون ، فنهى المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين ، فكأنّ المؤمنين قد أشركوا من حيث لا يعلمون . . وقوله تعالى : بغير علم . إشارة إلى جهالة المشركين وسفاهتهم . . وفي الآية دلالة واضحة على ان ما كان ضره أكثر من نفعه فهو محرم ، وان اللَّه لا يطاع من حيث يعصى .
{ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ } . المعنى الظاهر من هذه الجملة ان اللَّه سبحانه كما زين للمسلمين أعمالهم كذلك زين لغيرهم أعمالهم ، حتى المشركين . .
وليس من شك ان هذا المعنى غير مراد ، لأن الشيطان هو الذي يزين للمشركين والعاصين الشرك والعصيان بنص الآية 43 من الأنعام : {وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} . بالإضافة إلى أن اللَّه سبحانه لا يأمر عبده بالكفر ويزينه إليه ، ثم يعاقبه عليه ، بل العكس هو الصحيح ، قال تعالى : {ولكِنَّ اللَّهً حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمانَ وزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكَرَّهً إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والْفُسُوقَ والْعِصْيانَ} [الحجرات - 7] .
ومن أجل هذا نرجح حمل الآية على ان اللَّه خلق الإنسان على حال يستحسن معها ما يأتيه من أعمال ، ويجري عليه من عادات ، ووهبه عقلا يميز به بين الأعمال الحسنة والقبيحة ، ولو خلقه على حال يستقبح معها جميع أعماله لما عمل شيئا . . وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : { زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ } تماما كمعنى قوله : {كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [المؤمنون - 53] . وقولنا : كل انسان راض عن عمله .
{ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ } . إذن ، فليدع المؤمنون سب آلهة المشركين ما دام اللَّه سيعاقبهم عليه .
وتسأل : ان من سب اللَّه أو رسوله يجب قتله ، وهذه الآية تشعر بأن أمره متروك إلى حسابه وعذابه يوم القيامة ؟ .
الجواب : ان هذه الآية نزلت بمكة يوم كان المسلمون ضعافا لم يؤذن لهم بقتال ، لأن القتال كان آنذاك بالنسبة إليهم أشبه بعملية الانتحار ، أما مع قوة الإسلام وسلطانه فيجب تنفيذ حكم الاعدام بالساب ، ولا يجوز وقفه وتعطيله .
{ وأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها } . أيّد اللَّه سبحانه رسوله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بالأدلة الكافية على نبوته بما لا يدع مجالا للشك عند من يطلب الحق لوجه الحق ، ولكن مشركي قريش اقترحوا على محمد ( صلى الله عليه وآله ) معجزات خاصة ، وجعلوها شرطا لإيمانهم به ، وأقسموا أغلظ الإيمان أن يصدقوا محمدا إذا استجاب لاقتراحهم ، فأمر اللَّه نبيه أن يقول لهم : { إِنَّمَا الآياتُ عِنْدَ اللَّهِ } .
ينزل منها ما تقوم به الحجة على الجميع ، وما زاد فينزله أو يمنعه بحكمته وقضائه . . وتمنى المؤمنون ان يستجيب اللَّه لطلب الكافرين رغبة منهم في سلمهم وايمانهم ، فخاطب اللَّه المؤمنين بقوله : { وما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ } أي من أين علمتم ان اللَّه سبحانه إذا أنزل الآية المقترحة يترك الكافرون كفرهم وعنادهم ؟ وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية 34 - 37 من هذه السورة ، وفي ج 1 ص 189 .
{ ونُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ } . نقلب أفئدتهم وأبصارهم كناية عن علم اللَّه تعالى بحقيقتهم ، وضمير به يعود إلى محمد أو إلى القرآن ، والمعنى ان اللَّه يعلم بأن المشركين لا يؤمنون بعد نزول الآية التي اقترحوها ، وانهم يبقون مصرين على ضلالهم الأول الذي كانوا عليه قبل نزول الآية المقترحة . . انهم طلاب باطل وضلال ، وليسوا طلاب حق وهداية .
{ ونَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ } . أي بعد أن أصروا على الضلال رغم إقامة الحجة عليهم ندعهم وشأنهم ، حتى يأتي اليوم الذي يلاقون فيه جزاء عملهم ، وقد تكرر هذا المعنى في العديد من الآيات ، منها : {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} [الزخرف - 83] .
____________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 241-243 .
قوله تعالى : {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} السب معروف ، قال الراغب في المفردات ، : العدو التجاوز ومنافاة الالتيام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له : العداوة والمعاداة ، وتارة بالمشي فيقال له العدو ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان والعدو قال : {فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} وتارة بأجزاء المقر فيقال له العدواء يقال مكان ذو عدواء أي غير متلائم الأجزاء . انتهى .
والآية تذكر أدبا دينيا تصان به كرامة مقدسات المجتمع الديني وتتوقى ساحتها أن يتلوث بدرن الإهانة والإزراء بشنيع القول والسب والشتم والسخرية ونحوها فإن الإنسان مغروز على الدفاع عن كرامة ما يقدسه ، والمقابلة في التعدي على من يحسبه متعديا إلى نفسه ، وربما حمله الغضب على الهجر والسب لما له عنده أعلى منزلة العزة والكرامة فلو سب المؤمنون آلهة المشركين حملتهم عصبية الجاهلية أن يعارضوا المؤمنين بسب ما له عندهم كرامة الألوهية وهو الله عز اسمه ففي سب آلهتهم نوع تسبيب إلى ذكره تعالى بما لا يليق بساحة قدسه وكبريائه .
وعموم التعليل المفهوم من قوله : {كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} يفيد عموم النهي لكل قول سيئ يؤدي إلى ذكر شيء من المقدسات الدينية بالسوء بأي وجه أدى .
قوله تعالى : {كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} الزينة أمر جميل محبوب يضم إلى شيء ضما يجلب الرغبة إليه ويحببه عند طالبه فيتحرك نحو الزينة وينتهي إلى الشيء المتزين بها كاللباس المزين بهيئته الحسنة الذي يلبسه الإنسان لزينته فيصان به بدنه عن الحر والبرد .
وقد أراد الله سبحانه أن يعيش الإنسان هذه العيشة الدنيوية ذات الشعب والفروع ويديم حياته الأرضية الخاصة به من طريق إعمال قواه الفعالة فيدرك ما ينفعه وما يضره بحواسه الظاهرة ثم يتصرف فيها بحواسه وقواه الباطنة ثم يتغذى بأكل أشياء وشرب أشياء ويهيج إلى النكاح بأعمال خاصة ويلبس ويأوي ويجلب ويدفع وهكذا .
وله في جميع هذه الأعمال وما يتعلق بها لذائذ يقارنها وغايات حيوية ينتهي إليها وآخر ما ينتهي إليه الحياة السعيدة الحقيقية التي خلق لها أو الحياة التي يظنها الحياة السعيدة الحقيقية . وهو إنما يقصد بما يعمله من عمل ما يتصل به من اللذة المادية كلذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك أو اللذة الفكرية كلذة الدواء ولذة التقدم والأنس والمدح والفخر والذكر الخالد والانتقام والثروة والأمن وغير ذلك مما لا يحصى .
وهذه اللذائذ أمور زينت بها هذه الأعمال ومتعلقاتها ، وقد سخر الله سبحانه بها الإنسان فهو يوقع الأفعال ويتوخى الأعمال لأجلها ، وبتحققها يتحقق الغايات الإلهية والأغراض التكوينية كبقاء الشخص ، ودوام النسل ، ولو لا ما في الأكل والشرب والنكاح من اللذة المطلوبة لم يكن الإنسان ليتعب نفسه بهذه الحركات الشاقة المتعبة لجسمه والثقيلة على روحه فاختل بذلك نظام الحياة ، وفنى الشخص ، وانقطع النسل فانقرض النوع ، وبطلت حكمة التكوين بلا ريب في ذلك .
وما كان من هذه الزينة طبيعية مغروزة في طبائع الأشياء كالطعوم اللذيذة التي في أنواع الأغذية ولذة النكاح فهي مستندة إلى الخلقة منسوبة إلى الله سبحانه واقعة في طريق سوق الأشياء إلى غاياتها التكوينية ، ولا سائق لها إليها إلا الله سبحانه فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .
وما كان منها لذة فكرية تصلح حياة الإنسان في دنياه ولا تضره في آخرته فهي منسوبة أيضا إلى الله سبحانه لأنها ناشئة عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال تعالى : {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات : 7] .
وما كان منها لذة فكرية توافق الهوى وتشقي في الأخرى والأولى بإبطال العبودية وإفساد الحياة الطيبة فهي لذة منحرفة عن طريق الفطرة السليمة فإن الفطرة هي الخلقة الإلهية التي نظمها الله بحيث تسلك إلى السعادة والأحكام الناشئة منها والأفكار المنبعثة منها لا تخالف أصلها الباعث لها فإذا خالفت الفطرة ولم تؤمن السعادة فليست بالمترشحة منها بل إنما نشأت من نزعة شيطانية وعثرة نفسانية فهي منسوبة إلى الشيطان كاللذائذ الوهمية الشيطانية التي في الفسوق بأنواعه من حيث إنه فسوق فإنها زينة منسوبة إلى الشيطان غير منسوبة إلى الله سبحانه إلا بالإذن قال تعالى حكاية عن قول إبليس : {لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر : 39] وقال تعالى : {فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ} [النحل : 63] .
أما أنها لا تنسب إلى الله سبحانه بلا واسطة فإنه تعالى هو الذي نظم نظام التكوين فساق الأشياء فيه إلى غاياتها وهداها إلى سعادتها ثم فرع على فطرة الإنسان الكونية السليمة عقائد وآراء فكرية يبني عليها أعماله فتسعده وتحفظه عن الشقاء وخيبة المسعى ، وجلت ساحته عز اسمه أن يعود فيأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف ويبعث إلى كل قبيح شنيع فيأمر الناس جميعا بالحسن والقبيح معا وينهى الناس جميعا عن القبيح والحسن معا فيختل بذلك نظام التكليف والتشريع ثم الثواب والعقاب ثم يصف الدين الذي هذه صفته بأنه دين قيم فطرة الله التي فطر الناس عليها ، والفطرة بريئة من هذا التناقض وأمثاله متأبية مستنكفة من أن ينسب إليها ما تعده من السفه والعتاهية .
فإن قلت : ما المانع من أن تنسب الدعوة إلى الطاعة والمعصية إليه تعالى بمعنى أن النفوس التي تزينت بالتقوى وتجهزت بسريرة صالحة يبعثها الله إلى الطاعة والعمل الصالح ، والنفوس التي تلوثت بقذارة الفسوق واكتست بخباثة الباطن يدعوها الله سبحانه إلى الفجور والفسق بحسب اختلاف استعداداتها فالداعي إلى الخير والشر والباعث إلى الطاعة والمعصية جميعا هو الله سبحانه .
قلت : هذا نظر آخر غير النظر الذي كنا نبحث عنه وهذا هو النظر في الطاعة والمعصية من حيث توسيط أسباب متخللة بينهما وبينه تعالى فلا شك أن الحالات الحسنة أو السيئة النفسانية لها دخل في تحقق ما يناسبها من الطاعات أو المعاصي ، وعلى تقديرها تنسب الطاعة والمعصية إليها بلا واسطة وإلى الله سبحانه بالإذن فالله سبحانه هو الذي أذن لكل سبب أن يتسبب إلى مسببه .
وأما الذي نحن فيه من النظر فهو النظر في حال الطاعة والمعصية من حيث تشريع الأحكام ، ومن حيث انبعاث النفوس إليهما مع قطع النظر عن سائر الأسباب الباعثة الداعية إليهما فهل من الممكن أن يقال : إن الله سبحانه يدعو إلى الإيمان والكفر جميعا أو يبعث إلى الطاعة والمعصية معا ؟ وهو الذي يصف دينه بأنه الدين القيم على المجتمع الإنساني المبني على الفطرة الإلهية وهذه الشرائع الإلهية ثم الدواعي النفسانية الموافقة لها كلها فطرية والدواعي النفسانية الموافقة لهوى النفس المخالفة لأحكام الشريعة مخالفة للفطرة لا تنسب الدعوة إليها إلى ذي فطرة سليمة فمن المحال أن تنسب إليه تعالى قال تعالى : {وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} [الأعراف : 29] .
وأما أنها منسوبة إليه تعالى بالإذن فإن الملك عام والسلطنة الإلهية مطلقة وحاشا أن يتأتى لأحد أن يتصرف في شيء من ملكه إلا بإذنه فما يزينه الشيطان في قلوب أوليائه من الشرك والفسق وجميع ما ينتهي بوجه من الوجوه إلى سخط الله سبحانه فإنما ذلك عن إذن إلهي تتم به سنة الامتحان والاختبار الذي لا يتم دونه نظام التشريع ومسلك الدعوة والهداية ، قال تعالى : {ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} [يونس : 3] وقال : {وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ} [آل عمران : 141] .
فتبين أن لزينة الأعمال نسبة إليه تعالى أعم مما بواسطة الإذن أو بلا واسطة ، وعليه يجري قوله تعالى : {كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} [الآية : 108] وأوضح منه في الانطباق على ما تقدم قوله تعالى : {إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [الكهف : 7] .
وللمفسرين بحسب اختلافهم في نسبة الأفعال إليه تعالى أقوال في الآية .
منها : أن المراد هو التزيين بالأمر والنهي وبيان الحسن والقبح فالمعنى : كما زينا لكم أيها المؤمنون أعمالكم زينا لكل أمة من قبلكم أعمالهم من حسن الدعاء إلى الله وترك سب الأصنام ونهيناهم أن يأتوا من الأفعال ما ينفر الكفار عن قبول الحق . وفيه أنه مخالف لظهور الآية في العموم ، ولا دليل على تخصيصها بما ذكروه كما ظهر مما تقدم .
ومنها : أن المعنى : وكذلك زينا لكل أمة عملهم بميل الطباع إليه ولكن قد عرفناهم الحق مع ذلك ليأتوا الحق ويجتنبوا الباطل .
وفيه أنه كما لا يصح إسناد الدعوة إلى الطاعة والمعصية والإيمان والكفر إليه تعالى بلا واسطة كذلك لا تصح نسبة ميل الطباع إلى الأعمال الحسنة والسيئة على وتيرة واحدة إليه تعالى فالفرق بين الدعوة التكوينية وما يشابهها وبين الدعوة التشريعية إلى القبائح والمساوي ، ونسبة الأول إليه تعالى دون الثاني ليس في محله .
ومنها : أن المراد هو التزيين بذكر الثواب فهو كقوله {وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ} [الحجرات : 7] أي حبب إليكم الإيمان بذكر ثوابه ومدح فاعليه على فعله ، وكره الكفر بذكر عقابه وذم فاعليه . وفيه : أن فيه تقييدا للأعمال بالحسنة من غير مقيد . على أنه معنى بعيد من السياق ومن ظاهر لفظ التزيين . على أن التزيين بهذا المعنى لا يختص بالمؤمنين .
ومنها : أن المراد التزيين لمطلق الأعمال حسناتها وسيئاتها ابتداء من غير واسطة والدعوة منه تعالى إلى الطاعة والمعصية جميعا بناء على أن الإنسان مجبر في الأفعال المنسوبة إليه .
وفيه : أن ظاهر الآية أوفق بالاختيار منه بالإجبار فإن الشيء إنما تضم إليه الزينة ليرغب فيه الإنسان ويحبب إليه فتكون مرجحة لتعلقه به وترك غيره ، ولو لم تكن نسبة فعله وتركه إليه على السواء لم يكن وجه لترجيحه فتزين الفعل بما يرغب فيه الفاعل نوع من الحيلة يتوسل بها إلى وقوعه ، وهو ينطبق في الطاعات وحسنات الأعمال على ما يسمى في لسان الشرع هداية وتوفيقا ، وفي المعاصي وسيئات الأعمال على ما يعد إضلالا ومكرا إلهيا ، ولا مانع من نسبة الإضلال والمكر إليه تعالى إذا كانا بعنوان المجازاة دون الإضلال والمكر الابتدائيين ، وقد تقدم البحث عن هذه المعاني في مواضع من هذا الكتاب وتقدم البحث عن الجبر وما يقابله من التفويض والأمر بين الأمرين في الجزء الأول من الكتاب .
وقوله تعالى : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} يؤيد ما تقدم أن حكم التزيين عام شامل لجميع الأعمال الباطنية كالإيمان والكفر والظاهرية كأعمال الجوارح الحسنة والسيئة فإن ظاهر الآية أن الإنسان إنما يقصد هذه الأعمال ويوقعها لأجل ما يرغب فيه من زينته غافلا عن الحقائق المستورة تحت هذه الزينات المضروب عليها بحجاب الغفلة ثم إذا رجعوا إلى ربهم نبأهم بحقيقة ما كانوا يعملونه ، وعاينوا ما هم مصروفون عنه ، أما أولياء الرحمن فوجدوا ما لم يكن يعلم مما أخفي لهم من قرة أعين ، وأما أولياء الشيطان فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فظهور حقائق الأعمال يوم القيامة لا يختص بأحد القبيلين من الحسنات والسيئات .
قوله تعالى : {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ـ إلى قوله ـ عِنْدَ اللهِ} الجهد بفتح الجيم الطاقة والأيمان جمع يمين وهي القسم ، وجهد الأيمان أي ما تبلغه قدرتها وهو الطاقة ، والمراد أنهم بالغوا في القسم وأكدوه ما استطاعوا ، والمراد بكون الآيات عند الله كونها في ملكه وتحت سلطته لا ينالها أحد إلا بإذنه .
فالمعنى : وأقسموا بالله وبالغوا فيه لئن جاءتهم آياته تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله فيما يدعو إليه ليؤمنن بتلك الآية ـ وهذا اقتراح منهم للآية كناية ـ قل إنما الآيات عند الله وهو الذي يملكها ويحيط بها وليس إلي من أمرها شيء حتى أجيبكم إليها من تلقاء نفسي .
قوله تعالى : {وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} قرئ : {لا يُؤْمِنُونَ} بياء الغيبة وتاء الخطاب جميعا ، والخطاب على القراءة الأولى للمؤمنين بنوع من الالتفات ، وعلى القراءة الثانية للمشركين والكلام من تتمة قول النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر .
والظاهر أن {إِنَّمَا} في قوله : {وَما يُشْعِرُكُمْ} للاستفهام ، والمعنى : وما هو الذي يفيد لكم العلم بواقع الأمر وهو أنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات ؟ فالكلام في معنى قولنا : هؤلاء يحلفون بالله لئن جاءتكم الآيات ليؤمنن بها فربما آمنتم وصدقتم بحلفهم وليس لكم علم بأنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون بها لأن الله لم يشأ إيمانهم فالكلام من الملاحم .
وربما قيل : إن {أن} في قوله : {أَنَّها إِذا جاءَتْ} إلخ ، بمعنى لعل وهذا معنى شاذ لا يحمل على مثله كلام الله لو ثبت لغة .
قوله تعالى : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} إلخ ، ظاهر السياق أن الجملة عطف على قوله : {لا يُؤْمِنُونَ} وهي بمنزلة التفسير لعدم إيمانهم ، والمراد بقوله : {أَوَّلَ مَرَّةٍ} الدعوة الأولى قبل نزول الآيات قبال ما يتصور له من المرة الثانية التي هي الدعوة مع نزول الآيات .
والمعنى أنهم لا يؤمنون لو نزلت عليهم الآيات ، وذلك أنا نقلب أفئدتهم فلا يعقلون بها كما ينبغي أن يعقلوه ، وأبصارهم فلا يبصرون بها ما من حقهم أن يبصروه فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة من الدعوة قبل نزول هذه الآيات المفروضة ونذرهم في طغيانهم يترددون ويتحيرون . هذا ما يقضي به ظاهر سياق الآية .
وللمفسرين في الآية أقوال كثيرة غريبة لا جدوى في التعرض لها والبحث عنها ، من شاء الاطلاع عليها فليراجع مظانها .
___________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 267-272 .
قال تعالى : {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام : 108] .
تناولت الآيات السابقة موضوع قيام تعاليم الإسلام على أساس المنطق ، وقيام دعوته على أساس الاستدلال والإقناع لا الإكراه ، وهذه الآية تواصل نفس التوجيهات فتنهى عن سبب ما يعبد الآخرون ـ أي المشركون ـ لأنّ هذا سوف يدعوهم إلى أن يعمدوا هم أيضا ـ ظلما وعدوانا وجهلا ـ إلى توجيه السب إلى ذات الله المقدسة : {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
يروى أنّ بعض المؤمنين كانوا يتألمون عند رؤيتهم عبادة الأصنام ، فيشتمون أحيانا الأصنام أمام المشركين ، وقد نهى القرآن نهيا قاطعا عن ذلك ، وأكّد التزام قواعد الأدب واللياقة حتى في التعامل مع أكثر المذاهب بطلانا وخرافة .
إنّ السبب واضح ، فالسّب والشّتم لا يمنعان أحدا من المضي في طريق الخطأ ، بل إنّ التعصب الشديد والجهل المطبق الذي يركب هؤلاء يدفع بهم إلى التمادي في العناد واللجاجة وإلى التشبث أكثر بباطلهم ، ويستسهلون إطلاق ألسنتهم بسبّ مقام الرّبوبية جل وعلا ، لأنّ كل أمّة تتعصب عادة لعقائدها وأعمالها كما تقول العبارة التّالية من الآية : {كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ} .
وفي الختام تقول الآية : {ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ} .
{وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ } [الأنعام : 109-110] .
وردت في الآيات السابقة أدلة كثيرة كافية على التوحيد ، وردّ الشرك وعبادة الأصنام ، ومع ذلك فإنّ فريقا من المشركين المعاندين المتعصبين لم يرضخوا للحق ، وراحوا يعترضون وينتقدون ، من ذلك أنّهم أخذوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القيام بخوارق عجيبة وغريبة يستحيل بعضها أساسا (مثل طلب رؤية الله) ، زاعمين كذبا أنّ هدفهم من رؤية تلك المعجزات هو الإيمان ، في الآية الأولى ، يقول القرآن : {أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها} (2) .
وفي الردّ عليهم يشير القرآن إلى حقيقتين : يأمر النّبي صلى الله عليه وآله وسلم أوّلا أن يقول لهم : {قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ} ، أي أن تحقيق المعجزة لا يكون وفق مشتهياتهم ، بل إنّها بيد الله وبأمره .
ثمّ يخاطب المسلمين البسطاء الذين تأثروا بإيمان المشركين فيقول لهم : {وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ} (3) مؤكدا بذلك أنّ هؤلاء المشركين كاذبون في قسمهم .
كما أنّ مختلف المشاهد التي جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤكّد حقيقة أنّهم لم يكونوا يبحثون عن الحق ، بل كان هدفهم من كل ذلك أن يشغلوا الناس ويبذروا في نفوسهم الشك والتردد .
الآية التّالية تبيّن سبب عنادهم وتعصبهم ، فتقول : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} أي أنّهم بإصرارهم على الانحراف والسير في طريق ملتو وتعصبهم الناشئ عن الجهل ورفض التسليم للحق ، أضاعوا قدرتهم على الرؤية الصحيحة والإدراك السليم ، فراحوا يعيشون في متاهات الضلال والحيرة .
هنا أيضا نسب هذا الفعل إلى الله كما سبق من قبل ، وهو في الواقع نتيجة أعمالهم وسوء فعالهم ، وما نسبة ذلك إلى الله إلّا لأنّه علّة العلل ومبدأ عالم الوجود ، وكل خصيصة في أي شيء إنّما هي بإرادته ، وبعبارة أخرى : إنّ الله جعل من النتائج الحتمية للعناد والتعصب الأعمى والانحراف أن يكون لها مثل هذا الأثر ، وهو انحراف الإنسان شيئا فشيئا في هذا الطريق ، فلا يعود يدرك الأمور إدراكا سليما .
ثمّ تشير الآية في الخاتمة إلى أنّ الله ، يترك أمثال هؤلاء في حالتهم تلك لكي يشتد ضلالهم وتزداد حريتهم : {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (4) .
نسأل الله أن يجنبنا الابتلاء بمثل هذا الضلال والحيرة الناتجة عن أعمالنا السيئة ، وأن يمنحنا النظرة السليمة الكاملة لكي نرى الحقيقة ناصعة لا غبش عليها .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 185-190 .
2. «الجهد» بمعنى السعي وبذل الطاقة ، والمقصود هنا الجهد في توكيد القسم .
3. المفسّرون غير متفقين على «ما» ، أهي استفهامية أم نافية ؟ وكذلك فيما يتعلق بتركيب الجملة ، بعضهم يقول إنّ «ما» استفهامية استنكارية ، ولو كانت كذلك لكان معنى الآية : أنّى لكم أن تعلموا إنّهم لا يؤمنون إن رأوا معجزة ، أي إنّه قد يؤمنون ، وهذا خلاف ما تريده الآية ، لذلك اعتبر بعضهم «ما» نافية ، وهو الأقرب إلى الذهن ، فيكون معنى الآية : أنتم لا تعلمون إنّهم حتى إذا تحققت لهم المعجزات لا يؤمنون ، وعلى ذلك يكون فاعل «يشعر» مقدر بمعنى «شيء» وللفعل «يشعر» مفعولان «كم» و {أَنَّها} . . . (تأمل بدقّة) .
4. «يعمهون» من «عمه» بمعنى الحيرة والشك .
 الاكثر قراءة في سورة الأنعام
الاكثر قراءة في سورة الأنعام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











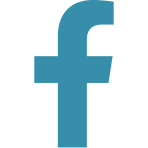

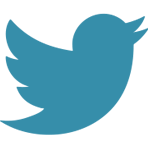

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)