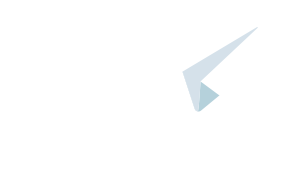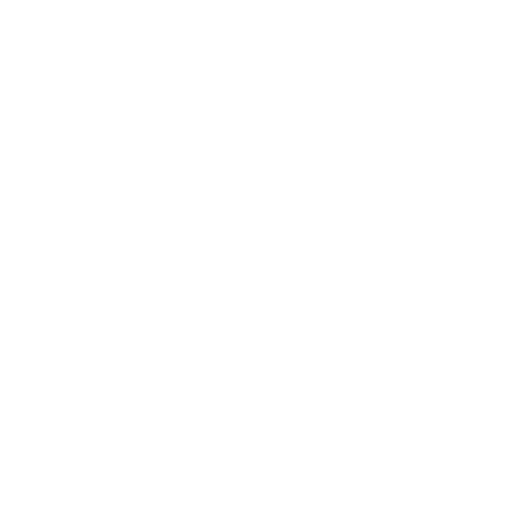تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير آية (100-107) من سورة الانعام
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
5-11-2017
6144
قال تعالى : {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام : 100 - 107].
قال تعالى : {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنعام : 100 - 101] .
رد سبحانه على المشركين ، وعجب من كفرهم ، مع هذه البراهين والحجج والبينات ، فقال : {وجعلوا} يعني المشركين {لله شركاء الجن} أخبر الله سبحانه أنهم اتخذوا معه آلهة ، جعلوهم له أندادا ، كما قال : {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا} وأراد بالجن الملائكة ، وإنما سماهم جنا لاستتارهم عن الأعين . وهذا كما قال {جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} ، عن قتادة ، والسدي .
وقيل : إن قريشا كانوا يقولون : إن الله تعالى قد صاهر الجن ، فحدث بينهما الملائكة ، فيكون على هذا القول المراد به : الجن المعروف . وقيل : أراد بالجن الشياطين ، لأنهم أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان ، عن الحسن {وخلقهم} الهاء والميم عائدة إليهم أي : جعلوا للذي خلقهم شركاء ، لا يخلقون . ويجوز أن يكون الهاء والميم عائدة على الجن ، فيكون المعنى : والله خلق الجن ، فكيف يكونون شركاء له ، ويجوز أن يكون المعنى : وخلق الجن ، والإنس جميعا . وروي أن يحيى بن يعمر قرأ : {وخلقهم} بسكون اللام أي : وخلق الجن ، يعني ما يخلقونه ويأفكون فيه ، ويكذبونه ، كأنه قال : جعلوا الجن شركاءه ، وأفعالهم شركاء أفعاله ، أو شركاء له ، إذا عنى بذلك الأصنام ونحوها . وقيل : إن المعني بالآية المجوس إذ قالوا : {يزدان} و {أهرمن} وهو الشيطان عندهم ، فنسبوا خلق المؤذيات ، والشرور ، والأشياء الضارة إلى {أهرمن} ، وجعلوه بذلك شريكا له ، ومثلهم الثنوية القائلون بالنور والظلمة {وخرقوا له بنين وبنات} أي : اختلقوا ، وموهوا ، وافتروا الكذب على الله ، ونسبوا البنين والبنات إلى الله ، فإن المشركين قالوا الملائكة بنات الله . والنصارى قالوا : المسيح ابن الله . واليهود قالوا : عزير ابن الله . {بغير علم} أي : بغير حجة ، ويجوز أن يكون معناه بغير علم منهم ، بما عليهم ، عاجلا وآجلا . ويجوز أن يكون معناه : بغير علم منهم بما قالوه على حقيقة ، لكن جهلا منهم بالله وبعظمته تعالى {سبحانه} أي : تنزيها له عما يقولون {وتعالى عما يصفون} من ادعائهم له شركاء ، واختراقهم له بنين وبنات أي : هو يجل من أن يوصف بما وصفوه به ، وإنما صار اتخاذ الولد نقصا ، لأنه لا يخلو من أن يكون ولادة ، أو تبنيا ، وكلاهما يوجب التشبيه ، ومن أشبه المحدث كان على صفة نقص .
{بديع السماوات والأرض} أي : مبدعهما ومنشئهما بعلمه ابتداء ، لا من شيء ، ولا على مثال سبق ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام . {أنى يكون له ولد} أي : كيف يكون له ولد ، ومن أين يكون له ولد {ولم تكن له صاحبة} أي :
زوجة ، وإنما يكون الولد من النساء فيما يتعارفونه {وخلق كل شيء} في هذا نفي للصاحبة والولد ، فإن من خلق الأشياء لا يكون شيء من خلقه صاحبة له ، ولا ولدا ، ولأن الأشياء كلها مخلوقة له ، فكيف يتعزز بالولد ويتكثر به {وهو بكل شيء عليم} يعلم الأشياء كلها ، موجودها ومعدومها ، لا يخفى عليه خافية .
ومن قال : إن في قوله {وخلق كل شيء} دلالة على خلق أفعال العباد ، فجوابه : إن المفهوم منه أنه أراد المخلوقات كما يفهم المأكولات ، من قول من قال :
أكلت كل شيء ، والمخلوقات كلها بما فيها من التقدير العجيب ، يضاف خلقها إليه سبحانه ، على أنه سبحانه قد نزه نفسه عن إفك العباد وكذبهم ، فلو كان خلقا له ، لما تنزه عنه .
- {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام : 102 - 103] .
لما قدم سبحانه ذكر الأدلة على وحدانيته ، عقبه بتنبيه عباده على أنه الإله المستحق للطاعة ، والعبادة ، وتعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه ، فقال :
{ذلكم} أي : ذلك الذي خلق هذه الأشياء ، ودبر هذه التدابير لكم ، أيها الناس هو {الله ربكم} أي : خالقكم ، ومالككم ، ومدبركم ، وسيدكم {لا إله إلا هو خالق كل شيء} أي : كل مخلوق من الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها غيره {فاعبدوه} لأنه المستحق للعبادة {وهو على كل شيء وكيل} أي : حافظ ، ومدبر ، وحفيظ على خلقه ، فهو وكيل على الخلق ، ولا يقال وكيل لهم .
{لا تدركه الأبصار} أي : لا تراه العيون ، لأن الإدراك متى قرن بالبصر ، لم يفهم منه إلا الرؤية ، كما أنه إذا قرن بآلة السمع ، فقيل : أدركت بأذني ، لم يفهم منه إلا السماع ، وكذلك إذا أضيف إلى كل واحد من الحواس ، أفاد ما تلك الحاسة آلة فيه ، فقولهم : أدركته بفمي ، معناه : وجدت طعمه ، وأدركته بأنفي معناه :
وجدت رائحته .
{وهو يدرك الأبصار} تقديره لا تدركه ذوو الأبصار ، وهو يدرك ذوي الأبصار أي : المبصرين ، ومعناه أنه يرى ولا يرى وبهذا خالف سبحانه جميع الموجودات ، لأن منها ما يرى ويرى كالأحياء ، ومنها ما يرى ولا يرى كالجمادات والأعراض المدركة ، ومنها ما لا يرى ولا يرى كالأعراض غير المدركة ، فالله تعالى خالف جميعها ، وتفرد بأن يرى ولا يرى وتمدح في هذه الآية بمجموع الأمرين ، كما تمدح في الآية الأخرى بقوله {وهو يطعم ولا يطعم} .
وروى العياشي بالإسناد المتصل ، أن الفضل بن سهل ، ذا الرياستين ، سأل أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام فقال : {أخبرني عما اختلف الناس فيه من الرؤية ، فقال : من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهذه الأبصار ليست هي الأعين ، إنما هي الأبصار التي في القلوب ، لا يقع عليه الأوهام ، ولا يدرك كيف هو .
{وهو اللطيف} قيل في معناه وجوه أحدها : إنه اللاطف بعباده ، بسبوغ الإنعام ، غير أنه عدل عن وزن فاعل إلى فعيل للمبالغة والثاني : إن معناه لطيف التدبير ، إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه . والثالث : إن اللطيف : الذي يستقل الكثير من نعمه ، ويستكثر القليل من طاعة عباده والرابع إن اللطيف : الذي إذا دعوته لباك ، وإن قصدته آواك ، وإن أحببته أدناك ، وإن أطعته كافاك ، وإن عصيته عافاك ، وإن أعرضت عنه دعاك ، وإن أقبلت إليه هداك . والخامس : اللطيف : من يكافي الوافي ، ويعفو عن الجافي ، والسادس : اللطيف من يعز المفتخر به ، ويغني المفتقر إليه والسابع : اللطيف : من يكون عطاؤه خيرة ، ومنعه ذخيرة . {الخبير} : العليم بكل شيء من مصالح عباده ، فيدبرهم عليها ، وبأفعالهم ، فيجازيهم عليها .
- {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [الأنعام : 104 - 105] .
ثم بين سبحانه ، انه بعد هذه الآيات ، قد أزاح العلة للمكلفين ، فقال : {قد جاءكم} أيها الناس {بصائر} : بينات ، ودلالات {من ربكم} تبصرون بها الهدى من الضلال ، وتميزون بها بين الحق والباطل ، ووصف البينة بأنها جاءت تفخيما لشأنها ، كما يقال : جاءت العافية ، وانصرف المرض ، وأقبل السعد {فمن أبصر فلنفسه} أي : من تبين هذه الحجج ، بأن نظر فيها حتى أوجبت له العلم ، فمنفعة ذلك تعود إليه ولنفسه نظر {ومن عمي} فلم ينظر فيها ، وصدف عنها (2) {فعليها} أي : على نفسه وباله ، وبها أضر ، وإياها ضر ، فسمي العلم والتبيين إبصارا ، والجهل عمى ، مجازا وتوسعا . وفي هذا دلالة على أن المكلفين مخيرون في أفعالهم ، غير مجبرين .
ثم أمر سبحانه نبيه بأن يقول لهم {وما أنا عليكم بحفيظ} أي : لست أنا الرقيب على أعمالكم . قال الزجاج : معناه لست آخذكم بالإيمان اخذ الحفيظ عليكم والوكيل ، وهذا قبل الأمر بالقتال ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال ، صار حفيظا عليهم ، ومسيطرا على كل من تولى {وكذلك} أي : وكما صرفنا الآيات قبل {نصرف} هذه {الآيات} قال علي بن عيسى : والتصريف إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة ، لتجتمع فيه وجوه الفائدة .
{وليقولوا درست} ذلك يا محمد أي : تعلمته من اليهود . قال الزجاج : وهذه اللام تسميها أهل اللغة لام الصيرورة أي : إن السبب الذي أداهم إلى أن قالوا درست هو تلاوة الآيات ، وكذلك دارست أي دارست أهل الكتابين ، وقارأتهم ، وذاكرتهم عن الحسن ، ومجاهد ، والسدي ، وابن عباس {ولنبينه لقوم يعلمون} معناه : لنبين الذي هذه الآيات دالة عليه ، للعلماء الذين يعقلون ما نورده عليهم ، وإنما خصهم بذلك لأنهم انتفعوا به ، دون غيرهم .
- {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} [الأنعام : 106 - 107] .
ثم أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم باتباع الوحي ، فقال : {اتبع} أيها الرسول {ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو} إنما أعاد سبحانه هذا القول ، لأن المراد ادعهم إلى أنه لا إله إلا هو ، عن الحسن . وقيل : معناه ما أوحي إليك من أنه لا إله إلا هو {وأعرض عن المشركين} قال ابن عباس : نسخته آية القتال . وقيل : معناه اهجرهم ، ولا تخالطهم ، ولا تلاطفهم ، ولم يرد به الإعراض عن دعائهم إلى الله تعالى ، وحكمه ثابت {ولو شاء الله ما أشركوا} أي : لو شاء الله ان يتركوا الشرك قهرا وإجبارا ، لاضطرهم إلى ذلك ، إلا أنه لم يضطرهم إليه بما ينافي أمر التكليف ، وأمرهم بتركه اختيارا ، ليستحقوا الثواب والمدح عليه ، فلم يتركوه ، فأتوا به من قبل نفوسهم .
وفي تفسير أهل البيت عليهم السلام : لو شاء الله أن يجعلهم كلهم مؤمنين معصومين حتى كان لا يعصيه أحد ، لما كان يحتاج إلى جنة ، ولا إلى نار ، ولكنه أمرهم ونهاهم ، وامتحنهم وأعطاهم ما له به عليهم الحجة ، من الآلة والاستطاعة ، ليستحقوا الثواب والعقاب .
{وما جعلناك عليهم حفيظا} مراقبا لأعمالهم {وما أنت عليهم بوكيل} أي : ولست بموكل عليهم بذلك وإنما أنت رسول عليك البلاغ ، وعلينا الحساب . وجمع بين حفيظ ووكيل لاختلاف معنى اللفظين ، فإن الحافظ للشيء هو الذي يصونه عما يضره . والوكيل على الشيء هو الذي يجلب الخير إليه .
______________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 125-131 .
2 . [حتى جهل] .
{ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ } . المشركون على أنواع ، منهم من جعل الأصنام آلهة مع اللَّه ، وآخرون أشركوا معه الكواكب ، ومنهم من عبد إبليس ، ومنهم من ألَّه الظلمة ، وفريق جعلوا الجن شركاء للَّه ، واللَّه سبحانه أخبر عن وجود الجن ، كما أخبر عن وجود الملائكة ، وانه خلقهم من مارج من نار ، وفي الآية التي نحن بصددها أخبر اللَّه سبحانه عن الفريق الذين جعلوا الجن شركاء له جل ثناؤه ، ولكنه لم يبين نوع هذا الجن المعبود للمشركين : هل هو جن الوهم والخيال ، أو غيرهم ، ولأجل هذا اختلف المفسرون ، فمنهم من قال : انه إبليس . وقال آخر : هو الظلمة ، إلى غير ذلك مما لا يستند إلى أساس من علم .
وأيا كان ، فان اللَّه قد رد على هؤلاء المشركين بكلمة واحدة هي :
{ وخَلَقَهُمْ } . وضمير خلقهم عائد إلى الجن لأنه أقرب ، ويجوز إلى المشركين وإليهما معا ، لأن اللَّه خالق الجن والإنس ، والمعنى كيف يكون للَّه شركاء ، وهو خالق كل شيء .
{ وخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ } . خرقوا أي اختلقوا وابتدعوا كذبا وافتراء . . قال مشركو العرب : الملائكة بنات اللَّه . وقالت اليهود : عزير ابن اللَّه . وقالت النصارى : المسيح ابن اللَّه . وكل هذه الأقوال رجم بالغيب ، وزعم بلا علم « سُبْحانَهُ وتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ » من المستحيلات عليه .
{ بَدِيعُ السَّماواتِ والأَرْضِ } . أي خالقها على غير مثال سابق { أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ولَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ } ، من جنسه ، ولا من غير جنسه ، لأنه ليس كمثله شيء ، وهو الغني عن كل شيء ، وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية 50 من سورة النساء { وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ } . والمخلوق لا يكون شريكا للخالق { وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ومع هذا لا يعلم بأن له ولدا ، ولو كان لعلم به ، فعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وجوده واقعا بالنسبة إلى غير اللَّه ، أما بالنسبة إليه تعالى فان علمه لا ينفك عن وجود المعلوم .
{ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهً إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ } . الخطاب موجه للمشركين ، والمعنى ان اللَّه استجمع صفات الوحدانية ، وخلق الكون بما فيه ، وتدبير الأمور كلها فهو جدير بأن تفردوه بالعبادة ، ولا تشركوا معه أحدا من الأنداد ، ولا تنسبوا له الصاحبة والأولاد .
{ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ } . تكلمنا عن رؤية اللَّه مفصلا عند تفسير الآية 55 من سورة البقرة ج 1 ص 107 { وهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصارَ } وغيرها ، لأنه بكل شيء محيط « وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » . لطيف بعباده ، خبير بأعمالهم ومقاصدهم .
{ قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ } . المراد بالبصائر هنا الدلائل والبينات على وجود اللَّه ووحدانيته ، ومنها ما سبق ذكره تعالى فالق الحب والنوى ، وخالق الليل والنهار ، والناس من نفس واحدة ، ومنزل الماء الذي أحيا كل شيء . .
واطلاق البصائر على الدلائل من باب اطلاق المسبب على السبب ، لأن البصائر جمع بصيرة : وهي الإدراك الحاصل بالقلب ، وهذا الإدراك ينشأ من الأدلة والبراهين .
{ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ومَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها } . بعد أن أقام الدليل القاطع على الحق قال : من اتبعه فإلى نفسه أحسن : ومن خالفه فإليها أساء : {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها} [الاسراء - 7] . { وما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ } بل بشير ونذير ، واللَّه وحده هو الوكيل والرقيب .
{ وكَذلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ ولِيَقُولُوا دَرَسْتَ ولِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } . كان العرب في الجاهلية أمة أمية ، لا شيء عندهم من العلم ، ولما استمعوا إلى القرآن ، ورأوا فيه من فنون البيان ، وأنواع الأدلة والبراهين الدامغة لهم ولما يقدسون ، ومع ذلك رفضوا الايمان والهداية ، لما كانت هذه حالهم لجأوا إلى التعليلات الكاذبة ، وقالوا : يا محمد هذا القرآن الذي جئنا به قد درسته وتعلمته من غيرك ، وليس هو وحيا من اللَّه .
وبهذا التمهيد يتبين معنا ان قوله تعالى : « وكَذلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ » معناه لقد أنزلنا في القرآن ألوانا من الدلائل والبينات بقصد أن يهتدي بها المشركون ، ويرجعوا عن غيهم ، فكانت عاقبة ذلك ان قالوا للنبي : انك درست هذه الآيات وتعلمتها من غيرك ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : { لِيَقُولُوا دَرَسْتَ } .
أما قوله : { ولِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } فمعناه اننا صرفنا الآيات في القرآن لينتفع بها الذين يعلمون معانيها ، فتقودهم إلى الايمان بالحق ، أما أهل الجهالة والضلالة فلا رجاء بهدايتهم ، وغاية الأمر ان هذه الآيات تقطع معذرتهم ، وتكون حجة عليهم .
{ اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهً إِلَّا هُوَ وأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ } .
هذا أمر من اللَّه لنبيه الأكرم أن ينذر ويبشر بالقرآن ، ويداوم على ذلك ، ولا يبالي بجحود المشركين وتكذيبهم واستهزائهم . . وغريب قول من قال : ان هذه الآية منسوخة بآية القتال ، ان هذا القول غريب لأن اللَّه سبحانه لم يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بترك قتال المشركين في هذه الآية كي يقال : انها منسوخة بالآية الآمرة بقتالهم ، وانما أمره بمتابعة الدعوة إلى الحق ، وعدم المبالاة بتكذيب المشركين . . وبديهة ان الأمر بمتابعة الدعوة مع عدم المبالاة شيء ، والأمر بالقتال شيء آخر . . وأول شرط للنسخ أن يتحد الموضوع .
{ ولَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا } . أي انه تعالى لم يرد إلجاءهم إلى الايمان ، وقهرهم على ترك الشرك بكلمة {كُنْ فَيَكُونُ} الذي خلق بها الكون ، ولو أراد ايمانهم بإرادته التكوينية هذه ما أشركوا . أنظر تفسير الآية 26 من سورة البقرة ، فقرة التكوين والتشريع ج 1 ص 72 . { وما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } . الجملة الأولى والثانية بمعنى واحد ، أو متقاربتان في المعنى ، ولا نفهم أي غرض من ذلك سوى التأكيد ، بل وهذا التأكيد تأكيد أيضا لقوله تعالى : { وأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ } لأنه لو كان وكيلا وحفيظا عليهم لما جاز الاعراض عنهم : {إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ} [الغاشية - 25] .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 237-240 .
قوله تعالى : {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ} إلى آخر الآية . الجن إما مفعول لجعلوا ومفعوله الآخر شركاء أو بدل من شركاء ، وقوله : {وَخَلَقَهُمْ} كأنه حال وإن منعه بعض النحاة وحجتهم غير واضحة . وكيف كان فالكلمة في مقام ردهم ، والمعنى وجعلوا له شركاء الجن وهو خلقهم والمخلوق لا يجوز أن يشارك خالقه في مقامه .
والمراد بالجن الشياطين كما ينسب إلى المجوس القول : بأهرمن ويزدان ونظيره ما عليه اليزيدية الذين يقولون بألوهية إبليس [الملك طاووس ـ شاه بريان] أو الجن المعروف بناء على ما نسب إلى قريش أنهم كانوا يقولون : إن الله قد صاهر الجن فحدث بينهما الملائكة ، وهذا أنسب بسياق قوله : {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وعلى هذا فالبنون والبنات هم جميعا من الملائكة خرقوهم أي اختلقوهم ونسبوهم إليه افتراء عليه سبحانه وتعالى عما يشركون .
ولو كان المراد من هو أعم من الملائكة لم يبعد أن يكون المراد بهم ما يوجد في سائر الملل غير الإسلام فالبرهمانية والبوذية يقولون بنظير ما قالته النصارى من بنوة المسيح كما تقدم في الجزء الثالث من الكتاب ، وسائر الوثنيين القدماء كانوا يثبتون لله سبحانه بنين وبنات من الآلهة على ما يدل عليه الآثار المكتشفة ، ومشركو العرب كانوا يقولون : إن الملائكة بنات الله .
قوله تعالى : {بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} إلى آخر الآية . جواب عن قولهم بالبنين والبنات ، ومحصله أن لا سبيل لتحقق حقيقة الولد إلا اتخاذ الصاحبة ولم يكن له تعالى صاحبة فأنى يكون له ولد ؟ .
وأيضا هو تعالى الخالق لكل شيء وفاطره ، والولد هو الجزء من الشيء يربيه بنوع من اللقاح وجزء الشيء والمماثل له لا يكون مخلوقا له البتة ، ويجمع الجميع أنه تعالى بديع السماوات والأرض الذي لا يماثله شيء من أجزائها بوجه من الوجوه فكيف يكون له صاحبة يتزوج بها أو بنون وبنات يماثلونه في النوع فهذا أمر يخبر به الله الذي لا سبيل للجهل إليه فهو بكل شيء عليم ، وقد تقدم في الكلام على قوله تعالى : {ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ} الخ [آل عمران : 79] في الجزء الثالث من الكتاب ما ينفع في المقام .
قوله تعالى : {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} إلى آخر الآيتين الجملة الأولى أعني قوله : {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ} نتيجة متخذة من البيان المورد في الآيات السابقة ، والمعنى : إذا كان الأمر على ما ذكر فالله الذي وصفناه هو ربكم لا غير ، وقوله : {لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} كالتصريح بالتوحيد الضمني الذي تشتمل عليه الجملة السابقة ، وهو مع ذلك يفيد معنى التعليل أي هو الرب ليس دونه رب لأنه الله الذي ليس دونه إله وكيف يكون غيره ربا وليس بإله .
وقوله : {خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} تعليل لقوله : {لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} أي إنما انحصرت الألوهية فيه لأنه خالق كل شيء من غير استثناء فلا خالق غيره لشيء من الأشياء حتى يشاركه في الألوهية ، وكل شيء مخلوق له خاضع له بالعبودية فلا يعادله فيها .
وقوله : {فَاعْبُدُوهُ} متفرع كالنتيجة على قوله {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ} أي إذا كان الله سبحانه هو ربكم لا غير فاعبدوه ، وقوله : {وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} أي هو القائم على كل شيء المدبر لأمره الناظم نظام وجوده وحياته وإذا كان كذلك كان من الواجب أن يتقى فلا يتخذ له شريك بغير علم فالجملة كالتأكيد لقوله : {فَاعْبُدُوهُ} أي لا تستنكفوا عن عبادته لأنه وكيل عليكم غير غافل عن نظام أعمالكم .
وأما قوله : {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ} فهو لدفع الدخل الذي يوهمه قوله : {وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} بحسب ما تتلقاه أفهام المشركين الساذجة والخطاب معهم ، وهو أنه إذا صار وكيلا عليهم كان أمرا جسمانيا كسائر الجسمانيات التي تتصدى الأعمال الجسمانية فدفعه بأنه تعالى لا تدركه الأبصار لتعاليه عن الجسمية ولوازمها ، وقوله : {وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ} دفع لما يسبق إلى أذهان هؤلاء المشركين الذين اعتادوا بالتفكر المادي ، وأخلدوا إلى الحس والمحسوس وهو أنه تعالى إذا ارتفع عن تعلق الأبصار به خرج عن حيطة الحس والمحسوس وبطل نوع الاتصال الوجودي الذي هو مناط الشعور والعلم ، وانقطع عن مخلوقاته فلا يعلم بشيء كما لا يعلم به شيء ، ولا يبصر شيئا كما لا يبصره شيء فأجاب تعالى عنه بقوله : {وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ} ثم علل هذه الدعوى بقوله : {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} واللطيف هو الرقيق النافذ في الشيء ، والخبير من له الخبرة ، فإذا كان تعالى محيطا بكل شيء بحقيقة معنى الإحاطة كان شاهدا على كل شيء لا يفقده ظاهر شيء من الأشياء ولا باطنه ، وهو مع ذلك ذو علم وخبرة كان عالما بظواهر الأشياء وبواطنها من غير أن يشغله شيء عن شيء أو يحتجب عنه شيء بشيء فهو تعالى يدرك البصر والمبصر معا ، والبصر لا يدرك إلا المبصر .
وقد نسب إدراكه إلى نفس الأبصار دون أولي الأبصار لأن الإدراك الموجود فيه تعالى ليس من قبيل إدراكاتنا الحسية حق يتعلق بظواهر الأشياء من أعراضها كالبصر مثلا الذي يتعلق بالأضواء والألوان ويدرك به القرب والبعد والعظم والصغر والحركة والسكون بنحو بل الأغراض وموضوعاتها بظواهرها وبواطنها حاضرة عنده مكشوفة له غير محجوبة عنه ولا غائبة فهو تعالى يجد الأبصار بحقائقها وما عندها وليست تناله .
ففي الآيتين من سطوح البيان وسهولة الطريق وإيجاز القول ما يحير اللب وهما مع ذلك تهديان المتدبر فيهما إلى أسرار دونها أستار .
( كلام في عموم الخلقة وانبساطها على كل شيء )
قوله تعالى : {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ظاهره وعموم الخلقة لكل شيء وانبساط إيجاده تعالى على كل ما له نصيب من الوجود والتحقق ، وقد تكرر هذا اللفظ أعني قوله تعالى : {خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} منه تعالى في كلامه من غير أن يوجد فيه ما يصلح لتخصيصه بوجه من الوجوه قال تعالى : {قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] وقال تعالى : {اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الزمر : 62] و . قال تعالى {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} [المؤمن : 62] .
وقد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة حتى من المتكلمين والفلاسفة من النصارى واليهود فضلا عن متكلمي الإسلام وفلاسفته ، ولا يهمنا المبادرة إلى إيراد أقوالهم وآرائهم والتكلم معهم ، وإنما بحثنا هذا قرآني تفسيري لا شغل لنا بغير ما يتحصل به الملخص من نظر القرآن الكريم بالتدبر في أطراف آياته الشريفة .
نجد القرآن الكريم يسلم ما نتسلمه من أن الموضوعات الخارجية والأشياء الواقعة في دار الوجود كالسماء وكواكبها ونجومها والأرض وجبالها ووهادها وسهلها وبحرها وبرها وعناصرها ومعدنياتها والسحاب والرعد والبرق والصواعق والمطر والبرد والنجم والشجر والحيوان والإنسان لها آثار وخواص هي أفعالها وهي تنسب إليها نسبة الفعل إلى فاعله والمعلول إلى علته .
ونجده يصدق أن للإنسان كسائر الأنواع الموجودة أفعالا تستند إليه وتقوم به كالأكل والشرب والمشي والقعود وكالصحة والمرض والنمو والفهم والشعور والفرح والسرور من غير أن يفرق بينه وبين غيره من الأنواع في شيء من ذلك فهو يخبر عن أعماله ويأمره وينهاه ، ولو لا أن له فعلا لم يرجع شيء من ذلك إلى معنى محصل . فالقرآن يزن الواحد من الإنسان بعين ما نزنه نحن معشر الإنسان في مجتمعنا فنعتقد أن له أفعالا وآثارا منسوبة إليه نؤاخذه في بعض أفعاله التي ترجع بنحو إلى اختياره كالأكل والشرب والمشي ونصفح عنه فيما لا يرجع إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصحة والمرض والشباب والمشيب وغير ذلك .
فالقرآن ينظم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند حواسنا وتؤيده عقولنا بما شفعت به من التجارب ، وهو أن أجزاء هذا النظام على اختلاف هوياتها وأنواعها فعالة بأفعالها مؤثرة متأثرة في غيرها ومن غيرها وبذلك تلتئم أجزاء النظام الموجود الذي لكل جزء منها ارتباط تام بكل جزء ، وهذا هو قانون العلية العام في الأشياء ، وهو أن كل ما يجوز له في نفسه أن يوجد وأن لا يوجد فهو إنما يوجد عن غيره فالمعلول ممتنع الوجود مع عدم علته ، وقد أمضى القرآن الكريم صحة هذا القانون وعمومه ، ولو لم يكن صحيحا أو تخلف في بعض الموارد لم يتم الاستدلال به أصلا ، وقد استدل القرآن به على وجود الصانع ووحدانيته وقدرته وعلمه وسائر صفاته .
وكما أن المعلول من الأشياء يمتنع وجوده مع عدم علته كذلك يجب وجوده مع وجود علته قضاء لحق الرابطة الوجودية التي بينهما . وقد أنفذه الله سبحانه في كلامه في موارد كثيرة استدل فيها من طريق ما له من الصفات العليا على ثبوت آثارها ومعاليلها كقوله : [وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ] وقوله : [إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ] ، [أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] ، [إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] وغير ذلك ، واستدل أيضا على كثير من الحوادث والأمور بثبوت أشياء أخرى يستعقب ثبوتها بعدها كقوله : {فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} [يونس : 74] وغير ذلك مما ذكر من أمر المؤمنين والكافرين والمنافقين ولو جاز أن يتخلف أثر من مؤثره إذا اجتمعت الشرائط اللازمة وارتفعت الموانع المنافية لم يصح شيء من هذه الحجج والأدلة البتة .
فالقرآن يسلم حكومة قانون العلية العام في الوجود ، وأن لكل شيء من الأشياء الموجودة وعوارضها ولكل حادث من الحوادث الكائنة علة أو مجموع علل بها يجب وجوده وبدونها يمتنع وجوده هذا مما لا ريب فيه في بادئ التدبر .
ثم إنا نجد أن الله سبحانه في كلامه يعمم خلقه على كل ما يصدق عليه شيء من أجزاء الكون قال تعالى : {قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد : 16] إلى غير ذلك من الآيات المنقولة آنفا ، وهذا ببسط عليته وفاعليته تعالى لكل شيء مع جريان العلية والمعلولية الكونية بينها جميعا كما تقدم بيانه .
وقال تعالى : {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ـ إلى أن قال ـ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} [الفرقان : 2] وقال : {الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى} [طه : 50] وقال : {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى} [الأعلى : 3] إلى غير ذلك من الآيات .
وفي هذه الآيات نوع آخر من البيان أخذت فيه الأشياء منسوبة إلى الخلقة وأعمالها وأنواع آثارها وحركاتها وسكناتها منسوبة إلى التقدير والهداية الإلهية فإلى تقديره تعالى تنتهي خصوصيات أعمال الأشياء وآثارها كالإنسان يخطو ويمشي في انتقاله المكاني والحوت يسبح والطير يطير بجناحيه قال تعالى : {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ} [النور : 45] والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فخصوصيات أعمال الأشياء وحدودها وأقدارها تنتهي إليه تعالى ، وكذلك الغايات التي تقصدها الأشياء على اختلافها فيها وتشتتها وتفننها إنما تتعين لها وتروم نحوها بالهداية الإلهية التي تصحبها منذ أول وجودها إلى آخره ، وينتهي ذلك إلى تقدير العزيز العليم .
فالأشياء في جواهرها وذواتها تستند إلى الخلقة الإلهية وحدود وجودها وتحولاتها وغاياتها وأهدافها في مسير وجودها وحياتها كل ذلك ينتهي إلى التقدير المنتهي إلى خصوصيات الخلقة الإلهية وهناك آيات أخرى كثيرة ناطقة بأن أجزاء الكون متصل بعضه ببعض متلائم بعض منه مع بعض متوحدة في الوجود يحكم فيها نظام واحد لا مدبر له إلا الله سبحانه ، وهو الذي ربما سمي ببرهان اتصال التدبير .
فهذا ما ينتجه التدبر في كلامه تعالى غير أن هناك جهات أخرى ينبغي للباحث المتدبر أن لا يغفل عنها وهي ثلاث :
إحداها : أن من الأشياء ما لا يرتاب في قبحه وشناعته كأنواع الظلم والفجور التي ينقبض العقل من نسبتها إلى ساحة القدس والكبرياء والقرآن الكريم أيضا ينزهه تعالى عن كل ظلم وسوء في آيات كثيرة كقوله : {وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [حم السجدة : 46] وقوله : {قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ} [الأعراف : 28] وغير ذلك ، وهذا ينافي عموم الخلقة لكل شيء فمن الواجب أن تخصص الآية بهذا المخصص العقلي والشرعي .
وينتج ذلك أن الأفعال الإنسانية مخلوقة للإنسان وما وراءه من الأشياء ذواتها وآثارها مخلوقة لله سبحانه .
على أن كون الأفعال الإنسانية مخلوقة له تعالى يبطل كونها عن اختيار الإنسان ، ويبطل بذلك نظام الأمر والنهي والطاعة والمعصية والثواب والعقاب وإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع . كذا ذكره جمع من الباحثين .
وقد ذهب على هؤلاء في بحثهم أن يفرقوا بين الأمور الحقيقية التي تنال الوجود والتحقق حقيقة ، والأمور الاعتبارية والجهات الوضعية التي لا ثبوت لها في الواقع ، وإنما اضطر الإنسان إلى تصورها أو التصديق بها حاجة الحياة ، وابتغاء سعادة الوجود بالاجتماع والتمدن فخلطوا بين الجهات الوجودية والعدمية في الأشياء ، وقد تقدمت نبذة من هذا البحث في الكلام على الجبر والتفويض في الجزء الأول من الكتاب .
والذي يناسب المقام من الكلام أن ظاهر قوله : {اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} يعمم الخلقة لكل شيء ثم قوله تعالى : {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة : 7] يثبت الحسن لكل ما خلقه الله ، ويتحصل من الآيتين أن كل ما يصدق عليه اسم شيء ما خلا الله فهو مخلوق ، وأن كل مخلوق فهو متصف بالحسن فالخلق والحسن متلازمان في الوجود فكل شيء فهو من جهة أنه مخلوق لله أي بتمام واقعيته الخارجية حسن فلو عرض لها عارض السوء والقبح كان من جهة النسب والإضافات وأمور أخرى غير جهة واقعيته ووجوده الحقيقي الذي ينسب به إلى الله سبحانه وإلى فاعله المعروض له .
ثم إنا نحصل في كلامه تعالى على موارد كثيرة يذكر فيها السيئة والظلم والذنب وغيرها ذكر تسليم فلنقض بضمها إلى ما تقدم بأن هذه معان وعناوين غير حقيقية لا يلحق الشيء من جهة انتسابه إلى الله سبحانه وخلقه له ، وإنما يلحق الموضوع الذي يقوم الأثر والعمل به من جهة وضع أو نسبة أو إضافة فإن كل معصية وظلم فإن معه من سنخه ما ليس بمعصية وإنما يختلفان من جهة اشتمال أحدهما على مخالفة أمر تشريعي أو عقلي أو اشتماله على فساد في المجتمع أو نقض لغاية دون الآخر مثاله الزنا والنكاح وهما فعلان متماثلان لا يختلفان في حقيقتهما ووجودهما النوعي مثلا وإنما يختلفان بالموافقة والمخالفة للشرع الإلهي أو السنة الاجتماعية أو مصلحة المجتمع ، وتلك أمور وضعية وجهات إضافية ، والخلقة والإيجاد إنما يتعلق بجهة التكوين والخارج ، وأما الجهات الإضافية والعناوين الوضعية التي تلحق الأشياء بحسب انطباقها على المصالح والمفاسد الاجتماعية المستعقبة للمدح والذم أو الثواب والعقاب بحسب ما يشخصها ويحكم بها العقل العملي والشعور الاجتماعي فإنما هي أمور لا تتعدى طور الاجتماع ولا يدخل في دار التكوين أصلا إلا آثارها التي هي أقسام الثواب والعقاب مثلا .
فالفعل الكذائي كالظلم بعنوانه الذي هو الظلم قبيح في ظرف الاجتماع ومعصية تستتبع الذم والعقاب عند المجتمعين ، وأما بحسب التكوين فليس إلا أثرا أو مجموع آثار من قبيل الحركات العارضة للإنسان والعلل الخارجية وخاصة السببية الأولى الإلهية إنما تنتج هذه الجهة التي هي جهة التكوين ، وأما عنوانه القبيح وما يلحق به فإنما هو مولود النظر التشريع أو العقلائي لا خبر عنه بنظر التكوين كما أن زيدا الرئيس هو بعنوانه الذي هو الرئاسة موضوع اجتماعي عندنا له آثار مترتبة عليه في المجتمع كالاحترام والتقدم ونفوذ الكلمة وإدارة الأمور ، وأما من حيث التكوين والواقعية فإنما هو فرد من أفراد الإنسان لا فرق بينه وبين الفرد المرءوس أصلا ، ولا خبر في هذا النظر عن الرئاسة والآثار المرتبة عليها ، وكذا الغني والفقير والسيد والمسود والعزيز والذليل والشريف والخسيس وأمثال ذلك مما لا يحصى .
وبالجملة الخلقة في عين أنها تعم كل شيء إنما تتعلق بالموضوعات والأفعال الواقعة في ظرف الاجتماع المعنونة بمختلف عناوينها بجهة تكوينها وواقعيتها الخارجية ، وأما ما وراء ذلك من جهات القبح والحسن والمعصية والطاعة وسائر الأوصاف والعناوين الاجتماعية الطارئة على الأفعال والموضوعات فالخلق والإيجاد لا يتعلق بها ، وليس لها ثبوت إلا في ظرف التشريع أو القضاء الاجتماعي وساحة الاعتبار والوضع .
وإذا تبين أن ظرف تحقق الأمر والنهي وانتشاء الحسن والقبح والطاعة والمعصية وتعلق الثواب والعقاب وارتباطهما بالفعل وكذا سائر الأمور والعناوين الاجتماعية كالمولوية والعبودية والرئاسة والمرءوسية والعزة والذلة ونحو ذلك غير ظرف التكوين وساحة الواقعية الخارجية التي يتعلق بها الخلق والإيجاد ظهر أن عموم الخلقة لكل شيء لا يستلزم شيئا من المفاسد التي ذكروها كبطلان نظام الأمر والنهي والثواب والعقاب وغير ذلك مما تقدم ذكره .
وكيف يسوغ لمن تدبر كلامه تعالى أن يفتي بمثل هذه الثنوية وكلامه مشحون بأنه خالق كل شيء وأنه الله الواحد القهار وأن قضاءه وقدره وهدايته التكوينية وربوبيته وتدبيره شامل لكل شيء لا يشذ عنه شاذ ، وأن ملكه وسلطانه وإحاطته وكرسيه وسع كل شيء ، وأن له ما في السماوات والأرض وما ظهر وما بطن ، وكيف يستقيم شيء من هذه التعاليم الإلهية المنبئة عن توحيده في ربوبيته مع وجود ما لا يحصى من مخلوقات غيره خلال مخلوقاته .
الثانية : أن القرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شيء إليه تعالى ويحصر العلة الفاعلة فيه كان لازمه إبطال رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء فلا مؤثر في الوجود إلا الله ، وإنما هي عادته تعالى جرت أن يخلق ما نسميه معلولا عقيب ما نسميه علة من غير أن تكون بينهما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب العلة فالنار التي تستعقب الحرارة نسبتها إلى الحرارة والبرودة على السواء ، والحرارة نسبتها إلى النار والثلج على السواء غير أن عادة الله جرت أن يخلق الحرارة عقيب النار والبرودة بعد الثلج من غير أن يكون هناك إيجاب واقتضاء بوجه أصلا .
وهذا النظر يبطل قانون العلية والمعلولية العام الذي عليه المدار في القضاء العقلي وببطلانه ينسد باب إثبات الصانع ولا تصل النوبة مع ذلك إلى كتاب إلهي يحتج به على بطلان رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء ، وكيف يسع أن يبطل القرآن الشريف حكما صريحا عقليا ويعزل العقل عن قضائه ؟ وإنما تثبت حقيته وحجيته بالحكم العقلي والقضاء الوجداني ، وهو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يؤثر إلا إبطال النتيجة لنفسها .
وهؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا من جهة خلطهم بين العلل الطولية والعرضية وإنما يستحيل توارد العلتين على شيء إذا كانتا في عرض واحد لا إذا كانت إحداهما في طول الأخرى ، مثال ذلك أن العلة التامة لوجود النار كما توجب وجود النار كذلك توجب وجود الحرارة ولا يجتمع مع ذلك في الحرارة إيجابان ولا تعمل فيها علتان تامتان مستقلتان بل علة معلولة لعلة .
وبتقريب آخر أدق : منشأ الخطإ هو عدم التمييز بين الفاعل بمعنى ما منه والفاعل بمعنى ما به ولاستقصاء القول في المسألة محل آخر .
الثالثة : وهي قريبة المأخذ من الثانية أنهم لما وجدوا أنه تعالى ينسب خلق كل شيء إلى نفسه ، وهو تعالى مع ذلك يسلم وجود رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء أنفسها حسبوا أن ما له علة ظاهرة معلومة من الأشياء فهي العلة له دونه تعالى وإلا لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ولا يبقى لتأثيره تعالى إلا حدوث الأشياء وبدء وجودها ولذا تراهم يرومون إثبات الصانع من جهة حدوث الأشياء كحدوث الإنسان بعد ما لم يكن وحدوث الأرض بعد ما لم تكن وحدوث العالم بعد ما لم يكن .
ويضيفون إلى ذلك وجود أمور أو حدوث حوادث مجهولة العلل للإنسان كالروح وكالحياة في الإنسان والحيوان والنبات فإن الإنسان لم يظفر بعلل وجودها بعد ، والبسطاء منهم يضيفون إلى ذلك أمثال السحب والثلوج والأمطار وذوات الأذناب والزلازل والقحط والغلاء والأمراض العامة ونحو ذلك مما لا يظهر عللها الطبيعية للأفهام العامية ثم كلما لاح لهم في شيء منها علته الطبيعية انهزموا منه إلى غيره وبدلوا موقفا بآخر أو سلموا للخصم .
وهذا بحسب اللسان العلمي هو أن الوجود الممكن إنما يحتاج إلى الواجب في حدوثه لا في بقائه ، وهو الذي يصر عليه جم غفير من أهل الكلام حتى صرح بعضهم : أنه لو جاز العدم على الواجب لم يضر عدمه وجود العالم تعالى الله وتقدس ، وهذا ـ فيما نحسب ـ رأي إسرائيلي تسرب في أذهان عدة من الباحثين من المسلمين ومن فروع ذلك قولهم باستحالة البداء والنسخ ، والرأي جار سار بين الناس مع ذلك .
وكيف كان هو من أردإ الأوهام والاحتجاج القرآني يخالفه فإن الله سبحانه يستدل على وجود الصانع ووحدته بالآيات المشهودة في العالم وهو النظام الجاري في كل نوع من الخليقة وما يجري عليه في مسير وجوده وأمد حياته من التغير والتحول والفعل والانفعال والمنافع التي يستدرها من ذلك ويوصلها إلى غيره كالشمس والقمر والنجوم وطلوعها وغروبها وما يستجلبه الناس من منافعها والتحولات الفصلية الطارئة على الأرض والبحار والأنهار والفلك التي تجري فيها والسحب والأمطار وما ينتفع به الإنسان من الحيوان والنبات وما يجري عليه من الأحوال الطبيعية والتغيرات الكونية من نطفية وجنينية وصباوة وشباب وشيب وهرم وغير ذلك .
وجميع ذلك من الجهات الراجعة إلى الأشياء من حيث بقائها وموضوعاتها علل أعراضها وآثارها وكل مجموع منها في حين علة للمجموع الحاصل بعد ذلك الحين ، وحوادث اليوم علل حوادث الغد كما أنها معلولة حوادث الأمس .
ولو كانت الأمور من حيث بقائها مستغنية عن الله سبحانه واستقلت بما يكتنف بها من الحوادث ويطرأ عليها من الآثار والأعمال لم يستقم شيء من هذه الحجج الباهرة والبراهين القاهرة وذلك أن احتجاج القرآن بهذه الآيات البينات من جهتين :
إحداهما : من جهة الفاعل كما يشير إليه أمثال قوله تعالى : {أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} [إبراهيم : 10] فإن من الضروري أن شيئا من هذه الموجودات لم يفطر ذاته ولم يوجد نفسه ، ولا أوجده شيء آخر مثله فإنه يناظره في الحاجة إلى إيجاد موجد ، ولو لم ينته الأمر إلى أمر موجود بذاته لا يقبل طرو العدم عليه لم يوجد في الخارج شيء من هذه الأشياء فهي موجودة بإيجاد الله الذي هو في نفسه حق لا يقبل بطلانا ولا تغيرا بوجه عما هو عليه .
ثم إنها إذا وجدت لم تستغن عنه فليس إيجاد شيء شيئا من قبيل تسخين المسخن مثلا حيث تنصب الحرارة بالانفصال من المسخن إلى المتسخن فيعود المتسخن واجدا للوصف بقي المسخن بعد ذلك أو زال ، إذ لو كانت إفاضة الوجود على هذه الوتيرة عاد الوجود المفاض مستقلا بنفسه واجبا بذاته لا يقبل العدم لمكان المناقضة ، وهذا هو الذي يعبر عنه الفهم الساذج الفطري بأن الأشياء لو ملكت وجود نفسها واستقلت بوجه عن ربها لم يقبل الهلاك والفساد فإن من المحال أن يستدعي الشيء بطلان نفسه أو شقاءها .
وهو الذي يستفاد من أمثال قوله : {كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص : 88] وقوله : {وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً} [الفرقان : 3] ويدل على ذلك أيضا الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه هو المالك لكل شيء لا مالك غيره ، وأن كل شيء مملوك له لا شأن له إلا المملوكية .
فالأشياء كما تستفيض منه تعالى الوجود في أول كونها وحدوثها كذلك تستفيض منه ذلك في حال بقائها وامتداد كونها وحياتها فلا يزال الشيء موجودا ما يفيض عليه الوجود وإذا انقطع عنه الفيض انمحى رسمه عن لوح الوجود قال تعالى : {كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} [الإسراء : 20] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .
وثانيتهما : من جهة الغايات كما تشير إليه الآيات الواصفة للنظام الجاري في الكون متلائمة أجزاؤه متوافقة أطرافه يضمن سير الواحد منها إيصال الآخر إلى كماله ويتوجه ما وقع في طرف من السلسلة المترتبة إلى إسعاد ما في طرف آخر منها ينتفع فيها الإنسان مثلا بالنظام الجاري في الحيوان والنبات ، والنبات مثلا بالنظام الجاري في الأرض والجو المحيط بها ، وتستمد الأرضيات بالسماويات والسماويات بالأرضيات فيعود الجميع ذا نظام متصل واحد يسوق كل نوع من الأنواع إلى ما يسعد به في كونه ويفوز به في وجوده وتأبى الفطرة السليمة والشعور الحي إلا أن يقضي أن ذلك كله من تقدير عزيز عليم وتدبير حكيم خبير .
وليس هذا التقدير والتدبير إلا عن فطر ذواتها وإيجاد هوياتها وصوغ أعيانها بضرب كل منها في قالب يقدر له أفعاله ويحصره في ما أريد منه في موطنه وما يئول إليه في منازل هيئت على امتداد مسيره ، والذي يقف عليه آخر ما يقف ، وهي في جميع هذه المراحل على مراكب الأسباب بين سائق القدر وقائد القضاء .
قال تعالى : {لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف : 54] وقال : {أَلا لَهُ الْحُكْمُ} [الأنعام : 62] وقال : {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها} [البقرة : 148] وقال : {وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} [الرعد : 41] وقال : {هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ} [الرعد : 33] .
وكيف يسع لمتدبر في أمثال هذه الآيات أن يعطف واضح معانيها وصريح مضامينها إلى أن الله سبحانه خلق ذوات الأشياء على ما لها من الخصوصيات والشخصيات ثم اعتزلها وما كان يسعه إلا أن يعتزل ويرصد فشرع الأشياء في التفاعل والتناظم بما فيها من روح العلية والمعلولية واستقلت في الفعل والانفعال وخالقها يتأملها في معزله وينتظر يوم يفنى فيه الكل حتى يجدد لها خلقا جديدا يثيب فيه من استمع لدعوته في حياته الأولى ويعاقب المستكبر المستنكف ، وقد صبر على خلافهم طول الزمان غير أنه ربما غضب على بعض ما يشاهده منهم فيعارضهم في مشيتهم ، ويمنع من تأثير بعض مكائدهم على نحو المعارضة والممانعة .
أي أنه تعالى يخرج من مقام الاعتزال في بعض ما تؤدي الأسباب والعلل الكونية المستقلة الجارية إلى خلاف ما يرتضيه ، أو لا يؤدي إلى ما يوافق مرضاته فيداخل الأسباب الكونية بإيجاد ما يريده من الحوادث ، وليس يداخل شيئا إلا بإبطال قانون العلية الجاري في المورد إذ لو أوجد ما كان يريده من طريق الأسباب والعلل كان التأثير على مزعمتهم للعلل الكونية دونه تعالى ، وهذا هو السر في إصرار هؤلاء على أن المعجزات وخوارق العادات ونحوهما إنما تتحقق بالإرادة الإلهية وحدها ونقض قانون العلية العام ، فلا محالة يتم الأمر بنقض السببية الكونية وإبطال قانون العلية ويبطل بذلك أصل قولهم : إن الأشياء مفتقرة إليه تعالى في حدوثها غنية عنه في بقائها .
فهؤلاء القوم لا يسعهم إلا أن يلتزموا أحد أمرين : إما القول بأن العالم على سعته ونظامه الجاري فيه مستقل عن الله سبحانه غير مفتقر إليه أصلا ولا تأثير له تعالى في شيء من أجزائه ولا التحولات الواقعة فيه إلا ما كان من حاجته إليه في أول حدوثه وقد أحدثه فارتفعت الحاجة وانقطعت الخلة .
أو القول بأن الله هو الخالق لكل ما يقع عليه اسم شيء والمفيض له الوجود حال الحدوث وفي حال البقاء ، ولا غنى عنه تعالى لذات ولا فعل طرفة عين .
وقد عرفت أن البحث القرآني يدفع أول القولين لتعاضد الآيات على بسط الخلقة والسلطة الغيبية على ظاهر الأشياء وباطنها وأولها وآخرها وذواتها وأفعالها حال حدوثها وحال بقائها جميعا فالمتعين هو الثاني من القولين والبحث العقلي الدقيق يؤيد بحسب النتيجة ما هو المتحصل من الآيات الكريمة .
فقد ظهر من جميع ما تقدم : أن ما يظهر من قوله : {اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} على ظاهر عمومه من غير أن يتخصص بمخصص عقلي أو شرعي .
قوله تعالى : {قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها} إلخ قال في المجمع ، : البصيرة البينة والدلالة التي يبصر بها الشيء على ما هو به والبصائر جمعها انتهى . وقيل : البصيرة للقلب كالبصر للعين ، والأصل في الباب على أي حال هو الإدراك بحاسة البصر الذي يعد أقوى الإدراكات ، ونيلا من خارج الشيء المشهود ، والإبصار والعمى في الآية هو العلم والجهل أو الإيمان والكفر توسعا .
وكأنه تعالى يشير بقوله : {قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ} إلى ما ذكره في الآيات السابقة من الحجج الباهرة على وحدانيته وانتفاء الشريك عنه ، والمعنى أن هذه الحجج بصائر قد جاءتكم من جانب الله بالوحي إلي ، والخطاب من قبل النبي صلى الله عليه وآله ثم ذكر للمخاطبين وهم المشركون أنهم على خيرة من أمر أنفسهم إن شاءوا أبصروا بها وإن شاءوا عموا عنها غير أن الإبصار لأنفسهم والعمى عليها .
ومن هنا يظهر أن المراد بالحفظ عليهم رجوع أمر نفوسهم وتدبير قلوبهم إليه فهو إنما ينفي كونه حفيظا عليهم تكوينا وإنما هو ناصح لهم . والآية كالمعترضة بين الآيات السابقة والآية اللاحقة ، وهو خطاب منه تعالى عن لسان نبيه كالرسول يأتي بالرسالة إلى قوم فيؤديها إليهم وفي خلال ما يؤديه يكلمهم من نفسه بما يهيجهم للسمع والطاعة ويحثهم على الانقياد بإظهار النصح ونفي الأغراض الفاسدة عن نفسه .
قوله تعالى : {وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ} إلخ ، وقرئ : دارست بالخطاب و [دَرَسْتَ] بالتأنيث والغيبة ، قيل : إن التصريف هو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة ، وقوله : {دَرَسْتَ} من الدرس وهو التعلم والتعليم من طريق التلاوة ، وعلى هذا المعنى قراءة دارست غير أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني وأما قراءة {دَرَسْتَ} بالتأنيث والغيبة فهو من الدروس بمعنى تعفي الأثر أي اندرست هذه الأقوال كقولهم : أساطير الأولين .
والمعنى : على هذا المثال نصرف الآيات ونحولها بيانا لغايات كثيرة ومنها أن يستكمل هؤلاء الأشقياء شقوتهم فيتهموك يا محمد بأنك تعلمتها من بعض أهل الكتاب أو يقولوا : اندرست هذه الأقاويل وانقرض عهدها ولا نفع فيها اليوم ، ولنبينه لقوم يعلمون بتطهير قلوبهم وشرح صدورهم به ، وهذا كقوله : {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً} [الإسراء : 82] .
قوله تعالى : {اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} أمر باتباع ما أوحي إليه من ربه من أمر التوحيد وأصول شرائع الدين من غير أن يصده ما يشاهده من استكبار المشركين عن الخضوع لكلمة الحق والإعراض عن دعوة الدين .
وفي قوله : {مِنْ رَبِّكَ} المشعر بمزيد الاختصاص تلويح إلى شمول العناية الخاصة الإلهية إلا أن قوله : {مِنْ رَبِّكَ} لما كان ملحوقا بقوله : {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} وكان ذلك ربما يوهم أن المراد : اتبع الوحي واعبد ربك ، وأعرض عنهم يعبدوا أربابهم ، ولا يخلو ذلك عن إمضاء لطريقتهم وشركهم قدم على قوله : {وَأَعْرِضْ} إلخ ، قوله : {لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} ليندفع به هذا الوهم ، ويجلو معنى قوله : {وَأَعْرِضْ} إلخ ، ويأخذ موضعه .
فالمعنى : اتبع ما أوحي إليك من ربك الذي له العناية البالغة بك والرحمة المشتملة عليك إذ خصك بوحيه وأيدك بروح الاتباع ، وأعرض عن هؤلاء المشركين لا بأن تدعهم وما يعبدون وتسكت راضيا بما يشركون فيكون ذلك إمضاء للوثنية فإنما الإله واحد وهو ربك الذي يوحي إليك لا إله إلا هو بل إن تعرض عنهم فلا تجهد نفسك في حملهم على التوحيد ولا تتحمل شقا فوق طاقتك فإنما عليك البلاغ ولست عليهم بحفيظ ولا وكيل ، وإنما الحفيظ الوكيل هو الله ولم يشأ لهم التوحيد ولو شاء ما أشركوا لكنه تركهم وضلالهم لأنهم أعرضوا عن الحق واستنكفوا عن الخضوع له .
قوله تعالى : {وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} تطييب لقلب النبي صلى الله عليه وآله أن لا يجد لشركهم ولا يحزن لخيبة المسعى في دعوتهم فإنهم غير معجزين لله فيما أشركوا فإنما المشية لله لو شاء ما أشركوا بل تلبسوا بالإيمان عن طوع ورغبة كما تلبس من وفق للإيمان وذلك أنهم استكبروا في الأرض واستعلوا على الله ومكروا به وقد أهلكوا بذلك أنفسهم فرد الله مكرهم إليهم وحرمهم التوفيق للإيمان والاهتداء إذ كما أن السنة الجارية في التكوين هي سنة الأسباب وقانون العلية والمعلولية العام ، والمشية الإلهية إنما تتعلق بالأشياء وتقع على الحوادث على وفقها فما تمت فيه العلل والشرائط وارتفعت عن وجوده الموانع كان هو الذي تتعلق بتحققه المشية الإلهية وإن كان الله سبحانه له فيه المشية مطلقا إن لم يشأه لم يكن وإن شاء كان ، كذلك السنة في نظام التشريع والهداية هي سنة الأسباب فمن استرحم الله رحمه ومن أعرض عن رحمته حرمه ، والهداية بمعنى إراءة الطريق تعم الجميع فمن تعرض لهذه النفحة الإلهية ولم يقطع طريق وصولها إليه بالفسق والكفر والعناد شملته وأحيته بأطيب الحياة ، ومن اتبع هواه وعاند الحق واستعلى على الله ، وأخذ يمكر بالله ويستهزئ بآياته حرمه الله السعادة وأنزل الله عليه الشقوة وأضله على علم وطبع عليه بالكفر فلا ينجو أبدا . ولو لا جريان المشية الإلهية على هذه السنة بطل نظام الأسباب وقانون العلية والمعلولية وحلت الإرادة الجزافية محله ولغت المصالح والحكم والغايات ، وأدى فساد هذا النظام إلى فساد نظام التكوين لأن التشريع ينتهي بالأخرة إلى التكوين بوجه ودبيب الفساد إليه يؤدي إلى فساد أصله .
وهذا كما أن الله سبحانه لو اضطر المشركين على الإيمان وخرج بذلك النوع الإنساني عن منشعب طريقي الإيمان والكفر ، وسقط الاختيار الموهوب له ولازم بحسب الخلقة الإيمان ، واستقر في أول وجوده على أريكة الكمال ، وتساوى الجميع في القرب والكرامة كان لازم ذلك بطلان نظام الدعوة ولغو التربية والتكميل ، وارتفع الاختلاف بين الدرجات ، وأدى ذلك إلى بطلان اختلاف الاستعدادات والأعمال والأحوال والملكات وانقلب بذلك النظام الإنساني وما يحيط به ويعمل فيه من نظام الوجود إلى نظام آخر لا خبر فيه عن إنسان أو ما يشعر به فافهم ذلك .
ومن هنا يظهر أن لا حاجة إلى حمل قوله : {وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا} على الإيمان الاضطراري ، وأن المراد أن لو شاء الله أن يتركوا الشرك قهرا وإجبارا لاضطرهم إلى ذلك وذلك أن الذي تقدم من أن المراد تعلق المشية الإلهية على تركهم الشرك اختيارا كما تعلقت بذلك في المؤمنين سواء هو الأوفق بكمال القدرة ، والأنسب بتسلية النبي صلى الله عليه وآله وتطييب قلبه .
فالمعنى : أعرض عنهم ولا يأخذك من جهة شركهم وجد ولا حزن فإن الله قادر أن يشاء منهم الإيمان فيؤمنوا كما شاء ذلك من المؤمنين فآمنوا . على أنك لست بمسئول عن أمرهم لا تكوينا ولا غيره فلتطب نفسك .
ويظهر من ذلك أيضا أن قوله : {وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} أيضا مسوق سوق التسلية وتطييب النفس ، وكأن المراد بالحفيظ القائم على إدارة شئون وجودهم كالحياة والنشوء والرزق ونحوها ، وبالوكيل القائم على إدارة الأعمال ليجلب بذلك المنافع ويدفع المضار المتوجهة إلى الموكل عنه من ناحيتها فمحصل المراد بقوله : {وَما جَعَلْناكَ} إلخ ، أن ليس إليك أمر حياتهم الكونية ولا أمر حياتهم الدينية حتى يحزنك ردهم لدعوتك وعدم إجابتهم إلى طلبتك .
وربما يقال : إن المراد بالحفيظ من يدفع الضرر ممن يحفظه وبالوكيل من يجلب المنافع إلى من يتوكل عنه ، ولا يخلو عن بعد فإن الحفيظ فيما يتبادر من معناه يختص بالتكوين والوكيل يعم التكوين وغيره ، ولا كثير جدوى في حمل إحدى الجملتين على جهة تكوينية ، والأخرى على ما يعمها وغيرها بل الوجه حمل الأولى على إحدى الجهتين ، والأخرى على الأخرى .
____________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 247-267 .
قال تعالى : {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام : 100-103] .
خالق كل شيء :
هذه الآيات تشير إلى جانب من العقائد السقيمة والخرافات التي يؤمن بها المشركون وأصحاب المذاهب الباطلة ، وترد عليهم بالمنطق .
فأوّلا : قالوا : إنّ لله شركاء من الجن {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ} .
فيما يتعلق بالجن ، هل المقصود بهم هو المعنى اللغوي الذي يفيد كل كائن غير مرئي ومخفي عن حس الإنسان ، أم هم طائفة الجن التي يرد ذكرها مرارا في القرآن والتي سنشير إليها قريبا ؟ للمفسرين في هذا احتمالان .
على الاحتمال الأوّل قد تكون الآية إشارة إلى الذين كانوا يعبدون الملائكة أو مخلوقات غير مرئية .
وعلى الاحتمال الثّاني قد تكون الإشارة إلى الذين كانوا يعتبرون الجن شركاء لله أو زوجات له .
يقول الكلبي في كتاب «الأصنام» : إنّ إحدى الطوائف العربية ، وتدعي «بنو مليح» وهي إحدى أفخاذ قبيلة «خزاعة» كانت تعبد الجن (2) ، كما يقال إنّ عبادة الجن والاعتقاد بألوهيتها كانت منتشرة بين مذاهب اليونان الخرافية وفي الهند (3) .
ويستدل من الآية (158) من سورة الصافات : {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً} على أنّه كان بين العرب من يرى بين الله والجن نسبا وقرابة ، ويذكر بعض المفسّرين أنّ قريشا كانت تعتقد أنّ الله قد تزوج الجن ، فكان الملائكة ثمرة ذلك الزواج (4) .
فينكر الإسلام عليهم ذلك ، إذ كيف يمكن ذلك وهو الذي خلق الجن : {وَخَلَقَهُمْ} أي كيف يمكن أن يكون المخلوق شريكا للخالق ، لأنّ الشركة دليل التماثل والتساوي ، مع أنّ المخلوق لا يمكن أن يكون في مصاف خالقه أبدا!
الخرافة الأخرى هي قولهم جهلا ـ إنّ لله بنين وبنات : {وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
أفضل دليل على أنّ هذه العقائد ليست سوى خرافة ، هو أنّها تصدر عنهم {بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي أنّهم لا يملكون أي دليل على هذه الأوهام .
من الملاحظ أنّ القرآن استعمل لفظة «خرقوا» من الخرق ، وهو تمزيق الشيء بغير روية ولا حساب ، وهي في النقطة المقابلة تماما «للخلق» القائم على الحساب ، هاتان اللفظتان : «الخلق والخرق» قد تستعملان في حالات الكذب والاختلاق ، مع اختلاف بينهما هو أن (الخلق والاختلاق) تستعمل في الأكاذيب المدروسة و (الخرق والاختراق) فيما لا حساب فيه من الكذب .
أي أنّهم اختلقوا تلك الأكاذيب دون أن يدرسوا جوانب الموضوع وبدون أن يعدوا له ما يلزم من الأمور .
أمّا الطوائف التي كانت تنسب لله البنين ، فإنّ القرآن يذكر في آيات أخرى اسم طائفتين من هؤلاء :
الأولى : هم المسيحيون الذين قالوا : إنّ عيسى ابن الله .
والأخرى : هم اليهود الذين قالوا : عزير ابن الله .
يستفاد من الآية (30) من سورة التوبة ، وممّا توصل إليه المحققون عن دراسة الجذور المشتركة بين المسيحية والبوذية ، وعلى الأخص في موضوع التثليت ، أنّ المسيحيين واليهود ليسوا وحدهم الذين نسبوا ابنا لله ، بل كان هذا موجودا في المعتقدات الخرافية القديمة .
أمّا بشأن نسبة بنات لله ، فالقرآن نفسه يوضح ذلك في آيات أخرى : {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً} [الزخرف : 19] .
وكما سبقت الإشارة إليه ، جاء في التفاسير والتواريخ إنّ قريشا كانت ترى الملائكة بنات الله من زواجه بالجن .
والقرآن يرفض تماما في نهاية الآية كل هذه الخرافات التي لا أساس لها ، وبعبارة حاسمة قاطعة : {سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ} .
والآية التّالية ترد على تلك العقائد الخرافية فتؤكّد أنّ الله هو ذلك الذي أبدع خلق السموات والأرض : {بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} .
هل هناك غير الله من فعل ذلك أو يستطيع فعله كيما يكون شريكا له في عبادته ؟ كلا ، الجميع مخلوقاته ويطيعون أمره ومحتاجون إليه .
ثمّ كيف يمكن أن يكون له أبناء دون أن تكون له زوجة؟! {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ} .
وما حاجته إلى زوجة ؟ ثمّ من التي تكون زوجته وهم جميعا مخلوقاته ؟ وفضلا عن ذلك كلّه أنّ ذاته القدسية منزهة عن كل الصفات الجسمانية ، بينما الحاجة إلى زوجة وأبناء من الصفات الجسمانية المادية .
ومرّة أخرى تؤكّد الآية مقامه باعتباره خالقا لكل شيء ، ومحيطا بكل شيء : {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .
الآية الثّالثة تؤكّد على سبيل الاستنتاج من كل ما سبق من ذكر خالقية الله لكل شيء ، وإبداعه السموات والأرض وإيجادها ، وكونه منزها عن الصفات والعوارض الجسمية وعن الحاجة إلى الزوجة والأبناء وإحاطته العلمية بكل شيء : {ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} فلا يستحق العبودية غيره .
ولكي ينقطع كل أمل بغير الله ، وتنقلع كل جذور الشرك والاعتماد على غير الله ، تختتم الآية بالقول : {وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} .
أي أنّ مفتاح حل مشاكلكم بيده وحده ، وما من أحد غيره قادر على حلها إذ ما من أحد ـ غيره ـ إلّا وهو محتاج إلى إحسانه وكرمه ، فلا موجب إذن لأن تطرح مشاكلك على غيره ، وتطلب حلّها من غيره .
لاحظ أنّ العبارة تقول : {عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} ولم تقل : لكلّ شيء وكيل ، واختلاف المعنى واضح ، لأنّ «على» تفيد التسلط ونفوذ الأمر ، أمّا «اللام» فتفيد التبعية ، أي أن التعبير الأوّل يدل على الولاية والرعاية ، والثّاني يدل على التمثيل والوكالة .
الآية الاخيرة من الآيات مورد البحث ، ومن أجل إثبات حاكمية الله وإحاطته بكل شيء وحفاظه على كل شيء ، وكذلك لإثبات أنّه يختلف عن كل شيء ، تقول : {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} أي أنّه الخبير بمصالح عبيده وبحاجاتهم ، ويتعامل معهم بمقتضى لطفه .
في الحقيقة أنّ من يريد أن يكون حافظ كل شيء ومربيه وملجأه لا بدّ أن يتصف بهذه الصفات .
كما أنّ الآية تقول : إنّه يختلف عن جميع الأشياء في العالم ، لأنّ أشياء العالم بعضها يرى ويرى ، كالإنسان ، وبعضها لا يرى ولا يرى كصفاتنا الباطنية ، وبعض آخر يرى ولا يرى ، كالجمادات ، فالوحيد الذي لا يرى ولكنّه يرى كلّ شيء هو الله الواحد الأحد .
{قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107)} [الأنعام : 104-107] .
ليس من واجبك الإكراه :
تعتبر هذه الآيات نتيجة للآيات السابقة ، ففي البداية تقول : {قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ} .
«بصائر» جمع «بصيرة» من «البصر» بمعنى الرؤية ، ولكنّها في الغالب رؤية ذهنية وعقلانية ، وقد تطلق على كل ما يؤدي إلى الفهم والإدراك ، وهذه الكلمة في هذه الآيات تعني الدليل والشاهد ، وتشمل جميع الدلائل التي وردت في الآيات السابقة ، بل إنّها تشمل حتى القرآن نفسه .
ثمّ لكي تبيّن أنّ هذه الأدلة والبراهين كافية لإظهار الحقيقة لأنّها منطقية ، تقول : {فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها} ، أي أنّ إبصارهم يعود بالنفع عليهم وعماهم يسبب الإضرار بهم .
وفي نهاية الآية تقول ، على لسان النّبي صلى الله عليه وآله وسلم : {وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} .
للمفسّرين احتمالان في تفسير هذا المقطع من الآية :
الأوّل : إنّي لست أنا المسؤول عن مراقبتكم والمحافظة عليكم وملاحظة أعمالكم ، فالله هو الذي يحافظ على الجميع ، وهو الذي يعاقب ويثيب الجميع ، أنّ واجبي لا يتعدى إبلاغ الرسالة وبذل الجهد لهداية الناس .
والآخر : أنا غير مأمور لأحملكم بالجبر والإكراه على قبول الإيمان ، إنّما واجبي هو أن أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق والحجّة وأنتم الذين تتخذون قراركم النهائي .
وليس ما يمنع من انطواء العبارة على كلا المعنيين .
الآية التّالية تؤكّد أنّ اتخاذ القرار النهائي في اختيار طريق الحقّ أو الباطل إنّما يرجع للناس أنفسهم ، وتقول : {وَكَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ} (5) أي كذلك نبيّن الأدلة والبراهين بصور وأشكال متنوعة .
لكن جمعا عارضوا ، وقالوا ـ دونما دليل وبرهان ـ إنّك تلقيت هذا من الآخرين (أي اليهود والنصارى) : {وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ} (6) .
إلّا أنّ جمعا آخر ممن لهم الاستعداد لتقبل الحق لما لهم من بصيرة وفهم وعلم ، يرون وجه الحقيقة ويقبلونها : {وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} .
إنّ اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّه اقتبس تعاليمه من اليهود والنصارى قد تكرر من جانب المشركين ، وما يزال المعارضون المعاندون يتابعونهم في ذلك ، مع أنّ حياة الجزيرة العربية لم تكن فيها مدرسة ولا درس ليتعلم منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ، كما أنّ رحلاته إلى خارج الجزيرة كانت قصيرة لا تدع مجالا لمثل هذا الاحتمال ، ثمّ إنّ معلومات اليهود والمسيحيين الذين كانوا يسكنون الحجاز كانت على درجة من التفاهة وتسطير الخرافات بحيث لا يمكن ـ أصلا ـ مقارنتها بما في القرآن ولا بتعاليم الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وسنشرح هذا الموضوع ـ إن شاء الله ـ عند تفسير الآية (103) من سورة النحل .
ثمّ تبيّن الآية واجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبال معاندة المعارضين وحقدهم واتهاماتهم ، فتقول : {اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ} ومن واجبك أيضا الإعراض عما يوجهه إليك المشركون من افتراءات : {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} .
هذا ـ في الواقع ـ ضرب من التسلية والتقوية المعنوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكيلا ينتاب عزمه الراسخ الصلب أي ضعف في مواجهة أمثال هؤلاء المعارضين .
يتبيّن ممّا قلناه بجلاء أنّ عبارة {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} لا تتعارض مطلقا مع الأمر بدعوتهم إلى الإسلام ولا مع الجهاد ضدهم ، فالمقصود هو أن لا يلقى اهتماما إلى أقوالهم الباطلة واتهاماتهم الكاذبة ، بل يمضي في طريقه بثبات .
الآية الأخيرة يكرر القرآن فيما ـ مرّة أخرى ـ القول بأنّ الله لا يريد أن يكره المشركين ويجبرهم على الإسلام ، إذ لو أراد ذلك لما كان هناك أي مشرك : {وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا} كما يؤكّد القول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّك لست مسئولا عن أعمال هؤلاء ، لأنّك لم تبعث لإكراههم على الإيمان : {وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} ، ولا من واجبك حملهم على عمل الخير : {وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} .
«الحفيظ» هو من يراقب أمرا أو شخصا ليحفظه من أن يصاب بضرر ، أمّا «الوكيل» فهو من يسعى لإحراز النفع لموكله .
لعل من المفيد أن نشير إلى أنّ نفي هاتين الصفتين «الحفاظ والوكالة» عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني نفي الإجبار على دفع ضرر أو اجتلاب نفع ، وإلّا فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعوهم ـ ضمن تبليغه الرسالة ـ إلى عمل الخير وترك الشر بصورة طوعية واختيارية .
إنّ الفكرة التي تسود هذه الآيات تستلفت النظر ، فهي تقول : إنّ الإيمان بالله وبتعاليم الإسلام لا يكون عن طريق الإكراه والإجبار ، بل يكون عن طريق المنطق والاستدلال والنفوذ إلى أفكار الناس وأرواحهم ، فالإيمان بالإكرام لا قيمة له ، لأنّ المهم هو أن يدرك الناس الحقيقة فيتقبلوها بإرادتهم واختيارهم .
كثيرا ما يؤكّد القرآن حقيقة كون الإسلام بعيدا عن كل عنف وخشونة ، كتلك الأعمال التي كانت ترتكبها الكنيسة في القرون الوسطى (7) ، ومحاكم تفتيش العقائد .
أمّا صلابة الإسلام في مواجهة المشركين فسوف نبحثها ـ إن شاء الله في بداية تفسير سورة البراءة .
__________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 173-184 .
2. تفسير في ظلال القرآن ، ج 3 ، ص 326 ـ الهامش .
3. تفسير المنار ، ج 8 ، ص 648 .
4. تفسير معجم البيان وتفاسير أخرى .
5. «نصرف» من «التصرف» وهو بمعنى رد الشيء من حالة أو إبداله بغيره ، أي أنّ الآيات تنزل في صور وأشكال متنوعة ولمختلف المستويات العقلية والعقائدية والاجتماعية .
6. «اللام» في ليقولوا هي «لام العاقبة» لبيان العاقبة التي وصل إليها الأمر دون أن تكون هي الهدف المقصود ، لقد كانت هذه تهمة يوجهها المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
7. «القرون الوسطى» هي فترة الألف سنة التي امتدت بين القرن السادس الميلادي حتى نهاية القرن الخامس عشر ، كما يطلق عليها اسم «الفترة المظلمة» التي مرت على أوروبا والمسيحية ، والجدير بالذكر أنّ «العصر الذهبي الإسلامي» يقع في منتصف القرون الوسطى .
 الاكثر قراءة في سورة الأنعام
الاكثر قراءة في سورة الأنعام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











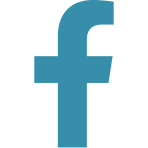

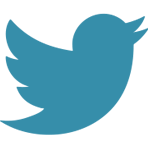

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)