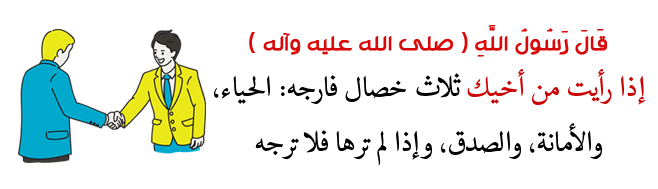
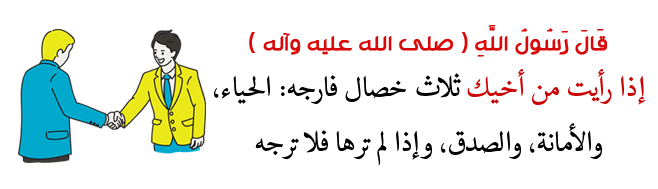

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية| شرح متن زيارة الأربعين (صَلَواتُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَعلىٰ اَرْواحِكُمْ وَاَجْسادِكُمْ، وَشاهِدِكُمْ وَغآئِبِكُمْ، وَظاهِرِكُمْ وَباطِنِكُمْ، آمينَ رَبَّ الْعٰالَمينَ) |
|
|
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-24
التاريخ: 2024-08-24
التاريخ: 18-10-2016
التاريخ: 18-10-2016
|
أشار إلى أنّهم (عليهم السلام) في جميع أحوالهم وأطوارهم ومراتبهم ومقاماتهم وشؤونهم وكيفيّاتهم وظهوراتهم وتجليّاتهم وتنقّلاتهم مستحقّون للصلوات والتحيّات من خالقهم وبرائهم فإنّهم في جميع هذه الحالات لا يزالون عارجين معارج القرب، سالكين مسالك الجذب، متقرّبين إلى بساط الديموميّة، بوسائل العبودية الكاملة كما قال (عليه السلام): في دعائه يوم عرفه: « وأنا أشهدُ يا إلهي بحقيقيّة إيماني وعقد عزمات يقيني، وخالص صريح توحيدي، وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري ... » ([1]).
فأشار بقوله : ( عليكم ) إلى مقام حقيقتهم المقدّسة ومرتبة نورانيّتهم العالية التي لم تلد ولم تولد، ولم يعرفها غير الله أحد، لكونها أوّل ما خلق الله في عالم الإبداع كما قال: ( نحن صنائع الله ) ([2])، وهذا هو المقام المشار عليه بقوله: « لولاك لما خلقت الأفلاك ».
وإلى هذا المقام أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: « أنا ذات الذوات » ([3]) وبقوله: « أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه » ([4]).
قوله: ( وعلى أرواحكم ) يمكن أن يراد بها نفوسهم القدسية، وأن يراد بها عقولهم الشريفة وهم وإن اتّحدوا في هذا المقام أيضاً ولكن الجمع باعتبار تعدّد الهياكل البشرية واختلاف المظاهر الجسمانية، وذلك لا يوجب التعدّد في أصل الروح كالصورة المرئية في مرايا متعدّدة.
|
وما الوجه إلّا واحد غير أنّه |
|
إذا أنت عدّدت المرايا تعدّدا |
ويحتمل أن يراد بالأرواح الأرواح الخمسة المشار إليها في جملة من الأخبار ([5])، مثل ما رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) قال: « إنّ الله خلق الأنبياء والأئمة على خمسة أرواح: روح القوّة، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح الشهوة، وروح القدس، فروح القدس([6]) لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب، وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى » ([7]).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله: ( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ) ([8]) فقال: « ذلك فينا منذ أهبطه الله إلى الأرض وما يخرج إلى السماء ».
وفي جملة من الأخبار أنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع محمد (صلى الله عليه وآله) يوفّقه ويسدّده وهو مع الأئمة من بعده وهو من الملكوت.
وفي بعضها: أنّه لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد وهو مع الأئمة.
وفي بعضها: إنّه خلق من خلقه له بصر وقوّة وتأييد يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين ([9]).
وفي بعضها: « مثل المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق إذا خرجت الجوهرة منه طرح الصندوق ولم تتعب به، قال: إنّ الأرواح لا تمازج البدن ولا تداخله إنّما هو كالكلل للبدن محيط به » ([10]).
وفي بعضها: عن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: ( يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) ([11]) فقال: جبرئيل الذي نزل على الأنبياء، والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم تفقّههم([12]) وتسدّدهم من عند الله وأنّه لا إله إلّا الله محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبهما عُبد الله واستعبد الخلق.
وعلى أجسادكم: جسم الإنسان وجسده وجثمانه هو مجموع أعضائه المؤلّفة من العناصر، وربما يفرّق بين الجسم والجسد باختصاص الأوّل بما فيه روح أو تعميمه لذي الروح وغيره، واختصاص الثاني بما خلا عن الروح، ويحتمل أن يراد بأجسامهم أشباحهم النورانيّة، لأنّ من مراتبهم ومنازلهم مقام الأشباح، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار، ففي بعضها:« إنّ آدم رأى على العرش أشباحاً يلمع نورها » ([13])، روى الصفّار في بصائر الدرجات 2: 80، الحديث 1 الباب الثاني عشر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: « إنّ الله خلق الخلق فخلق من أحبّ ممّا أحبّ وكان أحبّ أن يخلقه من طينة الجنّة وخلق من أبغض ممّا أبغض أن يخلقه من طينة النار ثمّ بعثهم في الظلال قال: قلت: أي شيء الظلال؟ قال: ألم تر إذا ظلّل في الشمس شيء وليس بشيء ثمّ بعث فيهم النبيّين يدعونهم إلى الإقرار بالله وهو قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله، ثمّ دعاهم إلى الإقرار بالنبيّين فأقرّ بعضهم وأنكر بعضهم ثمّ دعاهم إلى ولايتنا فأقرّ والله بها من أحبب وأنكرها من أبغض وهو قوله: ( فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ) ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): كان التكذيب ثمّة ».
ويحتمل أن يراد بالأجسام الأجساد الأصلية اللطيفة التي لا تتغيّر بمضيّ الدهور، وورود آلافات، وبالأجساد الأجساد العنصرية الزمانية التي تنقص وتزيد، ويحتمل أن يراد بأحدهما الأجساد المثالية البرزخية وبالآخر هذا الهيكل المحسوس في هذا العالم، وربما يفرّق بين الجسد والبدن، بأنّ الأوّل لا يقال إلّا على الحيوان العاقل بخلاف الثاني، وقد يقال البدن هو الجسد ما سوى الرأس.
قوله: ( وعلى شاهدكم... ) فيه أيضاً إقرار بشاهدهم وغائبهم كما في الزيارة الجامعة: ( مؤمن بسرّكم وعلانيّتكم وشاهدكم وغائبكم، أوّلكم وآخركم )، قال السيد عبد الله شبر قدس سره في شرحه على هذه الفقرة في الأنوار اللامعة: 164: « ( وشاهدكم ) من الأئمة الأحد عشر، ( وغائبكم ) المهدي، ( وأوّلكم ) عليّ بن أبي طالب، ( وآخركم ) القائم لا كما تقول العامّة بإمامة أوّلكم دون الأخير أو الواقفة الذين وقفوا دون آخركم »، والمراد بشاهدهم يحتمل أن يكون الأئمة الأحد عشر الذين ظهرواعلى الناس في أزمنتهم وعرفوهم ولو في الجملة، فالمراد بالغائب هو الإمام الثاني عشر ( عجل الله فرجه ) وقد اختلف الناس في وجوده وعدمه على أقوال متشتّتة ومذهب الإمامية إنّه حيٌّ موجود غاب عن أنظارنا لمصالح كثيرة.
ويحتمل أن يكون المراد بالشاهد هو الإمام الحيّ في كلّ زمان فينعكس الفرض في هذا الزمان فإنّ القائم مشاهد، وهم الغيب، لأنّهم مضوا وقضوا نحبهم فالقائم (عليه السلام) قطب هذا الزمان، ونقطة دائرة الإمكان، وهو المدبّر في أمر الخلق المتصرّف في العالم بإذن الله تعالى، وقد يقال: إنّ المراد حال حضورهم مع الخالق حال غيبتهم عمّا سوى الله، ويسمّى بحال الفناء والمراقبة، فإنّ لهم مع الله حالات كما في الحديث المعروف.
قوله: ( وعلى ظاهركم ... ) أي وعلى سرّكم وعلانيتكم، فالمراد بظاهرهم أعمالهم الظاهرة، وببطانهم عقائدهم ونيّاتهم الباطنية على ما يظهر من بعضهم في تفسير قوله: « مؤمن بسرّكم وعلانيتكم »، والظاهر أنّ المراد بالظاهر مقام بشريتهم المشار إليه بقوله : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ) ([14])، وبالباطن هو مقام قربهم إلى الحقّ واختصاصهم بمزايا الإمامة التي لا يدركها إلّا الخصيصون والعارفون، ويحتمل أن يزاد بظاهرهم في زمن محمد (صلى الله عليه وآله) في هذه الهياكل الشريفة، وبباطنهم كونهم في الأعصار السالفة مع الأنبياء السالفين كما يدلّ عليه حكاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مع الجنّي الذي كان في زمن نوح، ذكر السيّد هاشم البحراني في حلية الأبرار 1: 223، الباب الثاني، ط. الأعلمي ـ بيروت: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان جالساً وعنده جنّي يسأله عن قضايا مشكلة فأقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) فتصاغر الجنّي حتى صار كالعصفور ثمّ قال: أجرني يا رسول الله، فقال: ممّن؟ قال: من هذا الشاب المقبل، فقال: وما ذاك؟ فقال الجنّي: أتيتُ سفينة نوح لأغرقها يوم الطوفان فلمّا تناولتها ضربني هذا فقطع يدي، ثمّ أخرج يده مقطوعة فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : هو ذاك ».
والجنّي الذي كان في زمن سليمان وفي المصدر نفسه: « إنّ جنياً كان جالساً عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستغاث الجنّي وقال: أجرني يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من هذا الشاب المقبل قال : وما فعل بك؟ قال: تمرّدتُ على سليمان فأرسل إليّ نفراً من الجنّ وطلت عليهم فجاءني هذا الفارس فأسرني وجرحني وهذا مكان الضربة إلى الآن لم يندمل ».
وما ورد من أنّه (عليه السلام) كان مع الأنبياء باطناً ومع محمّد (صلى الله عليه وآله) ظاهراً وباطناً ويرشد إليه أيضاً قوله: « أنا حملت نوحاً في السفينة، أنا صاحب يونس في بطن الحوت، أنا الذي جاوزت موسى البحر، وأهلكت القرون الأُولى، أعطيتُ علم الأنبياء والأوصياء وفصل الخطاب، وبي تمّت نبوّة محمّد (صلى الله عليه وآله) ».
وقوله (عليه السلام): « أنا الذي جحد ولايتي ألف أُمة فمسخوا، أنا المذكور في سالف الزمان والخارج في آخر الزمان » ([15]).
ويدلّ عليه أيضاً حكايته مع اُمّه فاطمة بنت أسد ومع سلمان الفارسي حيث نجّاهما من الأسد. روى السيّد هاشم البحراني في مدينة المعاجز 1: 260، الحديث 234 عن البرسي قال: « رويت حكاية سلمان وأنّه لمّا خرج عليه الأسد قال: يا فارس الحجاز أدركني فظهر إليه فارس وخلّصه منه وقال للأسد: أنت دابته من الآن فعاد يحمل له الحطب إلى باب المدينة امتثالاً لأمر علي (عليه السلام) ».
وظهوره على فرعون لمّا همّ بقتل موسى بصورة شاب لابس لباس الذهب، روى السيّد هاشم البحراني في حلية الأبرار 1: 224: « إنّ فرعون لعنه الله لمّا
ألحق هارون بأخيه موسى (عليه السلام) دخلا عليه يوماً وأوجسا خيفة منه فإذا فارس يقدمهما، ولباسه من ذهب وبيده سيف من ذهب وكان فرعون يحبّ الذهب فقال لفرعون: أجب هذين الرجلين وإلّا قتلتك فانزعج فرعون لذلك وقال: عد عليّ غداً.
فلمّا خرجا دعا البوّابين وعاقبهم وقال: كيف دخل عليّ هذا الفارس بغير إذن فحلفوا بعزّة فرعون أنّه ما دخل إلّا هذان الرجلان وكان الفارس عليّ (عليه السلام) هذا الذي أيّد الله تعالى به النبيّين سرّاً وأيّد به محمّداً (صلى الله عليه وآله) جهراً إلّا أنه كلمة الله الكبرى التي أظهرها لأوليائه فيما شاء من الصور فينصرهم بها وبتلك الكلمة يدعون فيجيبهم الله وينجيهم وإليه الإشارة بقوله: ( وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا )، قال ابن عباس: كانت الآية الكبرى لهما هذا الفارس »، وغير ذلك من الغرائب المعروفة، وقال: « أنا والهداة من أهل بيتي سرّ الله المكنون، وأولياؤه المقرّبون كلّنا واحد، وأمرنا واحد، وسرّنا واحد فلا تفرّقوا بيننا فتهلكوا، فإنّا نظهر في كلّ زمان بما شاء الله فالويل كلّ الويل لمن أنكر ما قلت، ولا ينكره إلّا أهل الغباوة ومن خُتم على قلبه وسمعه وجعل على قلبه غشاوة » ([16]).
ويحتمل أن يراد بظاهرهم علومهم الظاهرة من علوم الشريعة المتعلّقة بالحلال والحرام والحدود والأحكام، وبباطنهم الأسرار المكنونة التي لا يطّلع على بعضها سوى أهل سرّهم كسلمان وكميل وغيرهما، وفي هذا المقام قال: « لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لكفّره أو لقتله » ([17]).
وقال (عليه السلام):
|
( إنّي لأكتم من علمي جواهره |
|
كيلا يرى الحقّ ذو جهل فيفتننا ) ([18]) |
إلى آخر الأبيات، وقال (عليه السلام): « إنّ أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلّا ملك مقرب، أو نبيّ مرسل، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان » ([19]).
وأمثال هذه الكلمات منهم كثيرة لا تحصى، ويحتمل أن يراد بظاهرهم الإمامة والخلافة، وبباطنهم حقيقتهم النورانية المجرّدة التي لا ينال إلى إدراكها أيدي العقول كما قال: « ظاهري إمامة وباطني غيب لا يدرك » ([20])، وقال: « نحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغيّر » ([21])، ويحتمل أن يراد بظاهرهم الناطق منهم وبباطنهم الصامت، فإنّ الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا صامتين في زمن عليّ (عليه السلام)، كما أنّ الحسين كان صامتاً في زمن الحسن (عليه السلام)، وهكذا سائر الأئمة وهذا لا ينافي إمامة الصامت كما لا يخفى، وإليه الإشارة بقوله: « إمامان قاما أو قعدا » ([22])، وسأل يعقوب السرّاج أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: « متى يمضي الإمام حتّى يؤدّي علمه إلى من يقوم مقامه من بعده؟ قال: لا يمضي الإمام حتّى يفضي علمه إلى من انتجبه الله، ولكن يكون صامتاً معه فإذا مضى ولي العلم نطق به من بعده » ([23]).
وفسّر في الأخبار ( البئر المعطّلة والقصر المشيد ) في قوله: ( وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ) ([24]) بالإمام الصامت والناطق.
ويحتمل أن يراد بظاهرهم شاهدهم وبباطنهم غائبهم فيكون العطف للتفسير والتأكيد فيجري فيهما ما تقدّم فيهما.
ولذا قال في الخطبة النورانية: « إنّ غائبنا إذا غاب لم يغب »، ومن هنا ينكشف سرّ حديث « الضيافة، وغزوة الأحزاب والبصرة »، وعن ابن شهر آشوب: « ان القوم لما انهزموا يوم الأحزاب انقسموا سبعين فرقة في كل فرقة ترى وراءها معها علي بن أبي طالب » ([25]) وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: جاء الناس إلى الحسن بن علي فقالوا: أرنا عجائب أبيك التي كان يريناها؟ فقال: أتؤمنون بذلك؟ قالوا: نعم نؤمن بذلك، قال: أليس تعرفون أبي؟ قالوا جميعاً: بلى نعرفه، فرفع لهم جانب الستره فإذا أمير المؤمنين (عليه السلام) قاعد، فقال: تعرفونه؟ قالوا بأجمعهم: هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) ونشهد أنّك وليّ الله حقاً، والإمام من بعده، ولقد أريتنا أمير المؤمنين بعد موته، كما أرى أبوك أبا بكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) جدّك فيمسجد قبا بعد موته » ([26]).
( وقد أرى أمير المؤمنين أبا بكر رسول الله بعد وفاته في مسجد قبا )، كما روى الصفّار ذلك عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لقي أبا بكر فاحتجّ عليه ثمّ قال له: أما ترضى برسول الله (صلى الله عليه وآله) بيني وبينك؟ قال: فكيف لي به؟ فأخذ بيده وأتى مسجد قبا فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه فقضى على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً فلقي عمر فأخبره فقال: مالكَ أما علمتَ سحر بني هاشم » ([27])، وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: « يموت من مات منّا وليس بميّت ويبقى من بقى منّا حجّة عليكم » ([28])، ويصدقه قول الله: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) ([29]).
[1] راجع مفاتيح الجنان للقمي : 245 ، دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة .
[2] أخرجه البرسي في مشارق أنوار اليقين : 77 ، فصل 42 ، ط . الشريف الرضي ـ قم ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: « أول ما خلق الله تعالى نوري ، ثمّ فتق منه نور عليّ ، فلم نزل نتردّد في النور حتى وصلنا إلى حجاب العظمة في ثمانين ألف سنة ، ثمّ خلق الخلائق من نورنا فنحن صنايع الله والخلق من بعد صنايع لنا » .
[3] راجع مشارق أنوار اليقين للبرسي : 64 ، فصل 28 .
[4] أخرجه البرسي في المشارق : 318 ، فصل 150 وهي خطبة طويلة يعرف الإمام (عليه السلام) نفسه .
[5] راجع بصائر الدرجات للصفار 9: 445، حيث ذكر روايات كثيرة تدلّ على هذا المطلب وبعضها قد تقدّم .
[6] في المصدر ( وروح القدس من الله وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان ... ) .
[7] بصائر الدرجات 9 : 454 ، الحديث 12 .
[8] سورة الشوری : 52 .
[9] أخرجها الصفّار في بصائر الدرجات 9 : 458 ، الحديث 14 ، الباب السادس عشر .
[10] أخرجه الصفار في البصائر 9 : 463 ، الحديث 13 ، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
[11] سورة النحل : 2 .
[12] في بعض النسخ « توفّقهم » بدل « تفقّههم » .
[13] بحار الأنوار 26 : 327 .
[14] سورة فصّلت : 6 .
[15] أخرجه البرسي في مشارق الأنوار : 320 ، فصل 150 ، ط . الشريف الرضي .
[16] أخرجه البرسي في مشارق أنوار اليقين : 306 ، وتقدّمت هذه الخطبة .
[17] ذكره السيّد المرحوم عبد الله شبّر في مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار 1: 348، الحديث الثالث والخمسون نقلاً عن الكافي، واحتمل فيه ستّة احتمالات منها وهو الخامس: « أن يكون المعنى لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان من العلم لقتله، لأنّ أبا ذر يعلم أنّ في قلب سلمان علماً ويعلم أنّه لا يجوز له إظهاره تقيّة فمع ذلك إذا أظهر سلمان ما في قلبه لأبي ذر ولم يتّق منه لقتله لعدم جواز إظهاره لذلك العلم ولا يخفى بعده ».
[18] هذه الأبيات منسوبة للإمام زين العابدين (عليه السلام) .
[19] أخرجه الصفّار في بصائر الدرجات 1 : 26 ، باب 12 ، الحديث 2 .
[20] راجع بحار الأنوار 25 : 171 ، الحديث 38 ، الباب الرابع .
[21] مشارق أنوار اليقين : 306 ، ط . الشريف الرضي ـ قم .
[22] بحار الأنوار 16 : 306 .
[23] بحار الأنوار 26 : 95 .
[24] سورة الحج : 45 .
[25] مدينة المعاجز 2 : 12 .
[26] بصائر الدرجات 6 : 275 .
[27] نفس المصدر .
[28] نفس المصدر .
[29] سورة آل عمران : 169 .



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيله الهيأة العليا لإحياء التراث تعقد ندوة ثقافية لاستذكار العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي
|
|
|