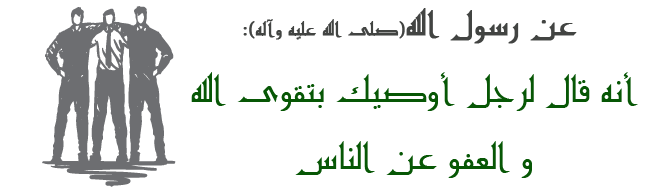
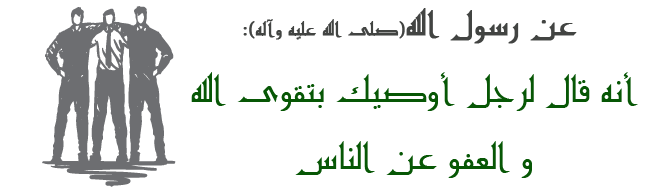

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2014
التاريخ: 19-6-2016
التاريخ: 18-11-2014
التاريخ: 2023-05-28
|
البحث يقع في عدة نقاط :
الأمية في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) :
لقد نزل القرآن في بلد كان أهله يجهلون الكتابة ، إلا أقل القليل منهم ، الذين كانوا يعرفونها بشكل متوسط ومحدود ، من دون إجادة وإحكام ، كما تدل عليه النصوص التاريخية الكثيرة.
يقول بعض المؤرخين : كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ، ولا إلى التوسط ، لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع ، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسم المصحف ، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم ، وكانت غير مستحكمة في الإجادة ، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها (١).
ويقول آخر : ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على أنهم كانوا يعرفون الكتاب إلا قبيل الإسلام ، مع أنهم كانوا محاطين شمالا وجنوبا بأمم من العرب خلفوا نقوشا كتابية كثيرة ، وأشهر تلك الأمم حمير في اليمن كتبوا بالحرف المسند ، والأنباط في الشمال كتبوا بالحرف النبطي (2).
وثالث يقول : الخط عند العرب كان مجهولا إلى قبيل ظهور الإسلام بنحو قرن لأن أحوالهم الاجتماعية وما كانوا عليه فيه من دوام الحروب والغارات صرفهم عن ذلك. ونعني بهؤلاء العرب عرب الحجاز الذين ظهر فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
ومما يدل على جهل العرب بالكتابة قول الله تعالى : {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة : 2].
وهذا هو الظاهر من إطلاقات القرآن ، وأنه لم يكن فرق بين العرب وفارس وغيرهم من هذه الجهة بل كان امراء إيران ممنوعين دينا من الكتابة والقراءة ، فمعنى الأمي من ليس له كتاب ديني ، وقد ورد في التوراة ما يرادف هذا المعنى بصورة الأميين ، ولا يبعد أن يكون هذا جريا على مصطلح اليهود الذين سكنوا جزيرة العرب.
حيث إن الظاهر من الأمي - كما نص عليه أهل اللغة - من لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، أو الكتابة فقط على قول بعضهم. ففي مجمع البحرين : الأمي في كلام العرب هو الذي لا كتاب له من مشركي العرب. قيل هو نسبة إلى الام ، لأن الكتابة مكتسبة ، فهو على ما ولدته امه من الجهل بالكتابة. وقيل : هو نسبة إلى أمة العرب ، لأن أكثرهم أميون ، والكتابة فيهم عزيزة أو عديمة ، فهم على أصل ولادة أمهم.
وعلى هذا ، فتكون كلمة " أمي " مأخوذة من الأمة ، بمعنى الجماعة. وفي أقرب الموارد : الأمي : من لا يعرف الكتابة ولا القراءة ، نسبة إلى الام ، لأن الكتابة مكتسبة ، فهو على ما ولدته امه من الجهل بالكتابة.
والظاهر أن العرب في هذه الأيام يستعملون كلمة " أمي " ويريدون بها الجاهل بالقراءة والكتابة معا ، على ما نقله لي بعضهم.
عدد الكتاب في مكة والمدينة :
وأما عدد هذا القليل من الذين كانوا يكتبون فيذكر البلاذري بسنده عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي أنه كان سبعة عشر رجلا ، قال : دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب ، فذكرهم (4).
وأما في المدينة (يثرب) فعددهم كان على قول أبي عبد الله الزنجاني بضعة عشر رجلا يعرفون الكتاب ، ثم عددهم (5).
ولكن قد زاد عددهم بعد ذلك بشكل ملحوظ ، ولعل ذلك يرجع إلى حث النبي (صلى الله عليه وآله) إياهم باستمرار على تعلم الخط كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وسبق أن ذكرنا في بحث " من هم كتاب الوحي ؟ " نقلا عن السيرة الحلبية : أن عدد كتاب الرسول - سواء من كان يكتب الوحي أو غيره أو هما معا - كان ستة وعشرين كاتبا ، وعن محكي سيرة العراقي : اثنين وأربعين ، وعن الأستاذ أبي عبد الله الزنجاني : أنهم كانوا ثلاثة وأربعين ، ولكن كتاب الوحي منهم كانوا ستة فقط.
النبي الأمي (صلى الله عليه وآله) :
هذا ، ولا إشكال في أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكتب في مدة عمره الشريف ، بل كان له كتاب يكفونه المؤونة باستمرار.
نعم ، قد نقل بعض المحدثين أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد كتب في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو جملة " بن عبد الله " ، بعد أن محا كلمة " رسول الله ". ولكن هذا النقل معارض بغيره مما يدل على أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يعرف الكتابة ، بل أمر عليا أن يكتب ، وأن يأخذ يده ويضعها على المورد الذي يريد محوه.
قال المفيد (رحمه الله) : إن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر عليا أن يكتب عقد الصلح بخطه ، فقال : اكتب يا علي : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال سهيل بن عمرو : هذا الكتاب بيننا وبينك يا محمد ، فافتحه بما نعرفه ، واكتب : باسمك اللهم. فقال النبي لأمير المؤمنين (عليه السلام) :
امح ما كتبت ، واكتب : باسمك اللهم. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لولا طاعتك يا رسول الله ، لما محوت " بسم الله الرحمن الرحيم " ثم محاها ، وكتب : باسمك اللهم ، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ، فقال سهيل : لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوة... امح هذا - إلى أن قال : - فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) : امحها يا علي ، فقال : يا رسول الله ، إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة ، قال له : فضع يدي عليها ، فمحاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده... ثم تمم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكتاب (6).
وظاهر هذا النقل أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يعرف القراءة فضلا عن الكتابة. ولعل مما يدل على ذلك في الجملة أيضا قوله تعالى : {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت : 48] أي لو كنت تقرأ وتكتب كتابا لقالوا إنما جمعه من كتب الأولين وليس وحيا من الله عز وجل وشكوا في نبوتك. أما إذا كنت لا تقدر على القراءة والكتابة وأنت تعيش فيما بينهم وبمرأى منهم ومسمع وهم مطلعون على أميتك فلا مجال لهم للارتياب والشك في الكتاب الذي تأتيهم به من عند الله عز وجل. ولكان لابد لهم من تصديقك والقبول منك.
ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن المتيقن من مدلول الآية هو أنه (صلى الله عليه وآله) في بدء أمره لابد وأن لا يعرف القراءة ولا الكتابة مخافة الريب والشك. وأما بعد ثبوت نبوته والتصديق به فلا تدل الآية على وجوب كونه أميا.
ولعل ما عن الشريف المرتضى علم الهدى (قدس سره) من أن الآية تدل على أن النبي لم يكن يحسن الكتابة قبل النبوة ، وأما بعدها فالذي نعتقده أنه يجوز عليه أن يكون عالما بها وبالقراءة ، ويجوز كونه غير عالم بهما ، من دون قطع بأحد الأمرين (7) صحيح ولا بأس به.
دعوة الإسلام إلى محو الأمية :
ثم إنه لا يخفى أن الإسلام حينما ظهر في الجزيرة العربية لم يدخر وسعا ولم يأل جهدا في الحث على تعلم الكتابة ، ويكفي أن نذكر أن الله تعالى يقول في كتابه المجيد : * {ن والقلم} * أي ما يكتب به * {وما يسطرون} * أي ما يكتبونه. فقد أقسم سبحانه بالقلم ، فيا للقلم من العزة والعظمة والمجد ، حين يقسم الله ويمجده ، حيث إنه أحد لساني الإنسان.
وقال تعالى : * {اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم} * لتبقى العلوم ، ولتنتقل إلى الأجيال التالية ، لتستفيد منها باستمرار وكفى القلم شرفا وعظمة أن الله تعالى ذكر بعد نعمة الخلق نعمة القلم مباشرة.
وأما الرسول فيكفي أن نذكر موقفه في غزوة بدر ، والذي يكشف عما كان للكتابة لديه من أهمية بالغة ، فقد روي عن جابر عن عامر ، قال : أسر رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر سبعين أسيرا ، وكان يفادي بهم على قدر أموالهم ، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون ، فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهم ، فإذا حذقوا فهو فداؤه (8).
وهكذا ، فقد جعل (صلى الله عليه وآله) الكتابة فداء للأسارى وعدلا للحرية ، وهذا إعلام صريح منه (صلى الله عليه وآله) بعظمة القلم وشرف الكتابة.
وقد نقل أنه (صلى الله عليه وآله) قال للشفاء بنت عبد الله العدوية - من رهط عمر بن الخطاب - : ألا تعلمين حفصة رقنة النملة كما علمتها الكتابة ؟ وكانت الشفاء كاتبة في الجاهلية (9).
ونقل عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال في كلماته القصار : قيدو العلم بالكتابة (10) وذلك من أجل أن يبقى العلم بواسطة بقاء الكتابة ، فهو ضمنا أمر بتعلم الكتابة أيضا ، ليمكن تقييد العلم بها.
ونقل عن أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) أيضا أنه إذا وضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء ، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء (11).
الخطوط المعروفة في عصره (صلى الله عليه وآله) :
وأما عن الخطوط التي كانت معروفة في عصر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فنقول : إن من المعروف أن لأهل اليمن خطا يسميه أهل الأخبار بالقلم المسند أو الحميري ، وهو قديم جدا. قال الدكتور راميار : وجدت في اليمن كتابات سبائية ، وقد ارسل بعضها إلى أوروبا سنة ١٨١٠ م ، وهي ترجع إلى عصر المعينين ، أقدم الأمم العربية ، وعاصمتهم " معين " (12).
وقال ابن خلدون : كان لحمير كتابة تسمى المسند ، حروفها منفصلة ، ومنهم تعلمت مصر الكتابة العربية (13).
وقال الدكتور جواد علي : ويظهر من عثور الباحثين على كتابات بالمسند أن قلم المسند كان هو القلم العربي الأصيل والأول عند العرب ، وقد كتب به كل أهل جزيرة العرب ، غير أن التبشير بالنصرانية الذي دخل جزيرة العرب وانتشر في مختلف الأماكن أدخل معه القلم الأرمي المتأخر ، قلم الكنائس الشرقية ، ولما كان هذا القلم أسهل في الكتابة من المسند وجد له أشياعا وأتباعا (14).
وأيضا ، فإن من المعروف أن للأنباط الساكنين في شمال الحجاز قلما يسمى بالقلم النبطي ، وهو قديم أيضا. قال الدكتور جواد علي : إن العرب صاروا يكتبون في الميلاد بقلم آخر أسهل وألين في الكتابة من القلم المسند ، أخذوه من القلم النبطي المتأخر ، وذلك قبيل الإسلام... لاختلاط العرب الشماليين ببني إرم واحتكاكهم بهم... فبان هذا الأثر في الكتابات القليلة التي وصلت إلينا مدونة بنبطية متأثرة بالعربية (15).
وقال جرجي زيدان : إن الأنباط في الشمال كتبوا بالحرف النبطي ، وآثارهم باقية إلى الآن في ضواحي حوران والبلقاء (16).
وقال أبو عبد الله الزنجاني : وعلى رأي الإفرنج الخط العربي قسمان أحدهما :
كوفي ، وهو مأخوذ من نوع من السرياني يقال : أسطر نجيلي. و : نسخي ، وهو مأخوذ من النبطي. ثم قال في هامش الكتاب : إن مملكة الأنباط امتدت من دمشق الشام إلى وادي القرى قرب المدينة شمالا ، وجنوبا من بادية الشام إلى خليج السويس شرقا وغربا ، فشملت شمال غرب جزيرة العرب وجزيرة سينا (17).
ثم إن هذين الخطين - النبطي والمسند - ظلا معروفين عند العرب وشايعين إلى ظهور الإسلام ، إلا أن النبطي كان مستعملا في المراسلات والمكاتبات التجارية. والمسند كان مستعملا في الكتب ، خصوصا الكتب المقدسة.
الخط القرآني في عصر الرسول :
بعد أن عرفنا شيوع الخطين معا - المسند المتبدل بالكوفي ، والنبطي المتبدل بالنسخ - جاء السؤال : بأيهما دون وكتب القرآن الكريم في عصر الرسول ؟
والذي يستفاد من الكتب التاريخية هو أن القرآن قد كتب أولا بالنسخ المتولد من النبطي ، ثم بالكوفي المتولد من المسند ، وكان يسمى بالحميري ، إلى أن ظهر ابن مقلة في أوائل القرن الرابع ، وجعل الخط النسخي على قاعدة جميلة حتى يصلح لكتابة المصاحف. وكتبت المصاحف بعدئذ بالخط النسخي الجميل بعد أن كانت تكتب بالكوفي نحو قرنين من الزمن ، ويشهد لما قلناه :
١ - ما قاله في المفصل : ولا يستبعد أخذ أهل مكة خطهم المدور المسمى بالنسخ من حوران ، أو من (البتراء) و (العلا) ، فبين مكة والمكانين المذكورين اللذين سكن بهما النبط اتصال وثيق - إلى أن قال : - فالخط المدور هو قلم النبط المتأخر ، وقلم كتبة العراق أيضا وهو والد القلم (النسخ) (18).
وقال أيضا : وأما جمهرة المستشرقين المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور الخطوط السامية ومنشأ الخطوط العربية فقد رأوا أن الخط العربي الذي دون به القرآن اخذ من الخط النبطي المتأخر (19).
٢ - ما عن الجاحظ من أنه : لا يخرج الخط من الجزم والمسند - إلى أن قال : - المسند خط العربية الجنوبية ، والجزم خط أهل مكة والمدينة وعرب العراق وغيرهم من العرب الشماليين (20).
أضف إلى ذلك ما ذكره في المفصل من أن العرب تسمي الكتاب العربي - أي خطنا - الجزم (21).
وما قاله أيضا من أنه لما جاء الإسلام وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة لنزول الوحي بينهم صار قلم مكة هو القلم الرسمي للمسلمين ، وحكم على المسند بالموت عندئذ (22).
وعلى هذا فتنتج المقدمات الثلاث الآنفة الذكر - وهي : أن الجزم خط أهل مكة ، وأنه هو خطنا اليوم ، أي النسخ ، وأن كتبة الوحي قد كتبوه بقلم أهل مكة - : أن القرآن قد دون في عصر الرسول بخط النسخ.
٣ - ما قاله أبو عبد الله الزنجاني في تاريخ القرآن بعد بحثه في تاريخ الخط العربي أنه كان للنبي (صلى الله عليه وآله) كتاب يكتبون الوحي بالخط المقرر ، وهو النسخ.
فالخطوط القرآنية في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) كانت خطوطا نبطية ، أي نسخية ، غاية الأمر أنها كانت غير مستحكمة في الإجادة والإتقان.
ولله در ابن مقلة الذي حسنها وهذبها ، حتى صارت المصاحف تكتب بعده بالخط النسخي الجميل ، والحمد لله رب العالمين.
______________________
(١) مقدمة ابن خلدون : ص ٤١٩ الفصل الثلاثون.
(2) تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان : ج ١ ص ١٨.
(3) دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي : ج ٣ مادة " خطط ".
(4) فتوح البلدان للبلاذري : ص ٥٨٠ القسم الثالث.
(5) تاريخ القرآن : ص ٥.
(6) الإرشاد : في غزوة الحديبية.
(7) تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية.
(8) الطبقات الكبرى : ج ٢ ص ١٤.
(9) فتوح البلدان : ص ٥٨٠ القسم الثاني.
(10) مروج الذهب : موجز كلمات للرسول ، مستدرك الحاكم : ج ١ ص ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ ، كنز العمال : ج ٥ ص ٢٢٧ ، مسند أحمد : ج ٢ ص ٢٤٩ و ج ٣ ص ٢٨٥ ، كشف الظنون : ج ١ ص ٢٨.
(11) سفينة البحار : مادة " علم ".
(12) تاريخ القرآن للدكتور راميار : ص ١١٤ (فارسي).
(13) مقدمة ابن خلدون : ص ٤١٨ الفصل الثلاثون.
(14) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ج ٨ ص ١٥٣.
(15) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ج ٨ ص ١٥٣.
(16) تاريخ التمدن الإسلامي : ص ٥٨.
(17) تاريخ القرآن للزنجاني : ص ٢.
(18) المفصل : ج ٨ ص ١٧٢ و ١٧٤.
(19) المفصل : ج ٨ ص ١٧٢ و ١٧٤.
(20) المفصل : ج ٨ ص ١٥٦.
(21) المفصل : ج ٨ ص ١٥٤.
(22) المفصل : ج ٨ ص ١٥٣.



|
|
|
|
أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم
|
|
|
|
|
|
|
لماذا تتناقص أعداد النحل عالميا؟
|
|
|
|
|
|
|
ممثل المرجعية العليا: العتبة الحسينية تخطط لإنشاء مراكز متخصصة للكشف المبكر عن (سرطان الثدي) بعموم العراق
|
|
|